تأملات في بعض مزامير الأجبية
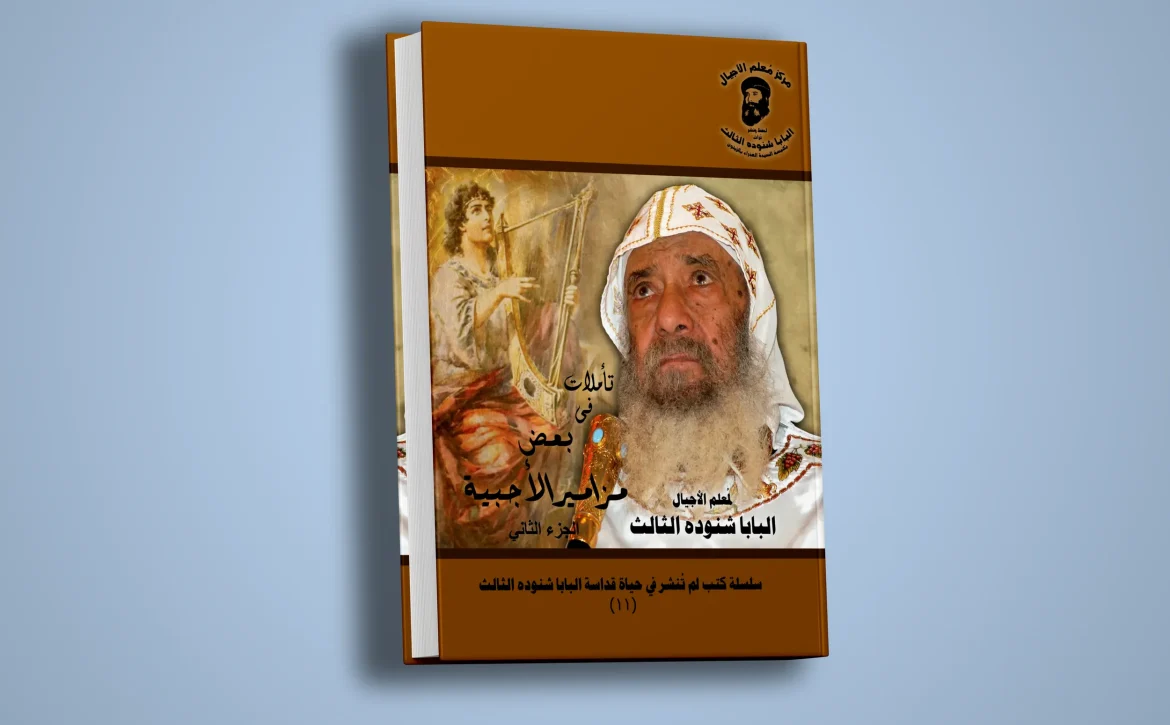
| الكتاب | تأملات في بعض مزامير الأجبية |
| المؤلف | مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث |
| دار نشر | كنيسة السيدة العذراء بالزيتون/ رقم 1021 |
| الطبعة | مارس 2016م |
| رقم الإيداع بدار الكتب | 3819 / 2016 |
طُرس البركة لقداسة البابا تواضروس الثاني
وإن مات فهو يتكلم بعد..
غزارة المعرفة وعمقها في حياة المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث جعلته يترك لنا تُراثًا
ورغم أنه نُشر أكثر من 150 كتابًا بأحجام متنوعة وفي موضوعات عديدة تغطي مساحات كبيرة من المعارف المسيحية الروحية والكنسية والآبائية، والتي تُرجمت معظمها إلى العديد من اللغات، حتى صار اسمه معروفًا عالميًا أنه "مُعلم الأجيال".. إلا أنه ما زال يوجد الكثير مما لم يُنشر بعد. وننشر لكم بعضًا من ذلك التُراث الخالد والذي لم يُنشر من قبل..
ونقدم لكم كتاب:
تأملات في بعض مزامير الأجبية
وسوف تجد عزيزي القارئ متعة خاصة وأنت تستمع لصوت قداسته عبر الصفحات وبعد رحيله.. يُعلِّمنا ويروينا من فيض معرفته وروحياته وخبراته العميقة.
تقديري ومحبتي لكل من ساهم في إخراج هذه الكتب إلى النور.. خاصة مركز "معلِّم الأجيال لحفظ ونشر تُراث البابا شنوده الثالث" في كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون بالقاهرة.
نفَّعنا الله ببركة صلواته لأجلنا كنيسةً وشعبًا وضعفي. ونعمته تشملنا جميعًا..
البابا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 118
قداسة البابا شنوده الثالث في سطور
1- وُلِدَ في 3 أغسطس 1923م، باسم نظير جيد روفائيل. في قرية سَلاَّم بأسيوط.
2- حصل على ليسانس الآداب - قسم التاريخ - من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا).
3- التحق بالقوات المسلحة - مدرسة المشاة - وكان أول الخريجين من الضباط الاحتياط سنة 1947م.
4- تخرَّج في الكلية الإكليريكية "القسم المسائي" سنة 1949م، وكان الأول على الخريجين - فعُيِّنِ مُدرّسًا فيها.
5- عمِلَ مُدَرِسًا للغة الإنجليزية والعربية، في إحدى المدارس الأجنبية.
6- أتقَنَ الشعر منذ عام 1939م، وكتب كثيرًا من القصائد الشعرية.
7- في سنة 1949م: تَكَرَّسَ للخدمة في الكلية الإكليريكية وبيت مدارس الأحد في روض الفرج بشبرا، وتولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد.
8- صار راهبًا في دير العذراء الشهير بالسريان في 18 يوليو 1954م.
9- تمت سيامته بيد البابا كيرلس السادس، أول أسقف للتعليم والكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، باسم الأنبا شنوده في 30 سبتمبر 1962م.
10- بدأ الاجتماعات الروحية التعليمية منذ سنة 1962م، واستمر فيها حتى نياحته سنة 2012م.
11- أصدر مجلة الكرازة في يناير 1965م، واستمر في تحريرها حتى نياحته سنة 2012م (واستمرّ قداسة البابا المُعَظَّمْ تواضروس الثاني في إصدارها).
12- اختارته السماء بالقرعة الهيكلية وتمَّ تجليسه البابا الـ 117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 14 نوڤمبر 1971م.
13- نَمَتْ الكنيسة القبطية في عهده، داخل مصر وخارجها؛ في كل قارات العالم: أفريقيا
وآسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين: الشمالية والجنوبية.
14- حصل على تسع شهادات دكتوراه فخرية من كبرى جامعات أمريكا وأوروبا.
15- امتدت الكلية الإكليريكية في عهده، وأصبح لها 16 فرعًا في مصر وخارجها.
16- حصل على العديد من الجوائز مثل؛ جائزة أفضل واعظ ومعلم للدين المسيحي في العالم 1978م من مؤسسة Browning الأمريكية، وجائزة أوجوسبورج الألمانية للسلام. كما حصل على وسام الصليب الأكبر للقديس أغناطيوس من الكنيسة السريانية.
17- كتب أكثر من 150 كتابًا ونبذة في كثير من المجالات الكتابية والروحية، واللاهوتية والعقائدية وفي الخدمة والرعاية والتربية.
17- قامَ بسيامة بطريركين لكنيسة إريتريا و5 مطارنة و112 أسقفًا وأكثر من 2000 كاهن و1000 راهب.
18- قامَ برحلات رعوية ورسمية لكثير من بلدان العالم، وصلت إلى 104 رحلة.. فمثلاً زار الولايات المتحدة (57 زيارة)، والمملكة المتحدة (31 زيارة) وغيرها.
19- أحضر إلى مصر رفات القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك الـ 20، في 10 مايو 1973م.
20- اهتم بخدمة المرأة؛ وقام بتشكيل لجنة المرأة، وسمح للمرأة بالدراسة بالكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، وقام بتعيينها مدرسًا بالكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية لتدريس علم اللاهوت، وسمح لها بعضوية المجلس الملي، وعضوية مجالس الكنائس.
21- جلس قداسة البابا شنوده الثالث على الكرسي المرقسي لمدة 40 سنة، و4 أشهر، و3 أيام، وبهذا يعتبر سابع الباباوات من حيث طول مدة الجلوس على الكرسي المرقسي. عاش 88 سنة و7 أشهر، و14 يوم.
22- رقد في الرب في 17 مارس سنة 2012م، وكانت جنازة قداسته مهيبة وعظيمة، حضرها أكثر من اثنين ونصف مليون شخص. نيحَ الله نفسه في فردوس النعيم، ونَفَّعْنا بصلواته.
هذا الكتاب
هذا الكتاب
يسر مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنوده الثالث أن يقدم لك أيها القارئ العزيز كتاب "تأملات في بعض مزامير الأجبية".
وهو عبارة عن تأملات وتفاسير روحية لبعض المزامير التي نصلي بها كل يوم في الأجبية. وكما كان قداسة البابا شنوده الثالث يوصي أبناءه دائمًا بحفظ المزامير، كذلك اهتم بشرحها. وهو يفسرها بأسلوب روحي رائع، بسيط وسلس يمكن استيعابه بسهولة. وهذا الكتاب من الكتب المعزية جدًا. نتمنى لك عزيزي القارئ رحلة ممتعة ومشبعة..
بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم العذراء.
القمص بطرس بطرس جيد
مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث
البابا شنوده الثالث
الفصل الأول لماذا ارتجت الأمم (مز2)
لماذا ارتجت الأمم[1]
[مز 2]
المزمور الثاني هو أحد مزامير صلاة باكر. نفهمه بمعنى عام.
وأيضًا هو نبوة عن السيد المسيح في أسبوع الآلام.
وقد استخدمه الآباء الرسل والتلاميذ في (أع4: 25–27) كنبوّة عن السيد المسيح، وما أصابه من هيرودس وبيلاطس وشعوب إسرائيل.
بل يقول المرتل - بروح النبوة – عن جميع المؤامرات التي قامت ضد السيد المسيح خلال فترة التجسد على الأرض..
كما يصلح أيضًا أن يقال عن كل الذين يعادون الله بالباطل، ويقومون ضد مسحائه، خدامه من الآباء الكهنة، وكل من مسحه الله خادمًا يحمل رسالته.. وهكذا يقول المرتل:
لِمَاذَا ارْتَجَّتِ الأُمَمُ، وَتَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟
قَامَ مُلُوكُ الأَرْضِ، وَتَآمَرَ الرُّؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الرَّبِّ وَعَلَى مَسِيحِهِ! إنه يتعجب كيف أن البشر يقومون ضد خالقهم، يتآمرون على الله نفسه الذي منحهم نعمة الوجود، ومنحهم العقل الذي يفكرون به ضده، كما منحهم القوة التي يحاربونه بها!!
إنها صورة من خيانة البشر. لهذا يتعجب داود. لقد قاموا على الرب وعلى مسيحه، يريدون التخلص منهما قائلين: "لِنَقْطَعْ قُيُودَهُمَا، وَلْنَطْرَحْ عَنَّا رُبُطَهُمَا".. عجيب هذا في ثورتهم ضد الله.
يعتبرون الدين أغلالًا تقيدهم، ونيرًا لا يحتملونه.
هكذا يقول الخطاة الذين تستعبدهم شهوات العالم، فيشعرون أن وصايا الله أغلالًا يجب أن يقطعوها ويتخلصوا منها ليصيروا (أحرارًا) يفعلون ما يشاؤون!! وهذا ما يقوله الوجوديون: "من الخير أن الله لا يوجد، لكي نحس نحن بوجودنا! إن وجود الله يعطل وجودنا"!
وهذا ما فعله الشيوعيون أيضًا وكل الملحدين.
اعتبروا الله نيرًا طرحوه عن أعناقهم، بل طرحوه عن الكل، وأرغموا الناس أن يرفضوا الله معهم. ما لزوم الله؟! وما لزوم الدين؟! وما لزوم الوصايا والكتب المقدسة؟!
وسلكوا في أساليب متعددة من التجديف على الله، ومن قيادة المجتمع كله إلى رفض الله، حتى التلاميذ الصغار في المدارس، كانوا يغرسون في أذهانهم أن الله غير موجود، وأن الدين هو أفيون للشعوب يتخدرون به، وينسون الواقع الذي يعيشون فيه.
ولكن ما الذي حدث نتيجة لهذا التجديف والرفض؟ يقول المرتل:
"اَلسَّاكِنُ فِي السَّمَاوَاتِ يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ!"
كل ثوراتهم على الله هي لون من العبث، هيهات أن تهز ملكوت الله!! هيهات أن تُهز الكنيسة التي أسسها الله على صخرة الإيمان، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا (مت 16: 18).
ترك الله هؤلاء الشيوعيين الملحدين، حتى زالت دولتهم، وانقسموا على بعضهم البعض، وتشتتت جماعاتهم، وعاد الإيمان إلى نفوس الرافضين، وظهر الإيمان الكامن في قلوب الخائفين. أما الملحدون بالحقيقة، فإن "اَلسَّاكِنُ فِي السَّمَاوَاتِ يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ". إنه درس لجميعنا أن نظل ثابتين، لا نتزعزع أمام قوى الشر.
بل ننتظر الرب، الذي لا بد أن يستهزئ بقوة هؤلاء. في يوم الجمعة العظيمة كان كل ذلك الجمع المحتشد، يصيح "اصْلِبْهُ! اصْلِبْهُ!". وكانوا يهزأون قائلين: "خَلَّصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا!" (مر15: 31).
وكانوا يظنون بصلبهم للمسيح أنهم قد تخلصوا منه، ومن شعبيته التي يكرهونها، ومن تعاليمه ومعجزاته التي تجذب الناس إليه؛ لذلك قاموا على الرب وعلى مسيحه وكان هدفهم "لنطرح عنّا نيرهما"، ولكن الذي حدث كان عكس ذلك. كيف؟ "اَلسَّاكِنُ فِي السَّمَاوَاتِ يَضْحَكُ. الرَّبُّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ".
ومتى استهزأ الرب بهم؟ كان ذلك يوم قيامته.. استهزأ بالقبر والحجر العظيم الذي يغلقه. واستهزأ بالأختام وبالحراس وبالجنود! واستهزأ بهم في دفعهم رشوة للجنود ليقولوا: "قُولُوا إِنَّ تَلاَمِيذَهُ أَتَوْا لَيْلاً وَسَرَقُوهُ وَنَحْنُ نِيَامٌ!" (مت28: 13).
حقًا إن الساكن في السماوات يضحك بهم!! لأنه ما منفعة التلاميذ في أن يسرقوا جسده وهو ميت، هذا الذي هربوا من الدفاع عنه وهو حي؟! وما قوّتهم وما جسارتهم في أن يأتوا إلى القبر المغلق، وعليه حجر كبير، وحوله حراس مدججون بالسلاح، بينما كان هؤلاء التلاميذ خائفين في علِّيَّة مُغَلَّقة عليهم! ولا مصلحة لهم في سرقة جسد ميت، ولا قدرة لهم على ذلك!!
في كل ثورة الناس على الله، السماوات تستهزئ بهم. هؤلاء الثائرون على الله ومسيحه، ينطبق عليهم قول الشاعر:
كناطحٍ صخرةً يومًا ليوهنها .:. فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
والناس الذين يقفون ضد الله، لم يكونوا فقط وقت الصلب، أو أثناء مؤامرات الكتبة والفريسيين وشيوخ الشعب، بل هم موجودون في كل زمان وكل مكان..
هؤلاء هم الذين يتهمون الله، ويحمّلونه مسئولية كل متاعبهم!
في كل فشلهم، وفي كل مصائبهم، يقولون: لماذا يفعل بنا الرب هكذا؟! بل إن رسب تلميذ لأنه لم يذاكر، يقول: لماذا سمح الله أن أرسب؟! بل إن قُبِض على لص وهو يسرق، ما أسهل أن يحتج أهله على هذا قائلين: لماذا يا رب جعلته يُسجن؟! هؤلاء الذين يبغضون الله، إنما يبغضونه بلا سبب من الله ضدهم، لذلك تعّجب المرتل قائلًا في المزمور: "لِمَاذَا ارْتَجَّتِ الأُمَمُ؟! لماذا تَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟"
والبعض قد يقوم ضد الله، بسبب الكبرياء، أو شهوات خاصة.
مثل الشيطان الذي أراد أن يرتفع إلى علو السماء، ويصير مثل العلي (إش14: 13، 14).. أو مثل آدم وحواء اللذين - بإغراء من الشيطان – أرادا أن تنفتح أعينهما ويصيرا مثل الله، عارفين الخير والشر (تك3: 5).. أو مثل بناة برج بابل، الذين أرادوا أن يبنوا لهم برجًا رأسه بالسماء، ويصنعوا لأنفسهم اسمًا (تك4:11).
والعجيب أن البعض يقف ضد الله، ظانًا أن الله سينافسه، أو يأخذ منه شيئًا.
مثال ذلك هيرودس لما سمع من المجوس عن ميلاد المسيح ملكًا لليهود. يقول الكتاب: "فَلَمَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ اضْطَرَبَ وَجَمِيعُ أُورُشَلِيمَ مَعَهُ فَجَمَعَ كُلَّ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَكَتَبَةِ الشَّعْب، وَسَأَلَهُمْ: أَيْنَ يُولَدُ الْمَسِيحُ؟" (مت2: 3-4). بل أكثر من هذا أمر بقتل كل أطفال بيت لحم، ليتخلص من المسيح!!
وأحيانًا يقف البعض ضد الله بسبب الجهل.
يجهل حكمة الله في تصرفه، فيقف ضده، بينما لو عرف الحقيقة لشكر الله. وصدق المثل الذي يقول: "الناس أعداء ما جهلوا".
المهم أن النفس في عداوتها لله، تفقد سلامها الداخلي.
مثلما حدث لهيرودس لما سمع بميلاد المسيح. ومثلما حدث لرؤساء اليهود لما عرفوا أن السيد المسيح أقام لعازر من الموت؛ فعقدوا مجمعًا وقالوا: " مَاذَا نَصْنَعُ؟ فَإِنَّ هذَا الإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً؟!" (يو11: 47).
وهكذا ارتجت الأمم، ليس رؤساء اليهود فقط، بل فيما بعد أباطرة وقياصرة الرومان أيضًا. ألقوا القبض على الآلاف وسجنوهم، وقتلوا من قتلوه، وعذّبوا من عذّبوه. "وَتَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ.. وَتَآمَرَ الرُّؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الرَّبِّ وَعَلَى مَسِيحِهِ".
ولكن ما الذي نتج عن تآمر الشعوب؟ يقول الكتاب:
"الساكن في السموات يضحك بهم؟؟". هزأ الله بكل قوتهم. وإذا بالمسيحيين العزل الواقعين تحت الاضطهاد، ينتصرون على الإمبراطورية الرومانية بكل سطوتها وكل قسوتها، ويصدر مرسوم ميلان سنة 313م. فيسمح للمسيحية بالحرية الدينية، بل صارت الدولة الرومانية مسيحية، وصار الأباطرة مسيحيين..
حِينَئِذٍ يُكَلّمُهِم بِغَضَبِهِ، وبِرِجْزِهِ يَرْجُفُهُمْ.
هذا هو الذي حدث. وليتنا نقرأ في التاريخ في نهاية الولاة والأباطرة الذين اضطهدوا المسيحية، وكيف ماتوا بميتات شنيعة. وبعضهم انتهت حياته بالجنون. ماذا كانت نهاية نيرون ودقلديانوس؟!
بعد هذا يقول المرتل نبوءته، عن السيد المسيح:
"أنا أقمت منه ملكًا على صهيون جبل قدسه، لأكرز بأمر الرب. الرب قال لي أنت ابني، وأنا اليوم ولدتك".
هنا ملكوت الله الحقيقي، الذي ترمز إليه كلمة "صهيون". ليس بالمعنى الحرفي، بل بالمعنى الرمزي. الملكوت الذي تأسس نتيجة للكرازة. هذه التي بدأ بها السيد المسيح، إذ كان يكرز ببشارة الملكوت (مت4: 17). ويقول للناس: "قَدْ كَمَلَ الزَّمَانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ اللهِ، فَتُوبُوا وَآمِنُوا بِالإِنْجِيلِ" (مر1: 15). وكما قال الله للسيد المسيح: "أَنْتَ ابْنِي". وقال للناس عنه: "هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ" (مت3: 17). هكذا أنت أيضًا دعاك الله ابنًا له، وصيّرك ملكًا على قلبك، لتعلن ملكوت الله على مشاعرك وأحاسيسك. لكي تكرز بأمر الرب. فهذه رسالتك في الحياة.. وفيما تكرز تجد أمامك وعد الله، يقول لك: "سلني فأعطيك الأمم ميراثًا، وسلطانك إلى أقصاء الأرض".
وقد تم هذا الوعد بالنسبة إلى السيد المسيح، فلما رفضه اليهود، وتفكروا عليه بالباطل، قبلته الأمم، وانتشر الإيمان به في كل أقطار الأرض، لكي يرعاهم "بقضيب من حديد". أما الخارجون عليه من الأمم فإنه "مثل آنية الفخار يسحقهم"..
وأنت إن صرت ابنًا حقيقيًا لله، سيعطيك الأمم ميراثًا". إن كان الأمم يرمزون للشعوب الغريبة، فكل ما يكون فيك غريبًا من رعوية الله، يعطيك الله إياه ميراثًا، ويمتد سلطانك الروحي إلى أقاصي الأرض، إلى كل ما تصل إليه إرادتك وكرازتك. لقد قيل في المزمور: "قامت ملوك الأرض على الرب وعلى مسيحه".
وأنت أيضًا – كمسيحي – تعتبر مسيحًا للرب.
أنت الذي نلت المسحة المقدسة في سر الميرون، وقال عنك الكتاب وعن أخوتك: "فَلَكُمْ مَسْحَةٌ مِنَ الْقُدُّوسِ" (1يو2: 20، 27). وقديمًا كان كل من يُمسح بالدهن المقدس، يدعى مسيح الرب، كما قال داود عن شاول الملك (1صم 24: 6).
وكمسيح للرب، اكرز بأمر الرب، ولا تخف من القائمين عليك.
فهوذا الرب يقول لك: "لاَ تَخَفْ، بَلْ تَكَلَّمْ وَلاَ تَسْكُتْ، لأَنِّي أَنَا مَعَكَ، وَلاَ يَقَعُ بِكَ أَحَدٌ لِيُؤْذِيَكَ" (أع18: 9، 10). "لاَ تَخَفْ مِنْ وُجُوهِهِمْ، لأَنِّي أَنَا مَعَكَ لأُنْقِذَكَ، يَقُولُ الرَّبُّ" (إر1: 8).. "فَيُحَارِبُونَكَ وَلاَ يَقْدِرُونَ عَلَيْكَ، لأَنِّي أَنَا مَعَكَ، يَقُولُ الرَّبُّ" (إر1: 19). بغرور الأشرار يقولون: "لنقطع أغلالهما، لنطرح عنا نيرهما"، ولكنه كلام غرور وادعاء، لا يقدرون عليه. وهكذا يشرح المرتل خبرته في (مز3) فيقول: " كَثِيرُونَ يَقُولُونَ لِنَفْسِي: لَيْسَ لَهُ خَلاَصٌ بِإِلهِهِ. الرب ناصري، لاَ أَخَافُ مِنْ رِبْوَاتِ الجموع المحيطين بي، القائمين عليَّ".
[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 24 أبريل 1998م
الفصل الثاني الــرب يـرعــاني
الرب يرعاني[1]
[مز 22] (23)
هذا المزمور هو من مزامير الساعة الثالثة.
ويسمى مزمور الراعي، وهو مزمور محبوب من جميع الناس. وله ميزة أنه لا توجد فيه أية طلبة. المرتل لا يطلب فيه شيئًا. ولا يوجد فيه اعتراف بالخطية. ولا توسل لنوال الغفران، ولا حزن ولا انسحاق. إنما يشمل إحساسًا بوجود الله في حياة الإنسان. فرح برعاية الله وعنايته فيقول في ذلك:
"الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراعٍ خضرٍ يربضني، وإلى ماء الراحة يوردني".
كون أنك تشعر أنك محتاج إلى رعاية، هي حالة من الاتضاع. وكون أنك تشعر أن الله هو الذي يرعاك، لا شك أن ذلك يغرس في نفسك شعورًا بالاطمئنان، وفيه شكر لله، وسلام قلبي..
عبارة الرب يرعاني معناها أنني لست وحدي.
أنا لا أعيش في هذه الدنيا وحيدًا متعبًا، بعيدًا عن المعونة.. إنما الرب يرعاني.
الناس لهم من يهتم بهم، ولهم من يسندهم ويحميهم ويرعاهم، أما أنا فلي الله نفسه. الله نفسه هو الذي يرعاني.
ولأن الله هو الذي يرعاني، لذلك لا يعوزني شيء.
ما دام الله يرعاني، فسوف أعيش في سلام وفي اطمئنان، وفي فرح. لا يدخل القلق إلى قلبي، ولا الاضطراب.
هذا المزمور أيضًا يتحدث عن علاقة خاصة مع الله. الرب يرعانا كلنا، ويرعى العالم كله. وهذا حق. ولكني هنا أتكلم عن علاقة خاصة لي مع الله. أنا شخصيًا لي علاقة مع الله. وأنا شخصيًا كفرد، كإنسان أشعر بيد الله في حياتي، وأشعر بأن الله يرعاني، وأنه يهتم بي. هذه مشاعر قلب فرحان بربنا، قلب حاسس بربنا في حياته، شاعر بوجود ربنا في حياته، وبحفظ الله، وستر الله، ومعونة الله، واهتمام الله به بصفة خاصة.
يعني أنك لست تائهًا أو ضائعًا وسط ملايين من البشر الذين يهتم بهم الله.
إنما لك علاقة خاصة مع الله. لست ضائعًا وسط الزحمة. ما أكثر وجود رعاة لهم آلاف من الناس يرعونهم. وعلى الرغم من هذا يوجد واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر يضيعون وسط زحام الناس من حولهم. لا يحس بهم الراعي لكثرة مشغولياته!! أما أنا فالرب يرعاني. وفي وسط ملايين الملايين من مخلوقاته، يعطيني اهتمامًا خاصًا في حياتي.
بسبب المحبة التي بيني وبينه.
هذه نقطة عملية مفرحة بلا شك. يفرح قلبي طبعًا إن شعر بهذا..
وهذه النقطة المفرحة نجدها في القداس الغريغوري:
ففي صلواته نجد علاقة خاصة بين الفرد وبين الله. يقول له: "أقمت السماء لي سقفًا. ومهدت لي الأرض لكي أمشي عليها". يقول لي وليس لنا..
هذه السماء أقامها الله لأجلي أنا، ومهّد الأرض من أجلي أنا..
ويقول أيضًا: "من أجلي ألجمت البحر، ومن أجلي أخضعت طبيعة الحيوان. "أرسلت لي الأنبياء من أجلي". شعورك بعلاقة خاصة بينك وبين الله.
الله ليس فقط إلهًا للعالم كله، وأنت مجرد شيء بسيط في العالم.
وإنما هو أيضًا إله لك أنت بالذات. ربنا كما صُلب ومات لأجل العالم، هو كذلك صُلب ومات لأجلك أنت. من أجلك أنت بالذات، لأجل خطاياك الخاصة "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ" (يو3: 16). وهكذا أحبك أنت كفرد "الرب يرعاني". شعور جميل من رعاية الله. وربنا فعلًا يحب الرعاية. والرعاية لها معنى خاص عنده.
ويقول: "أَنَا هُو الرَّاعِي الصَّالِحُ، وَالرَّاعِي الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ" (يو10: 11). والرسول يتكلم عن الله فيقول عنه: "رَاعِي نُفُوسِكُمْ وَأُسْقُفِهَا" (1بط 2: 25). ثم يسميه أيضًا "رَئِيسُ الرُّعَاةِ" (1بط5: 4). وفي سفر حزقيال النبي يقول: "أَنَا أَرْعَى غَنَمِي وَأُرْبِضُهَا، يَقُولُ السَّيِّدُ الرب وَأَطْلُبُ الضَّالَّ، وَأَسْتَرِدُّ الْمَطْرُودَ، وَأَجْبِرُ الْكَسِيرَ، وَأَعْصِبُ الْجَرِيحَ" (حز34: 15-16).
والله أقام في الأرض رعاة من رجال الكهنوت.
ويقول القديس بولس الرسول عن ذلك لأساقفة أفسس: "اِحْتَرِزُوا اِذًا لأَنْفُسِكُمْ وَلِجَمِيعِ الرَّعِيَّةِ الَّتِي أَقَامَكُمُ الرُّوحُ الْقُدُسُ فِيهَا أَسَاقِفَةً، لِتَرْعَوْا كَنِيسَةَ اللهِ الَّتِي اقْتَنَاهَا بِدَمِهِ" (أع20: 28).
إنه عمل رعاية، وعصا رعاية تُعطى للأسقف في يوم سيامته.. وفي الواقع إن الراعي له في الكنيسة مكانة معينة. سأشرح قليلًا عنه لنفهم مكانتها.
كثير من الناس الذين ائتمنهم الله على شعبه، جعلهم يشتغلون بالرعي
أولًا: موسى تهذب بكل حكمة المصريين (أع7: 22). ولكن هذا لم يكن كافيًا. تربى في القصر الملكي بكل تربية أولاد الملوك. وتدرب على أمور من قيادة الجيش، ولكن كل ذلك لم يكن كافيًا. فأخذه الله وجعله يرعى الغنم لمدة أربعين سنة، فلماذا؟
لأن مهنة الرعي تعطي عواطف الحب والحنان والشفقة، والهدوء والطيبة. الراعي يحب غنماته، ويشفق عليها كل الإشفاق ويقودها إلى العشب الأخضر وإلى الماء.
وتوجد علاقة طيبة وارتباط بين الراعي وغنمه.
تجد الراعي يمشي، والغنم تتبعه وتمشي وراءه، حيثما يسير، غنماته معه. في كل اتجاه يتجه إليه. "خرافي تسمع صوتي وتتبعني". تميز صوتي وتتبعني "أَمَّا الْغَرِيبُ فَلاَ تَتْبَعُهُ بَلْ تَهْرُبُ مِنْهُ، لأَنَّهَا لاَ تَعْرِفُ صَوْتَ الْغُرَبَاءِ". هكذا قال الرب (يو10: 4، 5).
لو كان أحد فيكم رأى زريبة غنم، وقد فتح الراعي بابها، سيرى أن كل الأغنام متجهة بأنظارها إليه. تعرفه وتركز وجهها عليه، وتتعلق به. والأغنام أيضًا تميّز صوته وتحبه، وهو يحبها. والراعي يبذل نفسه عن الخراف.
جميلة عبارة "تسمع صوتي، ولا تسمع لصوت الغريب". يظن البعض أن الأغنام لا تفهم! كلا، إنها تميز صوت راعيها، وتحبه، وتنظر إليه، وتسعى وراءه وتتبعه حيثما سار..
إن الأغنام لو كانت ترعى في أرض معشبة، وتجد أن راعيها قد ترك المكان، تترك العشب وتسعى وراءه. إن الراعي عندها أهم من العشب ومن الطعام.. إنه قلبها المحب اللطيف. والراعي يمسك عصا، يقود بها غنمه، لا يضرب بها أبدًا. إنما يرشد بها. وفي إرشاده للغنم، قد يمسها بعصاه، ولكنه لا يضربها. لذلك قال داود في المزمور: "عصاك وعكازك، هما يعزيانني".
سبب تعزية لي. متى تكون العصا سبب تعزية؟ هذا أمر يعرفه الرعاة، وتعرفه الرعية. إن عصا الراعي ليست للتأديب أو للأذى، إنما للإرشاد والتوجيه. بطريقة خفيفة. والخراف تحب عصا الراعي حينما تلمس أجسادها..
تدرب كثير من الآباء على الرعي، قبل أن يدخلوا إلى الرعاية.
داود النبي – مثل موسى النبي – تدرب في الرعي. هذا الذي قال: "الرب يرعاني"، كان من أنجح الرعاة في التاريخ. ولم يكن راعيًا عاديًا! كان يمشي معهم بالمزمار والقيثار، يغني لهم أغانٍ حلوة. لم يحدث أن غنيمات قد سمعت راعيًا حلو الصوت مثل داود! إنه راعٍ موسيقي، راعٍ يغني، راعٍ عازف. إنه الراعي الذي كان يأسر أسماع غنيماته، وليس فقط يأخذها إلى الخضرة. كانت الغنيمات تأكل، وتسمع الموسيقى في نفس الوقت. أية غنيمات تمتعت بمثل هذا؟!
حينما يقول داود "الرب يرعاني" إنما يقولها وهو فاهم تمامًا معنى الرعاية. من النوع الجميل الذي تدرب عليه هو نفسه.
إن النفس المحبة لله تقول في سفر النشيد: "أَنَا لِحَبِيبِي وَحَبِيبِي لِي. الرَّاعِي بَيْنَ السَّوْسَنِ" (نش6: 3).. يرعاني وسط الورود والزنابق. يرعى النفس. لذلك حينما نتكلم عن كلمة (الراعي)، إنما نتكلم عن كلمة كبيرة وعميقة.
داود راعي الغنم، والله رعاه
والقديس أغسطينوس يقول لله وهو يصلي من أجل شعبه: أنا يا رب بالنسبة إليهم الراعي. ولكن بالنسبة إليك مجرد خروف صغير من قطيعك. أطلب إليك أن ترعاني وترعاهم.
الله هو الراعي المهتم بالكل
إنه الراعي الصالح، الذي لما كان يرعى مائة، وواحد منها قد تاه. ترك التسعة والتسعين، وذهب يبحث عن الواحد؛ أي لا يترك أحدًا من رعيته. بل يهتم بالكل. يبحث عن الضال في وسط الجبال والتلال "طَافِرًا عَلَى الْجِبَالِ، قَافِزًا عَلَى التِّلاَلِ" (نش2: 8)، يبحث عن رعيته. إنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف.
الكتاب يقدم لنا أمثلة عديدة لرعاية ربنا.
رعاية الشعب في البرية. يظللهم ويقودهم بالسحاب في النهار، وبعمود النار في الليل (خر13: 21). الراعي الذي يرسل لهم المن والسلوى (خر16: 15)، ويفجر لهم الماء من الصخرة (خر17: 6). الراعي يقود إلى مراعٍ خضراء. الذي كان يرعى يونان وهو في بطن الحوت (يون1: 17)، ودانيال وهو في جب الأسود (دا 6: 22). ويرعى الثلاثة فتية وهم في أتون النار (دا 3: 28). ويرعى المسبيين وهم عند أنهار بابل. إن أمثلة رعاية الله لا تدخل تحت حصر..
وحينما نقول (الرب يرعاني) إنما نقصد يرعاني ماديًا وروحيًا.
تشمل رعايته الأمرين معًا. يرعى الجسد والروح، وكذلك النفس والعقل والفكر. إنها رعاية شاملة لذلك قال داود في المزمور..
لا يعوزني شيء..
كل إنسان يمكنه أن يقول، إن كثيرًا من الناس يرعونني. أبي وأمي يهتمون برعايتي في أمور الجسد، فيعطونني كفايتي من طعام وشراب وكساء. ويوجد مدرسون في المدارس يرعونني من جهة الثقافة والعلم والتهذيب. كذلك الدولة ترعاني، تعطيني الأمن والتموين والمسكن واحتياجات الحياة من كافة النواحي.
أما الله فيعطيني الكل. لا يعوزني شيء. إنه الراعي الذي تتمثل فيه كل احتياجاتي. منذ أن عرفت الله، لم أعد معوزًا شيئًا.
هو وكفى. لا أريد غيره. لا يعوزني شيء.
هو يرعاني. لذلك فإن الذين اختبروا رعاية الله، لم يعتمدوا على ذراع بشري. ولا على الذات، ولا على العالم. بل حينما آمنوا برعاية الله لهم، واختبروها في حياتهم، لم يعودوا معوزين لشيء.
ولا يعوزني لأحد. ولا أتكل على ذراع بشر
هو الرب الذي يرعاني، ولا يعوزني شيء
إنها عبارة يقولها الفرد، وتقولها الكنيسة، ويقولها العالم كله. هو يرعانا، ولسنا محتاجين لشيء. لأن الله في رعايته لا يغفل شيئًا من احتياجات الإنسان. بل يقول: "أَبَاكُمُ السَّمَاوِيَّ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هذِهِ كُلِّهَا. لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ" (مت6: 32-33).
كل هذه تزدادونها. لا يترككم محتاجين لشيء. الله الذي يرعى عصافير السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن (مت26:6). هو يرعاكم. الذي يرعى الفراشة التي تطير، والدودة التي تدب تحت الحجر. الكل ينال من رعايته. لذلك قل هذه العبارة بإيمان: الرب يرعاني، فلا يعوزني شيء..
يقول هذه العبارة إنسان اختبر الله وعاش معه
وذاق الله، كما يقول المزمور: "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب" (مز34: 8). انظروا ماذا قال داود أيضًا في خبراته الروحية: "كُنْتُ فَتى وَقَدْ شِخْتُ، وَلَمْ أَرَ صِدِّيقًا تُخُلِّيَ عَنْهُ، وَلاَذُرِّيَّةً لَهُ تَلْتَمِسُ خُبْزًا. (مز37: 25). جرّبت ربنا وعرفته.
معاملات الله ليست أشياء أقرأها في الكتاب المقدس، بل هي في حياتي العملية.
جربتها وعشتها. ومن خبراتي أقول: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. ينبغي أن تؤمن أن الله يرعاك لكي تطمئن من الداخل.
مسكين الإنسان الذي لا يشعر أنه تحت رعاية الله. وأنه محتاج لأحد. كلا. إن الله فيه الكفاية. لكي يذكّر السيد المسيح تلاميذه بالرعاية الإلهية، قال لهم ذات مرة: "حِينَ أَرْسَلْتُكُمْ بِلاَ كِيسٍ وَلاَ مِزْوَدٍ وَلاَ أَحْذِيَةٍ، هَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالُوا: لاَ" (لو22: 35).
أليس الله يرعى الراهب المتوحد في أعماق الجبل وسط الوحوش والدبيب، وعدم وجود لوازم الحياة الأساسية! الله يجعل قوانين الطبيعة في رعايتك. النبات والحيوان من أجل رعايتك. في النهار مثلًا تقول: هذه الشمس أرسلها الله لرعايتي، تعطيني النور والدفء. وهكذا النجوم بالليل. كلها لي. وكذلك القمر الجميل الهادئ.
ولذلك فإن أولاد الله الذين آمنوا برعايته، سلموا له الحياة بالكامل.
كل منهم يقول: أنا لا أقود نفسي، ولا أرعى نفسي، لأن الرب يرعاني. أسلم له نفسي بالكامل، وأنا مطمئن في الأحضان الإلهية، شاعرًا بالقلب المحب الذي أسند عليه رأسي. إنها حياة التسليم إيمانًا برعاية الله.
احذر أن تشك في أي وقت، مهما كانت الظروف.
بطرس الرسول مشى مع الرب على الماء. "وَلكِنْ لَمَّا رَأَى الرِّيحَ شَدِيدَةً خَافَ. وَإِذِ ابْتَدَأَ يَغْرَقُ" (مت14: 30). نسي أن الرب يرعاه، فبدأ يسقط في الماء. فقال له الرب: "يَا قَلِيلَ الإِيمَانِ، لِمَاذَا شَكَكْتَ؟" (مت14: 31). هل الرب يرعاك وأنت ماشٍ في الطريق، ولا يرعاك وأنت ماشٍ على الماء؟! نعم، إنه يرعاني حتى وأنا في جوف الحوت.. في كل مكان.
إن الذي يقول الرب يرعاني، يمتلئ بالإيمان.
الرب يرعاني مهما كانت الظروف الخارجية صعبة..
داود قال هذه العبارات، على الرغم من كل فترات الذل والضيق التي قاساها، وبخاصة من شاول الملك الذي كان يطارده في كل مكان ليقتله. وجُرِّبَ من أبشالوم ابنه الخائن، وجرب الحروب والكروب. وفي كل ذلك كان يقول: الرب يرعاني.
ليس معنى رعاية الرب، أن يجعله يسير في الطريق الواسع!
كلا بل يرعاه في وسط الضيقة. لذلك يقول:
"هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقيّ"
إذًا هناك مضايقون. ويقول له أيضًا: "إذا سرت في وادي ظل الموت، لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي".
إذًا هناك ظل الموت، وهناك مضايقون. ومع ذلك هو شاعر أن الرب معه.
ليست عبارة أن الرب معي، معناها أن يمنع عني ظل الموت، أو يمنع عني المضايقين! كلا أبدًا. كل هذه المضايقات موجودة، ولكنه معي. وأنا مسرور وسط الضيقات. لكن قبل أن يتكلم عن وادي ظل الموت وعن الضيقات، تكلم أولًا عن الخبرات الجميلة فقال:
في مراعٍ خضر يربضني. إلى ماء الراحة يوردني.
يقودني إلى المراعي الخضراء. حقًا إن الله حينما خلق الإنسان، وضعه في جنة. والعروس في سفر النشيد تقول إنه يرعاها بين السوسن (نش6: 3). ولكن ما هي المراعي الخضراء يا داود؟ يقول:
المراعي الخضراء هي وسائط النعمة التي أعيش فيها.
وهي أيضًا أسرار الكنيسة السبعة. لقد مهّد الله لي كل وسائط النعمة. أنا شاعر أنني سائر في مراعٍ خضراء. أتغذى بالروحيات، كما أتغذى بالجسديات. سعيد.. في مراعٍ خضرٍ يربضني؛ في عمل النعمة، في عمل الروح، في عمل الكنيسة.
عبارة (المراعي الخضر) تشير إلى معنى آخر
تشير إلى أن السائر في طريق الرب، يشعر بلذة في طريقه، وأن وصية الرب ليست ثقيلة (1يو5: 3). أو أن الفضائل ضاغطة على النفس!
لا، بل أولاد الله يشعرون بأن وصية الرب مضيئة تنير العينين (مزمور19). فيقول كل منهم أن الله يرعى حياته الروحية في مراعٍ خضراء. ويقول أيضًا:
وإلى ماء الراحة يوردني.
والماء في الكتاب المقدس يرمز إلى عمل الروح القدس. ولهذا يقول الرب: "مَنْ آمَنَ بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ. قَالَ هذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ" (يو7: 39).
الماء الذي يعطي الحياة. وعن المؤمن "فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه" (مز1). إلى هذا الماء الحي يوردني.
لذلك فإن الكنيسة تبارك الناس بالماء. في آخر كل قداس.
وأول ماء راحة دخلته في حياتك، هو ماء المعمودية.
يغسلك من القديم كله "غُسْلِ الْمِيلاَدِ الثَّانِي" (تي3: 5). وكما قال القديس حنانيا الدمشقي لشاول الطرسوسي بعد دعوة الرب له: "لِمَاذَا تَتَوَانَى؟ قُمْ وَاعْتَمِدْ وَاغْسِلْ خَطَايَاكَ" (أع22: 16).
إنه ماء الراحة. يريحك من كل الخطايا القديمة. يريحك من الإنسان العتيق (رو6:6). هذا أول ماء راحة بالنسبة لابن الله. وماذا بعد؟
هناك أنواع أخرى من ماء الراحة.
أحيانًا تخطئ. وماء الدموع يغسلك. ويكون ماء راحة. السيد المسيح قال للمرأة السامرية: إن ماء العالم، من يشرب منه يعطش. ولكن الماء الذي أعطيه أنا، من يشرب منه لن يعطش إلى الأبد (يو4: 13، 14).
هذا هو ماء الراحة الذي يروي الإنسان. ولذلك يقول في المزمور: "كأسي ريا". إن كانت نفسك عطشانة إلى هذا الماء، "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (مت5: 6).
هناك ماء راحة قال عنه داود النبي في المزمور: "كَمَا يَشْتَاقُ الإِيَّلُ إِلَى جَدَاوِلِ الْمِيَاهِ، هكَذَا تَشْتَاقُ نَفْسِي إِلَيْكَ يَا اللهُ" (مز42: 1) اشتاقت نفسي إليك يا الله، كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء. أنت يا رب هو الماء الحي. أنت هو ينبوع المياه الحية (إر2: 13). أنت ماء الراحة الذي يرويني.
في مراعٍ خضرٍ تربضني، وإلى ماء الراحة توردني. أي إنني حينما أسير معك أجد الراحة الكاملة. وأجد السعادة الكاملة، ليس كما يظن البعض أن من يسير مع الله يتعب!! أو أنه يُحرم من ملذات الدنيا ونعيمها. أبدًا فإنني حينما أسير معك يا رب، أستريح في المراعي الخضراء، وفي ماء الراحة. وماذا يقول بعد هذا؟ يقول:
يرد نفسي. يهديني إلى سبل البر.
إن داود النبي يقول في اتضاع: إنه على الرغم من أن الله يقودني إلى مراعٍ خضراء، ولكنه يتركني إلى حرية إرادتي. وبحرية إرادتي قد أضل وأخطئ. فماذا يفعل الرب معي وأنا هكذا؟ يقول: "يرد نفسي. يهديني إلى سبل البر" وسبل البر؛ تعني كل الطرق المؤدية إلى البر.
يرد نفســي
كل إنسان معرض للخطأ وله ضعفاته. وليس أحد بلا خطية، ولو كانت حياته يومًا واحدًا على الأرض. "إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُّ أَنْفُسَنَا وَلَيْسَ الْحَقُّ فِينَا" (1يو1: 8). نحن الغنيمات التي ترعى في البرية، تسرح هنا وهناك. وقد تستهويها أرض معشبة فتسرع إليها، فإن رأى الراعي أنها تبعد عنه يردها إليه.
الأصل أننا فيه، ثابتون فيه. فإن بعدنا عنه، يردنا إليه.
إننا نفخة من فيه، سكنت في هذا التراب. لسنا من هذا العالم، بل قد تغرّبنا فيه. وهدفنا هو الله، في الوطن السمائي الذي سنحيا معه فيه. فإن أحببنا هذا العالم وتعلقنا بشهواته، فإن الله يبحث عنا ويردنا إليه. لذلك قال المرتل: "يرد نفسي".
عبارة (يرد نفسي) تدل على عمل الله في هدايتنا.
لست أنا يا رب الذي أستطيع أن أرد نفسي وأوصلها إلى التوبة. لأني لو كنت أستطيع ذلك، لرددتها عن الخطية من بادئ الأمر.
"أَنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ الصَّالِحَ الَّذِي أُرِيدُهُ، بَلِ الشَّرَّ الَّذِي لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ. أَرَى نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي، وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ" (رو7: 19، 23).
لذلك فأنا أصرخ وأقول: "تَوِّبْنِي فَأَتُوبَ" (إر31: 18).
أنت يا رب الذي يرد نفسي، ويهديني إلى سبل البر.
يهديني إلى سبل البر
الهداية إلى البر، هي من عمل الراعي الصالح. هذا الذي نقول له في المزمور: "طُرُقَكَ يَا رَبُّ عَرِّفْنِي. سُبُلَكَ عَلِّمْنِي" (مز25: 4). "عَرِّفْنِي الطَّرِيقَ الَّتِي أَسْلُكُ فِيهَا، لأَنِّي إِلَيْكَ رَفَعْتُ نَفْسِي" (مز143: 8). في الحق لست أعرف طريقي. بل أقول مع إرميا النبي: "عَرَفْتُ يَا رَبُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ طَرِيقُهُ. لَيْسَ لإِنْسَانٍ يَمْشِي أَنْ يَهْدِيَ خَطَوَاتِهِ" (إر10: 23).
أنت يا رب تعرف الطريق الذي يناسبني. ويكون هو الطريق الذي يتفق مع إرادتك الصالحة.
أنت الذي يهديني إلى سبل البر، لأجل اسمه..
البعض يثيرون خلافًا في ترجمة إحدى صلوات القداس الإلهي. البعض يصلون كما في الخولاجي المقدس "علمنا طرق الخلاص". والبعض يترجموها "علمنا طريق الخلاص." فما هو الصحيح؟
من جهة الله هناك طريق واحد، يخلص به العالم كله، وهو الفداء بالدم. وهذا ما قام به السيد الرب على الصليب.
ولكن علمنا الطرق التي ننال بها الخلاص
فمنها الإيمان كما قال: "لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو3: 16).
وكما قيل لسجّان فيلبي: "آمِنْ بِالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَتَخْلُصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ" (أع16: 31).
ومن طرق الخلاص المعمودية.
كما قال الرب: "مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ" (مر16:16). وكما قال بطرس الرسول في يوم الخمسين لليهود الذين آمنوا: "فَقَالَ لَهُمْ بُطْرُسُ تُوبُوا وَلْيَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى اسْمِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ لِغُفْرَانِ الْخَطَايَا" (أع 2: 38).
وكما قال حنانيا الدمشقي لشاول الطرسوسي بعد دعوة الرب له: "لِمَاذَا تَتَوَانَى؟ قُمْ وَاعْتَمِدْ وَاغْسِلْ خَطَايَاكَ" (أع22: 16). وكما قال بولس الرسول: "لأَنَّ كُلَّكُمُ الَّذِينَ اعْتَمَدْتُمْ بِالْمَسِيحِ قَدْ لَبِسْتُمُ الْمَسِيحَ" (غل3: 27).
ومن طرق الخلاص التوبة. كما قال الرب: "إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تَهْلِكُونَ" (لو13: 3، 5).
وبالإضافة إلى ذلك باقي الأسرار اللازمة للخلاص مثل سر الإفخارستيا الذي نقول عنه في القداس الإلهي "يعطى عنا خلاصًا، وغفرانًا للخطايا، وحياة أبدية لكل من يتناول منه". وأيضًا سر التثبيت؛ سر الميرون الذي به يسكن الروح القدس داخلنا، ويرشدنا إلى كل الحق. هذه هي طرق الخلاص اللازمة لكل منا. ولكنه يقول هنا:
يهديني إلى سبل البر.
فما هي سبل البر هذه التي أسلك فيها كفرد، والتي تناسب حياتي وطبيعتي وعقليتي ومواهبي؟ كثيرًا ما يقف إنسان أمام طرق متشعبة أمامه، وكلها صالحة.
ولكنه لا يدري ما الذي يختاره له الرب منها: التكريس أم الرهبنة أم الكهنوت، أم الخدمة العادية؟ هل خدمة التعليم، أم خدمة الفقراء؟ أم خدمة الأسرة وتربية الأولاد. هل خدمة الغير أم حياة القدوة الصامتة في وداعة واتضاع. أم هذه كلها. وفي كل هذا يتجه إلى الله قائلًا: "يهديني إلى سبل البر".
أنا لا أعرف في هذا الأمر بالذات: هل أتكلم أم أصمت؟ هل أوبخ مهما أصابني، وهل أنذر؟ أم أهدأ إلى نفسي وأصلي؟ هل أقدم عشوري وبكوري لهذا الاتجاه، أم ذاك؟ كل ما أعرفه أنني قد سلمت حياتي إلى يد الله، وهو يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه.
من أجل اسمه
لست أسلك في سبل البر، من أجل الناس، ولا من أجل نفسي. فلست أريد أن أكون بارًا في عيني نفسي، ولا بارًا في أعين الناس "لَيْسَ لَنَا يَا رَبُّ لَيْسَ لَنَا، لكِنْ لاسْمِكَ أَعْطِ مَجْدًا" (مز115: 1).
اهدني إلى سبل البر، حتى لا يجدف على اسمك القدوس بسببي. كما يحذرنا القديس يعقوب الرسول قائلًا: "يُجَدِّفُونَ عَلَى الاسْمِ الْحَسَنِ الَّذِي دُعِيَ بِهِ عَلَيْكُمْ؟" (يع2: 7) حتى لا يقول الناس: أهكذا أولاد الله؟ أهكذا أولاد الكنيسة ومدارس الأحد؟ أهكذا الذين يعترفون ويتناولون ويحضرون الاجتماعات الروحية؟!.
عندما أخطأ داود النبي، وأتى ناثان النبي يشعره بخطيته، وينقل إليه رسالة من الله وعقوبة منه، قال له بصدد العقوبة: "مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ بِهذَا الأَمْرِ أَعْدَاءَ الرَّبِّ يَشْمَتُونَ" (2صم12: 14).
اهدني يا رب إلى سبل البر، بروحي وجسدي. كما قال رسولك القديس بولس: "مَجِّدُوا اللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي هِيَ للهِ" (1كو6: 20). وكما قلت في العظة على الجبل: "لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ" (مت 5: 16). نعمل من أجل اسمك، كما نقول كل يوم في أول الصلاة الربانية: "ليتقدس اسمك".
أنا إذًا مع الله. وهو الذي يرعاني. إن سرت في طريقه، يقودني إلى المراعي الخضراء وإلى ماء الحياة. وإن ضللت عنه، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يقول المرتل في مزموره:
إن سرت في وادي ظل الموت، لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي.
ما هو ظل الموت؟ الخطية هي موت. كما قال الأب في عودة ابنه الضال: "لأَنَّ ابْنِي هذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ" (لو15: 24).
وأيضًا أجرة الخطية هي موت (رو6: 23). فالذي يسير في الخطية إذًا، هو يسير في وادي الموت الروحي، وفي ظل الموت الأبدي، بعد القيامة. فإن جرفني الشيطان إلى طريق الموت، أنت تنقذني. وكيف؟
عصاك وعكازك هما يعزيانني.
أنت لا تتركني وحدي في طريق الموت هذا، بل أشعر أنك معي. بعصاك تغير مسيرتي الخاطئة، وتهديني إلى سبل البر، وتنقلني من الموت إلى الحياة. فأشعر برعايتك، وأرتل قائلًا: "لاَ تَشْمَتِي بِي يَا عَدُوَّتِي، إِذَا سَقَطْتُ أَقُومُ" (مي7: 8).
أنت يا رب الذي ترفعني من سقطتي، وتفدي من الحفرة حياتي (مز103: 4). يمينك القوية تنتشلني، كشعلة منتشلة من النار (زك3: 2).
وحينئذ أغني مع المرتل وأقول: "يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا، وأحدث بأعمال الرب" (مز 118: 15-17). إنه الرب الذي ينقذني من الموت ومن وادي ظل الموت. لذلك لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي.
هناك معنى آخر لعبارة: إن سرت في وادي ظل الموت.
فلنتصور الروح خارجة من الجسد، سائرة في وادي ظل الموت إلى الأبدية. حينئذ قد تجري وراءها الشياطين، محاولة أن تمسك بها وتجذبها إلى الهاوية.
مسكينة النفس الخاطئة "وأعمالها تتبعها".
تطاردها الشياطين، وتصرخ فيها: "إلى أين أنتِ ذاهبة؟ إننا نملك فيك أشياء وأشياء. عينك كانت ملكنا بنظراتها الشريرة. لسانك كان ملكنا بكل أخطاء الكلام. فكرك كان ملكنا بكل ما كان يفكر فيه من أمورنا. أيضًا حواسك، قلبك، مشاعرك. كل ذلك نملك فيه مُلكًا واسعًا. أنت ملكنا كلك. كنا نملك وقتك، ورغباتك، وكل حياتك".
إن سارت هذه النفس الخاطئة في وادي ظل الموت، تتبعها أعمالها. يجري وراءها غضبها ويقول لها: "كل أعصابك كانت ملكًا لي". ويجري وراءها كذبها، ويقول لها: "أنا الذي تدخلت في حل مشاكلك وفي تغطية أخطائك". وتجري وراءها محبة المال، وتقول لها: "أنا التي كنت أحقق لك متعك وملذاتك، وأكنز لك على الأرض". وهكذا باقي الخطايا.
أما نفس المرتل البار، فتقول في المزمور
"لا أخاف شرًا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني".
ما عدت أخاف من الشياطين في وادي ظل الموت، لأن عصاك وعكازك كانتا بركة لي في حياتي. أرشدني وأدبني. "لأَنَّ الَّذِي يُحِبُّهُ الرَّبُّ يُؤَدِّبُهُ" (عب12: 6). ولأنني تأدبت بهما، لذلك هما يعزيانني في وادي ظل الموت. لأني تبت بهما عن خطاياي، وغسلني الرب بالتوبة، ونضح عليَّ بزوفاه، فطهرت، وغسلني فصرت أبيض من الثلج (مز50).
وهكذا لم تجد الشياطين فيَّ شيئًا، بعد أن أحبنا الرب وغسلنا من خطايانا بدمه (رؤ1: 5). وهكذا استطعت أن أقول: "إِذَا سِرْتُ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ لاَ أَخَافُ شَرًّا، لأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي" (مز23: 4).
أنت معي
أنت معي أيها المؤدب والمرشد بعصاك وعكازك.
أنت معي أيها الغافر والفادي، الذي محوت كل ذنوبي بدمك الكريم، أنت المصالح العالم لنفسك، غير حاسب لهم خطاياهم (2كو5: 19).
إن جعلتني أسير في وادي ظل الموت لا أخاف شرًا، بل ترتل الملائكة من حولي وتقول: "طُوبَى لِلَّذِي غُفِرَ إِثْمُهُ وَسُتِرَتْ خَطِيَّتُهُ طُوبَى لِرَجُل لاَ يَحْسِبُ لَهُ الرَّبُّ خَطِيَّةً" (مز32: 1). شعرت وأنا غير خائف في وادي ظل الموت ببركة عصاك التي غيرت مسلكي في الحياة وهدتني إلى سبل البر، فأشكرك يا رب لأجلها.
أنا سعيد يا رب برعايتك ومسرور بتأديبك. سعيد بالمراعي الخضراء وماء الراحة، وكذلك بعصاك وعكازك لأنهما يعزيانني. كذلك أنا سعيد بشيء آخر وهو:
هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقيَّ، وكأسي ريًا
والمائدة هي سر الإفخارستيا. هي الجسد المقدس، الذي قال عنه الرب: "إنه خبز الحياة، الخبز النازل من السماء، الذي إن أكل منه أحد يحيا إلى الأبد، ويثبت في الله، والله فيه، وتكون له حياة أبدية" (يو6).
أما الكأس الريا، فهي التي تروينا بالدم الكريم. وعن المائدة والكأس، قال الرب: "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (مت5: 6).
أشكرك يا رب على هذه المائدة الإلهية التي غذيتني بها بخبز الحياة، وأعطيتنى بها لأثبت فيك. فقلت: "مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ" (يو6: 56).
على أن هناك مائدة أخرى هيأتها قدامي
تتمثل في كل الأغذية الروحية التي تتغذى بها الروح منها: "الصلاة" التي يقول عنها المرتل في المزمور: "بِاسْمِكَ أَرْفَعُ يدي كَمَا مِنْ شَحْمٍ وَدَسَمٍ تَشْبَعُ نَفْسِي" (مز63: 4، 5).
ومن الأغذية الروحية أيضًا "كلام الله: "كما هو مكتوب "لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ»" (مت4:4& تث8: 3). وما قيل في المزمور الكبير: "مَا أَحْلَى قَوْلَكَ لِحَنَكِي! أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ لِفَمِي" (مز119: 103).
ومن الأغذية الروحية "محبة الله" هذه المحبة التي تشبع النفس وترويها. كما يقول المرتل في المزمور: "كَمَا يَشْتَاقُ الإِيَّلُ إِلَى جَدَاوِلِ الْمِيَاهِ، هكَذَا تَشْتَاقُ نَفْسِي إِلَيْكَ يَا الله. عَطِشَتْ نَفْسِي إِلَى اللهِ" (مز42: 1، 2).
وأيضًا في مزمور آخر "يَا اَللهُ، إِلهِي أَنْتَ. إِلَيْكَ أُبَكِّرُ. عَطِشَتْ إِلَيْكَ نَفْسِي، (مز63: 1). نعم أليس هو الماء الحي (إر2: 13).
المائدة الروحية أيضًا: تشمل المزامير والتسابيح والألحان والأغاني الروحية، كما قال الرسول: "بِكُلِّ حِكْمَةٍ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ، بِنِعْمَةٍ، مُتَرَنِّمِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ" (كو3: 16)، (أف5: 19).
على أن المرنم لم يقل فقط "هيأت قدامي مائدة". إنما قال أيضًا إن هذه المائدة تجاه مضايقيَّ.
تجاه مضايقيَّ
يقصد بذلك أن هذه المائدة الروحية تعطيني قوة تجاه ما أتعرض له من حروب الشياطين وجنودهم. فالصلاة والتناول ومحبة الله، كلها تعطي استحياء للفكر، فيستحي الذهن من الانشغال بأفكار شريرة.
كما أن القراءة في الكتاب المقدس وفي الكتب الروحية، تغرس في العقل أفكارًا روحية تصد عنه الأفكار الرديئة، وتوُجد فيه جوًا مقدسًا لا يتمشى مع الحواس والأفكار الرديئة..
كما أن آيات الكتاب المقدس تصلح للرد على أفكار عدو الخير، وتكون درعًا تجاه مضايقيَّ.
فمثلًا إذا حورب الإنسان بالغضب، يضع تجاه الغضب قول الكتاب: "لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُسْرِعًا فِي الاسْتِمَاعِ، مُبْطِئًا فِي التَّكَلُّمِ، مُبْطِئًا فِي الْغضب. لأَنَّ غَضَبَ الإِنْسَانِ لاَ يَصْنَعُ بِرَّ اللهِ" (يع1: 19، 20).
وإذا حورب بنظرات الشهوة، يتذكر تجاهها قول الرب: "إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ" (مت5: 28). وكذلك قول أيوب الصديق: "عَهْدًا قَطَعْتُ لِعَيْنَيَّ، فَكَيْفَ أَتَطَلَّعُ فِي عَذْرَاءَ؟" (أي31: 1).
وإذا حورب الإنسان بمحبة المال، يتذكر تجاهها قول الكتاب: "مَحَبَّةَ الْمَالِ أَصْلٌ لِكُلِّ الشُّرُورِ، الَّذِي إِذِ ابْتَغَاهُ قَوْمٌ ضَلُّوا عَنِ الإِيمَانِ، وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعٍ كَثِيرَةٍ" (1تي6: 10). وأيضًا قول الرب: "لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا اللهَ وَالْمَالَ" (مت6: 24).
وهكذا باقي الحروب الروحية يمكن أن نضع آية من الكتاب تجاه كل عثرة أو إغراء، لكي نرد بها. فيتقوى بهذه المائدة الروحية التي تصد عنه أفكار العدو. كل خطية أضع أمامها آية ترد نفسي وتهديني إلى سبل البر.
أنت يا رب لم تتركني وحدي في جهادي الروحي. بل هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقيَّ، وأعطيتني سر التوبة. وماذا أيضًا؟ يقول المرتل:
مبارك أنت يا رب من كل نعمك هذه وكل إحساناتك. إنني لست أنسى مطلقًا زيت الميرون هذا، الذي صرت به "مِثْلُ زَيْتُونَةٍ خَضْرَاءَ فِي بَيْتِ اللهِ" (مز52: 8).
مسحت بالزيت رأسي
هذه هي المسحة المقدسة، مسحة الروح القدس، بزيت الميرون المقدس. أعطيتني به روحك القدوس ليسكن فيَّ.
يبكتني على خطية (يو16: 8)، ويرشدني إلى جميع الحق (يو16: 13)، ويعلمني كل شيء، ويذكرني بكل ما قلته لنا (يو14: 26). ويمكث معي إلى الأبد (يو14: 16). وبهذه المسحة المقدسة، صرت بنعمتك هذه هيكلًا لروحك القدوس (1كو6: 19)، ودخلت في شركة الروح القدس (2كو13: 14).
[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 16 فبراير 1996م، 1 مارس 1996م
الفصل الثالث اللهم التفت إلى معونتي
اللهم التفت إلى معونتي[1]
[مز 69] (70)
التفت إلى معونتي
هذا المزمور "اللهم التفت إلى معونتي" هو من أشهر مزامير الأجبية. نصليه في صلاة باكر، وصلاة الساعة السادسة، وصلاة الستار، وصلاة نصف الليل. أي في بدء اليوم وفي نصفه وفي آخره.
إنه صلاة إنسان شاعر بضعفه، ويطلب معونة من الله. يشعر أن أعداءه أقوى منه، وهم يطلبون نفسه. وأنهم يبتغون له الشر. ويستهزئون به قائلين "نعمًا نعمًا" أو "آها آها Aha Aha" وكأنه يقول لله: "أعنّي يا الله، فأنا لست على قدر هؤلاء، الذين يقول عنهم في (مز53 أول مزامير السادسة): "الغرباء قاموا عليَّ، والأقوياء (العتاة) طَلَبُوا نَفْسِي. لَمْ يَجْعَلُوا اللهَ أَمَامَهُمْ".
وهنا يرى المصلي أن المعونة لا تأتي إلا من عند الله.
فكما يقول له في أول المزمور: "التفت إلى معونتي" يقول في آخره "أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطئ". ويقول في مزمور 123 "عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض". ويقول في مزمور 120 "رفعتُ عَيْنَيَّ إِلَى الْجِبَالِ، مِنْ حَيْثُ يَأْتِي عَوْنِي. مَعُونَتِي مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، الذي صنع السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ". ويقول هنا: "أنت معيني ومخلصي"؛ أنت معيني، وأنا في الضيقة. وأنت مخلصي الذي أخرج به من الضيقة. من فرط احتياجي ألجأ إليك لكي تعينني.
أسرع وأعني
أسرع يا رب، وأنقذني قبل أن أهلك. فأعدائي أقوى مني، وهم يطلبون نفسي. "لقد كثر الذين يحزنونني. كثيرون قاموا عليَّ. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه" (مز3). لقد تجبروا وشمتوا بي، واعتزوا أكثر مني، وهم "يبتغون لي الشر".. إن داود المرتل – في صلواته – يعرض أمر أعدائه على الله.
أنا لا أقوى على جليات الجبار فهو أقوى وأضخم مني، ولكنني "آتي إليه باسم رب الجنود. لأن الحرب للرب، والله هو الذي يدفعه إلى يدي" (1صم17: 45، 47). إن فكرت في أعدائي فسأتعب. وإن تأملت في قوتك – أنت الذي تنقذني من أعدائي – فسوف أطمئن وأفرح بك. وأقول مع الرسول: "حِينَمَا أَنَا ضَعِيفٌ فَحِينَئِذٍ أَنَا قَوِيٌّ" (2كو12: 10). أنا ضعيف بذاتي "مسكين وفقير". ولكنني قوي بك أنت "قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصًا" (مز 118: 14). لذلك يا رب أسرع وأعني، لأني أعتمد عليك كل الاعتماد.
ليخزَ طالبو نفسي
عندما تتدخل أنت في الأمر، وتسرع إلى معونتي، حينئذ "يخزى ويخجل طالبو نفسي، ويرتد إلى الوراء ويخجل الذين يطلبون لي الشر، ويرجع بالخزي سريعًا القائلون لي آها آها". لقد رجع بالخزي أنصار جليات، حينما دخل الرب إلى المعركة. وأدرك الخزي كهنة اليهود وشيوخهم، حينما قام الرب بقوة. كذلك رجع أخوة يوسف بالخزي، لما تدخل الله ونصر يوسف. والذين احتالوا على إلقاء دانيال في جب الأسود، رجعوا بالخزي لما أرسل الله ملاكه، فسد أفواه الأسود (دا 6: 22). ولم يخزوا فقط، بل هلكوا.
والخزي هو عاقبة الظالمين، حينما يتدخل الله وينصر المظلومين. على أن داود يقول في مزموره: "ليرجع بالخزي سريعًا". إنه في صراخه إلى الله، إنما يطلب السرعة في إنقاذه. وكل هذا يدل على مقدار شعوره بالتعب من كل ما يحيط به من ضيقات.
هذا المزمور يمكن أن يقوله الأفراد، وتقوله الكنيسة. بل ويقوله المسيح، وهم يصلبونه ويستهزئون به قَائِلِينَ: "يَا نَاقِضَ الْهَيْكَلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، خَلِّصْ نَفْسَكَ" (مت27: 40) وكانوا يستهزئون به وقد ألبسوه ثوبًا أرجوانيًا (مر 15: 17، 20).
والكنيسة في وقت الاضطهاد والاستشهاد الذي قاسته من الدولة الرومانية الوثنية، كانت تصرخ إلى الرب وتقول: "اللهم التفت إلى معونتي. أسرع وأعني. ليخز ويخجل طالبو نفسي". بل الكنيسة في بدء عصر الرسل، وسط مؤامرات اليهود، وإلقاء التلاميذ في السجن وجلدهم، كانت أيضًا تقول: "التفت إلى معونتي، يا رب أسرع وأعني". بل قبل القيامة كان لسان حالها يقول للرب:
قـــم حـــطّــم الشيـــطــــان |
| لا تــبــقِ لــــدولتــــه بقــيــة |
ونحن نقول في صلوات القداس وفي صلواتنا الطقسية: "قم أيها الرب الإله، وليتبدد جميع أعدائك. وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس".
على أن المصلي حينما يقول: "أعدائي"، إنما يقصد الأعداء الداخليين والخارجيين. فربما يكون أعدائي القائمين عليَّ هم داخل نفسي: أفكاري وشهواتي، ورغباتي الخاطئة، وضعفاتي وسقطاتي، ونقائصي. هؤلاء هم طالبو نفسي. وأنا أطلب إلى الله أن ترتد إلى الوراء كل هذه الشهوات والضعفات التي تطلب نفسي وتُضيّع نفسي. كما قال الرب: "وَأَعْدَاءُ الإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ" (مت10: 36).
حقًا إن أعداء الإنسان الذين في داخله، هم أخطر بكثير من الأعداء الذين في الخارج. وإذا ما ارتد إلى الوراء أعداؤه الذين في داخله، فسوف ينتصر حتمًا من الخارج.. نقول لك يا رب إن أعداءنا هم أعداؤك أنت أيضًا. هم أعداء ملكوتك، يمنعوننا عن الملكوت، ويبعدوننا عنك. هم أنصار الشيطان عدوك، الذي يزرع الزوان في كل موضع. وماذا يحدث إذا أعاننا الرب في الانتصار على هؤلاء الأعداء؟ يقول المرتل:
"ليبتهج ويفرح بك كل الذين يبتغونك."
يفرح بك
"يفرح كل الذين يبتغونك" هنا يخرج المرتل من الصلاة لأجل نفسه، لكي يهتم بالآخرين "بكل الذين يبتغون الرب". ويقول أيضًا: "وليقل في كل حين محبو خلاصك فليتعظم (فليتمجد) الرب".
إن الصلاة من أجل الآخرين، فضيلة يعلمنا الكتاب إياها. حتى في الصلاة الربية، نتكلم بصيغة الجمع، عن الآخرين. فنقول: "اغفر لنا ذنوبنا. لا تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشرير". الإنسان الروحي لا ينحصر باستمرار حول نفسه، يذكر غيره أيضًا، سواء في صلوات الطلب، أو الشكر، أو التسبيح. فيقول: "نسبحك نباركك نسجد لك".
والاهتمام بالآخرين هو عمل رجال الكهنوت أيضًا. يندمجون مع الناس في كل مشاكلهم وفي كل مشاعرهم، ويتبعون قول الرسول: "فَرَحًا مَعَ الْفَرِحِينَ وَبُكَاءً مَعَ الْبَاكِينَ" (رو15:12). وقتهم وجهدهم وانشغالهم، هو لأجل غيرهم. نعم، مبارك هو الشخص الذي في وسط آلامه، يبذل جهده ليدخل الفرح إلى نفس غيره. أو يقول كلمة عزاء للقلوب المتألمة. أو ينسى فرحه لكي يشترك في آلام الآخرين.. هكذا الأب الكاهن، وهكذا الخدام أيضًا.
وهنا يقول المصلي: "يفرح بك الذين يبتغونك". فلست أنا وحدي أفرح. حينما تسرع وتعينني. إنما يفرح بك كل الذين يبتغونك ويطلبون اسمك. ويفرح بك محبو خلاصك. يفرحون بعملك معهم، وعملك من أجلهم، ويفرحون باستجابتك لصلواتهم. ويفرحون بالخلاص الذي تقدمه لهم. سواء الخلاص من أعدائهم، أو الخلاص من الخطايا ومن الضيقات.
وهو في هذا المزمور يكرر اسم الرب كثيرًا. إنه معينه في كل خطوة من حياته، وأمام كل ضيقة. سواء قال: "اللهم"، أو قال: "يا رب". وهذه سمة ثابتة في مزامير داود.
وهنا يذكر"الفرح بالرب" وليس مجرد الفرح بالمعونة. فيقول: "يفرح بك الذين يبتغونك". وهذا ما يقوله أيضًا القديس بولس الرسول: "اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا افْرَحُوا" (في4:4).
إننا نفرح بالرب أكثر مما نفرح بكل أفراح العالم. نفرح بالرب أكثر مما نفرح بعطاياه وبالمواهب التي ننالها. نفرح بالرب وعشرته والوجود معه، أكثر مما نفرح بالفردوس نفسه. فالله هو فردوس أنفسنا. هو ما لم تره عين، ولم تسمع به أذن. "بَلْ كَمَا هُو مَكْتُوبٌ، مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ" (1كو2: 9). لذلك قال المرتل: "يفرح بك الذين يبتغونك"، ولم يقل: "الذين يبتغون خيراتك". الله هو الكل بالنسبة لنا. فيه نجد راحتنا، ولا يعوزنا معه شيء.
وليقل في كل حين محبو خلاصك: فليتمجد الرب. إن محبي خلاص الرب، يحبون في نفس الوقت الرب مخلصهم. بل الرب نفسه هو خلاصهم. كما نقول في المزمور: "قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصًا" (مز118: 14). وبهذا يتمجد الرب.
ليتمجد الرب
كل صلواتنا وطلباتنا، هي أن يتمجد الرب. يتمجد في حياتنا، وفي أعمال برنا. كما قال في العظة على الجبل: "فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ" (مت5: 16). ويقول الرسول: "مَجِّدُوا اللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي هِيَ للهِ" (1كو6: 20). إذًا كل ما نعمله من خير بالجسد أو بالروح، إنما هو لكي يتمجد الله فينا. وكلما تدخل الله في مشاكلنا وحلها، نقول عنه: "الرب قد تمجد في هذا الموضوع". أي أن قوة الله في حل مشاكلنا، كانت نتيجتها تمجيد الله نتيجة لما عمله. وكثير من الناس، في شعورهم بيد الله وتدخله وعمله، يصلون تمجيدًا في الكنيسة (ذوكصولوجية). ويتمجد في كل الظهورات الإلهية التي يعلنها لنا. يتمجد بواسطتنا نحن الذين نشكره عليها، ويتمجد بواسطة غيرنا أيضًا الذين يرون أمامهم عملًا معجزيًا يقوم به الرب، ويظهر قدرته التي تفوق فهم البشر.
حتى في خدمتنا: كلها لمجد الله، نقول له فيها: "لَيْسَ لَنَا يَا رَبُّ لَيْسَ لَنَا، لكِنْ لاسْمِكَ أَعْطِ مَجْدًا" (مز115: 1). الله يتمجد أيضًا في عمله المعجزي معنا. الله يتمجد أيضًا في توبتي وتوبة غيري وانضمامي إلى ملكوته. أما أنا فمسكين وفقير.
مسكين وفقير
مهما كبر الإنسان الروحي، وارتفعت عظمته، يقف أمام الله كمسكين وفقير. داود هذا الذي يقول: "أما أنا فمسكين وفقير" كان مسيح الرب. صب عليه صموئيل الدهن المقدس "وَمَسَحَهُ فِي وَسَطِ إِخْوَتِهِ. وَحَلَّ رُوحُ الرَّبِّ عَلَى دَاوُدَ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ فَصَاعِدًا" (1صم16: 13). ومع ذلك كان أمام نفسه وأمام الله مسكينًا وفقيرًا. داود هذا كان "جبار بأس ورجل حرب" بشهادة رجال شاول الملك (1صم16: 18). ولما كان يرعى الغنم، جَاءَ أَسَدٌ مَعَ دُبٍّ وَأَخَذَ شَاةً مِنَ الْقَطِيعِ. فخرج داود وراءه وقتله، وأنقذ الشاة من فمه (1صم17: 34، 35). ومع ذلك يقول عن نفسه إنه مسكين وفقير. فماذا نقول نحن عن أنفسنا، وليست لنا مثل هذه الشجاعة والقوة؟ داود هذا هو الذي هزم جليات الجبار الذي خاف منه كل الجيش والملك شاول أيضًا. أما داود فتصدى له وانتصر عليه، حتى هتفت له النساء بالغناء والرقص والدفوف والفرح (1صم18: 6، 7). ومع ذلك يقول عن نفسه: "أما أنا فمسكين وفقير".
إنه درس لنا في التواضع. على الرغم من كل عظمته ومواهبه. يقف كمسكين وفقير أمام نفسه، وأمام الله، وأمام الناس. وفي هذه المسكنة يقول لله: "أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطئ".
لا تبطئ.. لا تبطئ لأني في خطر، أوشك على الضياع. حالتي حالة مستعجلة لا تحتمل الإبطاء إطلاقًا، ويلزمها السرعة. فأسرع وأعني.
هناك حالات يضرها الإبطاء، ويكون سببًا في ضياعها. لذلك فسيارات الإسعاف، وسيارات إطفاء الحريق، وسيارات الشرطة التي تطارد القتلة والهاربين من القانون، كلها معفاة من إشارات المرور. فعملها يحمل خطورة معينة، والإبطاء بالنسبة إليها يسبب ضررًا بالغًا.
فكما نطلب من الله ألا يبطئ في إنقاذنا، كذلك نحن لا نبطئ؛ لا نبطئ في كل عمليات الإنقاذ المطلوبة منا، سواء الإنقاذ المادي أو الروحي. ولا نبطئ في حالات من علاج المرضى، قد يؤدي الإبطاء فيها إلى موت المريض أحيانًا، أو إلى ازدياد المرض خطورة بحيث يتعقد ويصعب علاجه.
ولا يجوز أن نبطئ في معونة الفقراء وحل المشكلات الاجتماعية. فلا نضمن تطور الأمر إن أبطأنا. فهناك حالات من العوز، قد تؤدي أحيانًا إلى الانحراف بأنواع شتى، أو قد تؤدي إلى الارتداد. ويأمرنا الكتاب بهذا "لاَ تَمْنَعِ الْخَيْرَ عَنْ أَهْلِهِ، حِينَ يَكُونُ فِي طَاقَةِ يَدِكَ أَنْ تَفْعَلَهُ. لاَ تَقُلْ لِصَاحِبِكَ: "اذْهَبْ وَعُدْ فَأُعْطِيَكَ غَدًا" وَمَوْجُودٌ عِنْدَكَ." (أم3: 27، 28). وهناك حالات في العمل الكرازي أو الرعوي، لا تحتمل الإبطاء. وإلا فإن الأمر يتطور إلى حالة صعبة أو معقدة. إذ قد تتحول المنطقة – بكل من فيها أو بغالبية من فيها – إلى مذهب آخر، أو إلى انحراف فكري أو سلوكي، أو تسيطر عليها طوائف أخرى، وتغرس فيها جذور يصعب اقتلاعها فيما بعد.
وينطبق على هذا الأمر: المناطق البعيدة، والمناطق العشوائية، والمناطق التي يكون عدد المؤمنين فيها قليلًا. بحيث يبتلعهم التيار. وإن ذهبنا إليهم متأخرين، قد لا نجدهم! وكذلك الأشخاص الذين يحاربهم فكر معين، أو الواقعون تحت ضغوط معينة أو تحت إغراءات أصعب من احتمالهم، أو تحت شكوك أقوى من فكرهم ومن معلوماتهم. هؤلاء كل منهم يصرخ "أسرع وأعني" (ولا تبطئ). ليتنا نطبق هذا على واجباتنا، فيما نصلي هذا المزمور.
[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 4 يونيو2001م
الفصل الرابع مَسَاكِنَكَ محبوبة أيها الرب
مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات[1]
[مز 83] (84)
هذا المزمور من مزامير صلاة الساعة السادسة من النهار.
وبعض فقراته تستخدمها الكنيسة في تدشين المذابح الجديدة.
وهو يحوي تأملات عميقة جدًا لداود النبي عن المواضع المقدسة.
وأول ما يخطر على بالنا ونحن نتأمل في هذا المزمور هو:
ما هي مساكن الله المحبوبة؟
مساكن الله المحبوبة عبارة يمكن أن تطلق على السماء التي قيل إنها "كُرْسِيُّ اللهِ" (مت5: 34)، أو أورشليم السمائية التي وُصِفَت بأنها "مَسْكَنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ" (رؤ21: 3). ويمكن أن تكون الكنيسة المقدسة التي قال عنها الله: "بَيْتِي بَيْتَ الصَّلاَةِ يُدْعَى" (إش56: 7) (مت21: 13).
ويمكن أن تطلق هذه العبارة على قلب الإنسان، الذي هو هيكل لله وروح الله يسكن فيه (1كو3: 16). ويمكن أن تطلق على المواضع التي سكنها القديسون، وباركوها بحياتهم وصلواتهم. أو الأماكن التي استشهدوا فيها ورووها بدمائهم.
هذه الأماكن المقدسة تعتبر بركة. يذهب إليها أبناء الله لكي يتباركوا بها، ويلتمسوا شفاعة قديسيها وصلواتهم..
إن الإنسان الروحي يفرح بالمواضع المقدسة التي حلّ فيها الله، والتي عمل فيها إما مباشرة أو عن طريق قديسيه. إن كانت مواضع القديسين لها قدسيتها، فكم بالأولى التي حلّ فيها الله بنفسه، أو التي عمل فيها عجائب!
ولكن ماذا نقصد بعبارة "مساكنك أيها الرب إله القوات"؟
أليس الله في كل مكان؟ في السماء والأرض وما بينهما!
ونقول في المزمور: "لِلرَّبِّ الأَرْضُ وَمِلْؤُهَا الْمَسْكُونَةُ، وَكُلُّ السَّاكِنِينَ فِيهَا" (مز24: 1). لا يوجد مكان خالٍ من الله، حاشًا! إن الله يسكن الكون كله، والكون لا يسعه.
وهكذا صلى سليمان يوم تدشين الهيكل وقال: "لأَنَّهُ هَلْ يَسْكُنُ اللهُ حَقًّا عَلَى الأَرْضِ؟ هُوَذَا السَّمَاوَاتُ وَسَمَاءُ السَّمَاوَاتِ لاَ تَسَعُكَ، فَكَمْ بِالأَقَلِّ هذَا الْبَيْتُ الَّذِي بَنَيْتُ؟!" (1مل 8: 27). فماذا يكون شعورنا، حينما نقول للرب: "مساكنك"؟!
لا شك أننا نقصد الأماكن التي نحرص على قدسيتها، والأماكن التي نمجد الله فيها ونسبحه ونصلي إليه ونرتل.
وأول هذه الأماكن بيوت الله؛ الكنائس
وما قبل الكنائس: مثل خيمة الاجتماع، والهيكل، والمجامع التي يذكر فيها اسم الله، وتقرأ كلماته..
أول مكان سُمِّيَ ببيت الله، هو بيت إيل؛ المكان الذي رأى فيه أبونا يعقوب سلّمًا بين السماء والأرض. والملائكة يصعدون وينزلون عليه. ومن فوق السلّم خاطبه الله ومنحه وعدًا.
فقال يعقوب: "مَا أَرْهَبَ هذَا الْمَكَانَ! مَا هذَا إِلاَّ بَيْتُ اللهِ، وَهذَا بَابُ السَّمَاءِ" (تك28: 17). وأخذ الحجر الذي كان تحت رأسه، وصب عليه زيتًا. دشّنه، ودعاه بيت إيل أي بيت الله. ولأول مرة في الكتاب المقدس نقرأ هذا التعبير (بيت الله).
وأصبحنا نطلق على كل كنيسة (بيت الله) بلون من التخصيص.
على الرغم من وجود الله في كل مكان. ولكنه يوجد في هذا المكان بالذات في جو من التمجيد والعبادة والرهبة، كما قال أبونا يعقوب: " مَا أَرْهَبَ هذَا الْمَكَانَ"!!
ولذلك عندما ظهر الرب لموسى النبي في العليقة المشتعلة بالنار، قال له: "اخْلَعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، لأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ" (خر3: 5).
هذا المكان له رهبته وقدسيته، على الرغم من وجود الله في كل مكان. ونفس الكلام قيل ليشوع بن نون (يش5: 15). وهذا ما نفعله أيضًا حينما ندخل إلى الهيكل في أية كنيسة، نخلع أحذيتنا شعورًا بهيبة المكان وقدسيته..
المكان الثالث من مساكن الله المحبوبة والمهابة، كان خيمة الاجتماع.
وبوجه خاص قدس الأقداس، وتابوت العهد.. وكان حلول الله عليه يظهر كضباب أو سحاب. وما كان أحد يدخل إلى قدس الأقداس سوى رئيس الكهنة مرة كل عام. وما كان أحد من غير الكهنة يجرؤ أن يلمس تابوت العهد، وإلا فإنه يموت..
وظلت أماكن حلول الله رهيبة بالنسبة إلى الناس.
لدرجة أنه حينما سلّم الله الوصايا العشر للناس، لم يستطع الناس أن يحتملوا. وكان الجبل يدخن (خر19: 18) "وَكَانَ الْمَنْظَرُ هكَذَا مُخِيفًا حَتَّى قَالَ مُوسَى أَنَا مُرْتَعِبٌ وَمُرْتَعِدٌ" (عب12: 21). وكان الشعب مرتعدًا وواقفًا من بعيد وقالوا لموسى: "تَكَلَّمْ أَنْتَ مَعَنَا فَنَسْمَعَ. وَلاَ يَتَكَلَّمْ مَعَنَا اللهُ لِئَلاَّ نَمُوتَ" (خر20: 19).
ثم جاء الوقت الذي تحول فيه الخوف إلى حب.
ليس هذا فى العهد الجديد فقط، وإنما هوذا نرى داود – في العهد القديم – يرتل قائلًا: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات. تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب" (مز84: 1-2).
بل يقول أيضًا: "فَرِحْتُ بِالْقَائِلِينَ لِي إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ نَذْهَبُ" (مز121: 1)، ويقول أيضًا: "وَاحِدَةً سَأَلْتُ مِنَ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَمِسُ، أَنْ أَسْكُنَ فِي بَيْتِ الرَّبِّ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِي، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ، وَأَتَفَرَّسَ فِي هَيْكَلِهِ" (مز27: 4).
ويقول أيضًا: "هُوَذَا بَارِكُوا الرَّبَّ يَا جَمِيعَ عَبِيدِ الرَّبِّ، الْوَاقِفِينَ فِي بَيْتِ الرَّبِّ بِاللَّيَالِي. ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ نَحْوَ الْقُدْسِ، وَبَارِكُوا الرَّبَّ" (مز133: 1-2). ويقول للرب أيضًا في المزمور: "طوبى لكل السكان في بيتك. يباركونك إلى الأبد" (مز84: 4). أصبح بيت الرب له لذة في قلوب الناس. وأصبحت مساكنه محبوبة تشتاق إليها النفس. بل إنه يقول: "تَشْتَاقُ بَلْ تَتُوقُ نَفْسِي للدخول إِلَى دِيَارِ الرَّبِّ" (مز84: 2).
وأول مسكن لله نشتاق إليه، هو السماء. السماء هي عرش الله، وهذه الأرض كلها موطئ قدميه (مت5: 34 ،35). هذه السماء كانت محبوبة عند القديسين. وقالوا عنها أيضًا: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات" إله القوات السمائية التي تحيط بعرشك..
القديسون كانوا يحبون السماء، ويفكرون فيها، ويتخذونها موضعًا لتأملاتهم. يتأملون في عرش الله، وفي ملائكته، وفي نور السماء، وفي أورشليم السمائية، وفي ملكوت السموات، وفي كورة الأحياء ومجمع القديسين. وبهذا كله كانت تفرح قلوبهم، وكانت تتطهر وتتقدس أفكارهم. ويقولون للرب عن السماء: "مساكنك محبوبة".
لا شك أن نور السماء أجمل من ظلمة الأرض. وعشرة ملائكة السماء أسمى من سكان الأرض. وكان القديسون يفرحون بالذهاب إلى السماء.
وهكذا قال القديس بولس الرسول: "لِيَ اشْتِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ الْمَسِيحِ، ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًّا" (في1: 23).
وقبله قال سمعان الشيخ: "الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ" (لو2: 29). وعبارة "تطلق" تعني عند هذين القديسين أن وجودهم في الجسد، هو قيد يريدان الانطلاق منه..
كان القديسون يريدون الذهاب بسرعة إلى السماء. ولما تأخر هذا عليهم: بنوا الكنائس على شبه السماء. وجعلوها مملوءة بالأنوار كالسماء.
ولما كانت السماء هي موطن الملائكة، لذلك نقول في التسبحة "السلام لكِ أيتها الكنيسة، بيت الملائكة". وتسمى رعاة الكنائس بلقب ملائكة الكنائس، كما قال الرب في سفر الرؤيا عن ملائكة الكنائس السبع (رؤ1: 20).
السماء طاهرة، وكذلك الكنيسة طاهرة
وكما أن الملائكة في السماء ينفذون مشيئة الله، هكذا الكنيسة تفعل ذلك على الأرض، ويصلي شعبها قائلين للرب: "لتكن مشيئتك كما في السماء، كذلك على الأرض".
ونضع في الكنيسة أيقونة الله جالسًا على عرشه، وأيقونات للملائكة. وننشد له قائلين: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات". يشعر المؤمن وهو داخل إلى الكنيسة، أنه داخل إلى السماء.
في الخارج – قبل أن يدخل – يتخلص من العالميات والماديات، ويدخل إلى الكنيسة روحًا طاهرًا يقول للرب: "بِبَيْتِكَ تَلِيقُ الْقَدَاسَةُ يَا رَبُّ إِلَى طُولِ الأَيَّامِ" (مز93: 5). ولما كانت السماء لا يوجد فيها الأشرار، ولا يدخلها نجس ولا رجس، هكذا كانت الكنيسة الأولى، لا تسمح لأولئك بدخول الكنيسة، بل يقفون في الخارج، إلى أن يدخلوا خورس التائبين، وتظل الكنيسة مجمعًا للقديسين.
ويشعر كل من يدخل الكنيسة، أنه يدخلها لكي يتقدس فيها قلبه وفكره، وينسى العالم ومشغولياته، ويركز فكره في الله، في مكان روحي تليق به الأفكار الروحية.
الكنيسة محبوبة، لأنك تلتقي فيها مع الله. ومحبوبة أيضًا، لأجل عمل روح الله فيها.
ومحبوبة لأجل البركات التي تنالها منها، والسلام الداخلي الذي تحصل عليه، كلما يبارك الأب الكاهن كل الشعب بعبارة "السلام لجميعكم" (إيريني باسي). وإذ بالإنسان داخل الكنيسة ينال بركة ونعمة وسلامًا وغفرانًا لخطاياه.
وأكثر من هذا، يتناول من الأسرار المقدسة، لكي يثبت في الله، ويثبت الله فيه. ويعيش في جو من الألحان المقدسة، ويتخلص من الجو العالمي.
وفي هذه المتعة الروحية ينشد قائلًا: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات".
يقول للرب داخلها: "اسمح يا رب أن أتفرغ لك خلال هذا الوقت الذي أقضيه في الكنيسة.. أنسى كل شيء لكي تصير أنت في فكري كل شيء. وتشبع كل شهوة قلبي المقدسة، حتى أنني أصرخ بكل مشاعري: "تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب".
إنه تعبير عجيب، يصدر في هذا المزمور من داود الملك، الذي كان غنى العالم وبهجته في يديه. ولكنه على الرغم من ذلك، لا يجد شيئًا من متعة العالم يشبع قلبه. إن قلبه لا يشبعه سوى الله وحده.. وهو بهذا الشعور الذي تذوب فيه نفسه للدخول إلى ديار الرب، يغبط خدام الرب المتواجدين في بيته، فيقول للرب:
"طوبى لكل الساكنين في بيتك، يباركونك إلى الأبد".
ونحن نجد أبواب بيت الرب مفتوحة أمامنا في كل وقت. فهل تشتاق وتذوب نفوسنا للدخول إليها، ولو لسجدة وصلاة؟! ما الذي يمنع؟!
هل تستطيع الكنيسة أن تفتح أبوابها باستمرار لكل من يدخل؟ ليس فى موعد الاجتماعات فقط، إنما كل وقت. إن الأب الكاهن حينما يسدل ستر الهيكل، قبل الانصراف من الكنيسة، يقول أثناءها: "يا رب اجعل باب بيعتك مفتوحًا أمامنا في كل زمان، وإلى آخر كل زمان. ولا تغلق باب بيعتك في وجوهنا".
وكنا ونحن شبان منذ حوالي خمسين سنة لنا اجتماعات مستمرة في الكنيسة، كجماعات صغيرة، وكأفراد. وفي كل وقت كان من يدخل إلى الكنيسة، يسمع أصوات الصلاة والتسبيح من بعض زملائه في الخدمة.. نعم، لم تكن الكنيسة تخلو من الصلوات، ولا تقتصر صلواتها على الاجتماعات الرسمية.
وكانت السُرج (القناديل) توقد باستمرار، ويوجد خادم كنسي مسئول عنها يسمى (القندلفت). وهذا النظام لا يزال موجودًا حاليًا في الأديرة. وتظل الأنوار دائمة في الكنيسة، لأن الكنيسة هي نور العالم. هي المنارة – كما سُميت في سفر الرؤيا – يستنير بها الناس. الإنسان في الكنيسة يتقابل مع عمل الروح القدس، ويتقابل مع بركات الكهنوت، ومع أرواح القديسين والملائكة. إن عبارة "مساكنك محبوبة" لا تطلق فقط على الكنائس والأديرة.
بل تطلق أيضًا على قلالي الرهبان وأماكن تواجدهم.
قلاية الراهب تعتبر كنيسة صغيرة، يمكن أن يخلع الزائر حذاءه قبل أن يدخلها، إن أتيح له أن يدخلها. ذلك لأن هذه القلاية هي مكان صلاة ومكان عبادة، ومكان مملوء من المزامير والألحان والتسابيح.
ولهذا نحن نفرح بزيارة القلالي القديمة، التي على مدى مئات السنين كانت تُصلّي فيها صلوات، ربما من عشرات الآباء الذين عاشوا فيها: كل واحد منهم أضاف إليها صلوات ومزامير وتراتيل وألحانًا. وملأها بجهاده ودموعه؛ فأصبحت القلاية مكانًا مقدسًا طُردّت منه الشياطين، وتعبت من الجهاد الروحي الذي فيه.
أما القلاية الجديدة فنباركها بالصلوات قبل أن تُسكن.
ونرفع فيها البخور، ونقرأ كلمة الله، ونرش فيها ماء مُصَلَّى عليه. ونترك الراهب الذي يسكنها لكي يملأها صلاة. كما أن المكان الذي بنيت فيه كان برية مقدسة، تقدست فيه الأرض قبل الأبنية الجديدة التي شُيدت عليه.
عن هذه الأماكن التى انهزمت فيها الشياطين، وطُردت منها، نقول: مساكنك محبوبة يا رب. وماذا أيضًا عن مساكننا الخاصة؟
هناك طقس يُسمّى تبريك المنازل الجديدة.
يأتي إليه الأب الكاهن، ويصلي ويرفع البخور، ويرشها ماء مُصلّى عليه. ولا يسكن فيها ساكنها الجديد إلا بعد هذه الصلاة التي يقول فيها الكاهن أيضًا – من أوشية الاجتماعات – "بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة".
ويتقدس البيت بالصلاة قبل السكنى فيه. وبعد ذلك يكون واجب الساكن أن يملأ البيت ترتيلًا. ويضع فيه صورًا مقدسة، ويلصق آيات من الكتاب بالجدران. ويظهر البيت لكل أحد أنه بيت مقدس، بيت للرب.
يدخله الزائر فيقول: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات". كما يتقدس البيت أيضًا بالحياة الطاهرة التي للذين يعيشون فيه.
ولذلك تجد بيوتًا معينة لها روحانية خاصة، بعكس بيوت أخرى سمحت بالخطية أن يدخلها عدو الخير..!
أتدرج في عبارة "مساكنك محبوبة" إلى القلب الطاهر الذي يسكنه الله. لا ننسى قول الرسول: "أَنَّكُمْ هَيْكَلُ اللهِ" (1كو3: 16&6: 19). لذلك قال: "فَمَجِّدُوا اللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي هِيَ للهِ" (1كو6: 20).
هكذا كانت قلوب القديسين.. وعندما تقول: "تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب"؛ إنما تقصد: أشتاق أن أدخل إلى هذا القلب، وأرى عمل الله فيه.
أرى كيف صيّره روح الله هيكلًا مقدسًا يحل الرب فيه. هذا القلب الذي قال عنه الرب في مزمور آخر: "هذِهِ هِيَ رَاحَتِي إِلَى الأَبَدِ. ههُنَا أَسْكُنُ لأَنِّي اشْتَهَيْتُهَا" (مز132: 14).
إن قال الرب هذا، عليك أن تستجيب وتقول له: "قُمْ يَا رَبُّ إِلَى رَاحَتِكَ، أَنْتَ وَتَابُوتُ موضع قدسك" (مز132: 8). فإن استراح الله في قلبك هذا، وأصبح هيكلًا للروح القدس، حينئذ سوف تنظر الملائكة إلى هذا القلب المقدس، وتقول له: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات".
إن السيد الرب يجول يبحث عن الأماكن التي يستريح فيها روحه القدوس، التي يستريح فيها الرب وهو لا يجد مكانًا يسند فيه رأسه (لو9: 58).
وهو لا يزال واقفًا يقرع على بابك لتفتح له. فإن فتحت له هذا القلب، ودخل فباركك، وطرد منك كل شهوة ردية، وملأ هذا القلب بحبه، وسكن فيه، حينئذ سوف تقول له: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات".
ما أسهل أن نقف أمام أيقونات القديسين الذين جاهدوا وغلبوا، ونقول للرب "مساكنك محبوبة".
تقول هذه العبارة، وأنت أمام أيقونة الأنبا أنطونيوس، أو الأنبا بولا، أو الأنبا بيشوي، أو أمام أيقونة مارجرجس، أو القديس أثناسيوس الرسولي، أو غير هؤلاء من الرعاة، بل ومن التائبين كالقديس أوغسطينوس أو القديس الأنبا موسى الأسود. تنظر إلى كل هؤلاء وتقول: "مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات".
في إحدى المرات سألت نفسي وقلت: ما هي السماء التي يسكنها الله؟ هل هي هذا المكان العالي علينا، الذي نتطلع إليه كلما ننظر إلى فوق؟
أم سماءه هي أرواح الملائكة التي هي أيضًا مساكن محبوبة لله؟ أم أن سماءه هي التي ذُكرت فى هذين البيتين من الشعر:
فـي سماءٍ أنت حـقًا إنمــا كل قلــب عـاش بـالـحب سماك
عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل فلا يحوي سواك
[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 25 يوليو 1975م
الفصل الخامس رَضِيتَ يَا رَبُّ عَن أَرْضِكَ
رضيت يا رب عن أرضك[1]
[مز 84] (85)
إنه أحد مزامير الساعة السادسة. أثناء القداس يصليه الكاهن الخديم. يرمز المزمور إلى عمل الفداء الذي قام به السيد المسيح على الصليب، حيث الرحمة والحق تلاقيا. كما يعّبر المزمور أيضًا عن الحياة الروحية الفردية، وعن حياة الكنيسة.
يبدأ المزمور بقول المصلي:
رضيت يا رب عن أرضك
أول شيء يحاول المصلي أن يتأكد منه هو رضى الله، لأن الخطية الأولى سببت غضب الله على الإنسان وعلى الأرض، عندما خلق الله الأرض وخلق الإنسان، "وَرَأَى اللهُ كُلَّ مَا عَمِلَهُ فَإِذَا هُو حَسَنٌ جِدًّا" (تك1: 31).
ثم عندما أخطأ الإنسان، قال الله له: "مَلْعُونَةٌ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ. وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ" (تك3: 17-18). فالأرض الحسنة الجميلة لُعِنَت بسبب خطية الإنسان. وفي خطية قايين عاد الرب إلى ذكر اللعنة. فقال لهذا القاتل: "مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الأَرْضِ الَّتِي فَتَحَتْ فَاهَا لِتَقْبَلَ دَمَ أَخِيكَ مِنْ يَدِكَ. مَتَى عَمِلْتَ الأَرْضَ لاَ تَعُودُ تُعْطِيكَ قُوَّتَهَا" (تك4: 11، 12). وهكذا تمردت الأرض على الإنسان بسبب الخطية. فأصبحت لا تعطيه قوتها، وأصبحت أيضًا تنبت له الشوك والحسك. كما تمردت عليه أيضًا وحوش الأرض. ولا يجد المصلي أمامه إلا أن يقول: رضيت يا رب عن أرضك؟
هل رضيت يا رب عن الأرض، ورفعت عنها اللعنة القديمة؟
الأرض التي سبق فأغرقتها بالطوفان في أيام نوح. الأرض التي أحرقت بعض مدنها بالنار في أيام لوط (تك19). الأرض التي سمحت أن تفتح فاها، وتبتلع قورح وداثان وأبيرام (عد16: 32). الأرض التي تدنست وتنجست بخطايا الناس. هل رضيت يا رب عنها؟
كلمة (أرض) تعني أيضًا الإنسان ذاته
فهي تعني الأرض والساكنين فيها. فحينما نقول في المزمور: "رَنِّمِي لِلرَّبِّ يَا كُلَّ الأَرْضِ" (مز96: 1) لا نعني التراب والجبال والأنهار، إنما نعني سبحي الرب يا كل المسكونة، أو سبحوا الرب يا ساكني الأرض.
نعم يا رب.
هذه الأرض إن أنتجت ثلاثين وستين ومائة، فهي أرضك. وإن أخرجت شوكًا وحسكًا، هي أيضًا أرضك. هي خليقتك وصنعة يديك "لِلرَّبِّ الأَرْضُ وَمِلْؤُهَا. الْمَسْكُونَةُ، وَكُلُّ السَّاكِنِينَ فِيهَا" (مز24: 1).
فارضَ يا رب عن أرضك
نحن يا رب – مهما أخطأنا إليك – فلا نزال أولادك، شعبك وغنم رعيتك، حتى إن ضللنا، فنحن أمامك أبناء. فهل رضيت يا رب عن أرضك؟ مهما غضبت عليها فهي أرضك. ومهما أخطأت إليك، فهي أرضك..
فلذلك، الابن الضال: عندما ترك بيت أبيه، وذهب إلى كورة بعيدة، وأنفق مال أبيه في عيش مسرف، وعاد أخيرًا، قال عنه الأب: "ابْنِي هذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالًا فَوُجِدَ" (لو15: 24).
إنه ابني حتى لو كان ضالًا وميتًا، حتى إن كان فتيلة مدخنة أو قصبة مرضوضة (إش42: 3) (مت12: 20).. فلا تتخلّ يا رب عن أبوتك لهذه الأرض، مهما أخطأت إليك. ليتك تعود إلى محبتك الأولى لها.
وتقول لها عبارتك المعزية: "لُحَيْظَةً تَرَكْتُكِ، وَبِمَرَاحِمَ عَظِيمَةٍ سَأَجْمَعُكِ. بِفَيَضَانِ الْغَضَبِ حَجَبْتُ وَجْهِي عَنْكِ لَحْظَةً، وَبِإِحْسَانٍ أَبَدِيٍّ أَرْحَمُكِ" (إش54: 7، 8). حينئذ تجيبك أرضك بمزمور عبدك داود "أُعَظِّمُكَ يَا رَبُّ لأَنَّكَ نَشَلْتَنِي وَلَمْ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي" (مز30: 1).
نحن نعلم كم تمردت عليك هذه الأرض.
هذه التي امتلأت خطية وفسدت قدامك. نعلم أن صراخها قد صعد إليك ونزلت لترى كم فعلت (تك18: 20-21). نعلم أن كل شر مكشوف أمامك.
أرضـــك الفــضلى التي ازدادت على الأفلاك حســـنًا
استُذلت واستُبيحت لــــم تــعــد أهـــــلًا لــســكنى
تدنست، وأحبت الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالها كانت شريرة (يو3: 19). العالم بك كُوّن، والعالم لم يعرفك. إلى خاصتك أتيت، وخاصتك لم تقبلك (يو1: 10-11). رفضوك أيها الحبيب مثل الميت المرذول. وجُرحت في بيت أحبائك (زك13: 6). حتى قلت على فم المرنم: "أَكْثَرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِي الَّذِينَ يُبْغِضُونَنِي بِلاَ سَبَبٍ" (مز69: 4).
كم مرة تكبرت هذه الأرض وتجبرت، وأغلقت أبوابها في وجهك، ورفضت قبولك؟!
حتى قال تلميذاك: "أَتُرِيدُ أَنْ نَقُولَ أَنْ تَنْزِلَ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُفْنِيَهُمْ، كَمَا فَعَلَ إِيلِيَّا أَيْضًا" (لو9: 54).
ولكنك أنت يا رب كما أنت، الإله الحنون الطيب "رَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ، طَوِيلُ الرُّوحِ وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ" (مز103: 8)، أجبت هذين التلميذين موبخًا بقولك: "لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ أَنْتُمَا! لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُهْلِكَ أَنْفُسَ النَّاسِ، بَلْ لِيُخَلِّصَ" (لو9: 55-56).
بل قلت في مناسبة أخرى: "لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ" (لو19: 10).
عجيب قولك هذا يا رب! لم تقل "يطلب ما قد سقط"، وإنما قلت "يطلب ويخلص ما قد هلك"، فهل رضيت يا رب عن أرضك؟ وهل حان زمن افتقادك لها؟ (لو19: 44).
حدث ذلك حينما تجسدت وأتيت إلى العالم. كان ذلك في ملء الزمان، الزمان الذي حنّت فيه أحشاؤك، وقلت رحمة أرحمه (إر31: 20).
فأتيت إلى العالم لتخلصه. أتيت إليه في إخلاء ذات (في2: 7). وولدت في مذود بقر، ولكن جمهورًا من الجند السماوي غنّى قائلًا: "الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ" (لو2: 13، 14). حينئذ أحسسنا جميعًا أنك قد رضيت يا رب عن أرضك. قبل ذلك مرّت فترة طويلة من الخصومة.
لم يأتِ فيها إلى الأرض أنبياء، ولا مرسلون من عند الله. ولم تكن هناك رؤى من الله ولا أحلام ولا ملائكة. انقطع هذا كله عن الأرض. وكان عصرًا طويلًا ومريرًا من التخلي. ثم رضيت يا رب عن أرضك.
وبدأت تباشير الصلح تظهر..
ملاك ظهر لزكريا يبشره بميلاد المعمدان (لو1: 11). وملاك ظهر للسيدة العذراء يبشرها بميلاد المسيح (لو1: 26، 27). وملاك ظهر في حلم ليوسف النجار يقول إن الذي حبلت به مريم هو من الروح القدس (مت1: 20). وملاك بشر الرعاة بميلاد مخلص هو المسيح الرب (لو2: 10،11).
وقرأنا أيضًا أن الله قد أوحى إلى المجوس في حلم بأن لا يرجعوا إلى هيرودس (مت2: 12). وأن ملاكًا ظهر ليوسف في حلم يقول له: "قُمْ وَخُذِ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ" (مت2: 13). ثم ملاكًا آخر ظهر له في حلم يقول له أن يرجع إلى أرضه (مت2: 19، 20). ثم أوحي إليه في حلم أن ينصرف إلى نواحي الجليل (مت2: 22). إذًا إن مرت عليك فترة من التخلي، لا تيأس.
إن مرّ عليك وقت شعرت فيه أن الله قد تركك. لم يعد يتكلم في قلبك، ولا يعزيك. ولم تعد تشعر بصلة بينك وبينه، ولا بوجوده في حياتك، لا حرارة في الصلاة، ولا دموع، وربما لا رغبة في الصلاة ولا اشتياق. ولا حماس للتناول ولا للاعتراف.. وكأنك في سبي من الخطية أو من الفتور، حينئذ تصرخ إلى الرب، لكي يرضى عن أرضه، ويرد سبي يعقوب. قل له: متى يا رب نصطلح، ونرجع سويًا إلى الحب القديم؟
فرّح وجه الأرض، ليرو حرثها، ولتكثر ثمارها!
أعدّها للزرع والحصاد، ودبّر حياتنا كما يليق.. متى ترضى يا رب عن هذا القلب، وتسكنه كما كان، هيكلًا لروحك القدوس؟ متى تعود لتملأه بالتأملات الصالحة، كما كان منذ زمان؟ أعنّي يا رب على خلاص نفسي، ولا تسمح للشيطان أن يسبي فكري وشعوري.
غضب الرب مرة على الأرض، ثم عاد وصالحها، من أجل إنسان واحد بار.
كان ذلك في أيام أبينا نوح، غضب الله على الأرض، فأغرقها بالطوفان وأمات كل حي، ولما رسى الفلك، بنى نوح مذبحًا، وقدّم عليه محرقات للرب، من كل البهائم الطاهرة "فَتَنَسَّمَ الرَّبُّ رَائِحَةَ الرِّضَا. وَقَالَ الرَّبُّ فِي قَلْبِهِ: "لاَ أَعُودُ أَلْعَنُ الأَرْضَ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الإِنْسَانِ، وَلاَ أَعُودُ أَيْضًا أُمِيتُ كُلَّ حَيٍّ كَمَا فَعَلْتُ" (تك8: 20 ،21). وأقام الله ميثاقًا مع أبينا نوح، قوس قزح في السحاب، حتى لا يعود يهلك كل ذي جسد، ولا يكون طوفان فيما بعد (تك9: 11-13).
وهكذا رضي الله على الأرض كلها، من أجل محُرقات أبينا نوح البار.
من أجل إنسان واحد بار، منع الله ضربة الفناء عن الأرض، وقال لا أعود ألعن الأرض. بهذا نعرف مقدار وجود القديسين وبركتهم للأرض، إذ يمنعون غضب الله عنها، ويعيدون إليها رضى الله عليها، من أجل أن الله فرح بحياتهم التي يتنسم منها رائحة الرضا.
إنهم قديسون كلما يراهم الله يرضى، ويرفع غضبه عن الأرض..
مثال ذلك داود النبي بالنسبة إلى شاول الملك.. كان الرب قد غضب على شاول، ففارقه روح الرب، وبغته روح رديء من قِبل الرب (1صم16: 14). وكان هذا الروح يصرعه ويتعبه. فيقف داود بينهما "فيَرْتَاحُ شَاوُلُ وَيَذْهَبُ عَنْهُ الرُّوحُ الرَّدِيءُ" (1صم16: 23). داود يقف وسيطًا، وفيه روح الله (1صم16: 13). يراه الرب فيرضى، ويسمع الروح الرديء مزاميره فيخاف ويترك شاول. أحيانًا يرضى الله عن أرضه، عندما يزول سبب غضبه عليها.
كان غضب الله على الأرض، بسبب وجود أنبياء البعل وأنبياء السواري، الذين كانوا يأكلون على مائدة الملكة إيزابل (1مل18: 19). فمنع الله المطر عن الأرض على لسان إيليا النبي، وسادت المجاعة، فلما قدم إيليا محرقة قبلها الله، وخلّص إيليا الأرض من كل هؤلاء الأنبياء الكذبة.
وكأنه قال للرب: "رضيت يا رب عن أرضك"، فأرسل الله المطر على الأرض، وانتهت المجاعة. إن كنا نسأل الله قائلين: "رضيت يا رب عن أرضك"، لا شك أنه يجيب: وهل أزلتم سبب غضبي عليها، ويقول: "فِي وَسَطِكَ حَرَامٌ يَا إِسْرَائِيلُ" (يش7: 13). هكذا قال الرب ليشوع، حينما انهزم الجيش أمام بلدة صغيرة اسمها عاي، بينما كان قد انتصر من قبل على مدينة عظيمة هي أريحا. ذلك لأنه حدثت خيانة، إذ أن عخان بن كرمي أخذ من الحرام، فغضب الرب على الشعب. فلما مزق يشوع ثيابه، وتذلل أمام الله وسأل عن السبب، أجابه: "قَدْ أَخْطَأَ إِسْرَائِيلُ، بَلْ تَعَدَّوْا عَهْدِي الَّذِي أَمَرْتُهُمْ بِهِ" (يش7: 11). فلما تم رجم عخان بن كرمي عقوبة له على خيانته "رَجَعَ الرَّبُّ عَنْ حُمُو غَضَبِهِ" (يش7: 26).
حدث نفس الوضع للسفينة بسبب يونان. خالف يونان أمر الرب، فلم يذهب إلى نينوى. فركب سفينة ذاهبة إلى ترشيش، "فَأَرْسَلَ الرَّبُّ رِيحًا شَدِيدَةً إِلَى الْبَحْرِ، فَحَدَثَ نَوْءٌ عَظِيمٌ فِي الْبَحْرِ حَتَّى كَادَتِ السَّفِينَةُ تَنْكَسِرُ" (يون1: 4)؛ فبذل البحارة كل جهدهم لإنقاذ السفينة فلم يستطيعوا. وأخيرًا قال لهم يونان: "خُذُونِي وَاطْرَحُونِي فِي الْبَحْرِ فَيَسْكُنَ الْبَحْرُ عَنْكُمْ، لأَنَّنِي عَالِمٌ أَنَّهُ بِسَبَبِي هذَا النَّوْءُ الْعَظِيمُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَخَذُوا يُونَانَ وَطَرَحُوهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَقَفَ الْبَحْرُ عَنْ هَيَجَانِهِ" (يون1: 12-15). هنا ونقول عن السفينة وأهلها: "رضيت يا رب عن أرضك".
انزع يا أخي الشر من حياتك، فيرضى الرب عنك.
تخلص من المخالفة التي كانت ليونان، ومن الحرام الذي أخذه عخان، وتخلص من أصنامك التي مثل أصنام أنبياء البعل وأنبياء السواري، حينئذ يرضى الرب عن أرضك، ويرد سبي يعقوب..
وابحث عن إرضاء الله قبل كل شيء.
قل له: لست أريد يا رب شيئًا سوى إرضائك. فإن رضيت ستحقق لي كل ما أحتاجه حتى دون أن أطلب. عندما شرح موسى أنواع الذبائح في سفر اللاويين، ذكر أولًا المُحرَقة التي من أجل إرضاء الله "كرائحة سرور للرب" (لا1: 9-13-17)، قبل باقي الذبائح التي من أجل غفران الخطايا، كذبيحة الخطية وذبيحة الإثم (لا4، 5).
وفي لوحي الشريعة، نجد أن اللوح الأول يشمل الأربع وصايا الأولى، الخاصة بواجباتنا حيال الله. أما اللوح الثاني فيشمل الوصايا الباقية الخاصة بمعاملاتنا مع الناس (خر20، تث 5).
ولما سئل السيد المسيح عن الوصية العظمى في الناموس. قال: "تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَالثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ" (مت22: 36-39). إذًا باستمرار الله هو الأول. وبنفس الوضع في الصلاة الربانية: الطلبات الثلاث الأولى خاصة بالله، وباقي الطلبات خاصة بنا نحن. لذلك اطلب رضى الله أولًا، حتى قبل أن تطلب غفران خطاياك. وإذا رضي الله عن أرضك سيمنحك غفران الخطايا. وهنا نسأل: ماذا تعمل الأرض لكي يرضى الله عنها؟
أولًا يرضى الله عنها بالتوبة وانسحاق النفس، والوصول إلى التراب والرماد. تصرخ كما قال داود النبي في توبته: " تَعِبْتُ فِي تَنَهُّدِي. أُعَوِّمُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سَرِيرِي وَبِدُمُوعِي أبل فِرَاشِي" (مز6:6). ثم بعد ذلك تسلك في وسائط النعمة، وفي ناموس الرب تلهج نهارًا وليلًا، وتملأ القلب من محبة الله.
وقد يرضى الرب عن أرضك بعد عقوبة تتلقاها.
حدث ذلك بالنسبة إلى شمشون الجبار. لقد عاد الرب ورضي عن شمشون بعد كسر نذره لما سئم من إلحاح دليلة عليه، ولكن متى رضي الرب عليه، وكيف؟ ذلك بعد أن قاسى شمشون ألوانًا من الذل، وفُقئت عيناه، واستهزأ به الأطفال، وصار يجرّ الطاحون كالحيوانات (قض16: 21). وضاعت هيبته وضاع وقاره. وقضى في هذا الذل زمنًا، قبل أن يصرخ قائلًا: "رضيت يا رب عن أرضك"؟! ورضي الرب أخيرًا عليه واستجاب له..
وحدث ذلك أيضًا مع القديس يعقوب المجاهد. كان قد أخطأ، وشعر بتخلي النعمة عنه. فترك مكانه، وسكن في القبور. وقضى سنوات طويلة في ذل أمام الله، بتوبة صادقة، واختفاء عن الناس، واحتقار لذاته، وبعده عن مجده الأول. وأخيرًا عاد الرب ورضي عن أرضه، وقبل توبة يعقوب. وأعاد إليه نعمته. أشرق على قلبه مرة أخرى.
إن للخطية نتائج مُرّة ينبغي أن نتحملها في انسحاق قلب، قبل أن نسأل الرب قائلين: رضيت يا رب عن أرضك؟ وقبل أن نقول له أيضًا:
رددت سبي يعقوب؟
كثيرًا ما نخطئ، ولا نريد أن نذوق ثمار الخطية المُرّة.
داود النبي أخطأ. وفي بادئ الأمر ما كان يحسّ نتائج ما اقترفه، ولا بشاعته! إلى أن أيقظه ناثان النبي من غفلته (2صم12). وبدأ داود يبكي على خطيته حتى بلل فراشه بدموعه، قبل أن يقول: "رضيت يا رب عن أرضك".
وهكذا فعل القديس يعقوب المجاهد، والقديس تيموثاوس، بعد أن شعر كل منهما بخطيئته، وبالنتائج المُرّة للخطية. يكفي أنها مرحلة من السبي، سُبِيَ فيها القلب والفكر، وجعلا الجسد أيضًا يخطئ ويُسبَى. هنا يعترف الخاطئ أنه في سبي، ويطلب من الرب أن يرد سبيه. يقول في انسحاق: "أنت يا رب الذي ترد سبينا. ترده بعمل نعمتك فيَّ. أنت يا رب تعرف ضعف طبيعتي ويقظة أعدائي وقوّتهم".
أنت الذي فتحت أبواب الجحيم، وأخرجت المسبيين من الشيطان هناك (أف 4: 8). ورددت سبي يعقوب من الجحيم، ونقلت هذا السبي إلى الفردوس. وفتحت الطريق إلى شجرة الحياة. وقلت لملاك الكاروبيم الذي كان يحرس شجرة الحياة بسيف من نار (تك24:3) "الآن رُد سيفك إلى غمده، وافتح الطريق ليدخل الذين كانوا في سبي".
أنت يا رب الذي تكلمت فى قلب كورش ملك فارس (عز1:1). لكي يرد السبي إلى أورشليم، وحوّلت القلب الصخري إلى قلب لحم (حز36: 26). فهل رضيت الآن يا رب عن أرضك؟ وهل رددت سبي يعقوب؟ هل رددت سبي هذا القلب الذي تملكته الخطية، وسَبَت جميع مشاعره؟ وهل رددت سبي هذا العقل الذي سبَت الخطية كل أفكاره؟ وهل رددت سبي هذا اللسان الذي يتكلم بما لا يليق؟
هل رددت سبينا يا رب، وأعدتنا إلى رتبتنا الأولى؟
ما أجمل قولك لتلميذي يوحنا المعمدان: "اَلْعُمْيُ يُبْصِرُونَ، وَالْعُرْجُ يَمْشُونَ، وَالْبُرْصُ يُطَهَّرُونَ، وَالصُّمُّ يَسْمَعُونَ، وَالْمَوْتَى يَقُومُونَ، وَالْمَسَاكِينُ يُبَشَّرُونَ. وَطُوبَى لِمَنْ لاَ يَعْثُرُ فِيَّ" (مت11: 5، 6).
لقد رددت يا رب سبي كل هؤلاء. ونحن نؤمن أنك قادر أن تفعل ذلك معنا. ولسنا نعثر فيك. السبي هو بسبب الخطية..
فإن سألنا الرب أن يرد سبي يعقوب، يقول لنا: "اتركوا الخطية فينتهي سبيكم". ولكننا نرد ونقول: وكيف نتركها بدون معونتك؟! ألست أنت القائل: "بِدُونِي لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا" (يو15: 5).
إذًا قم أيها الرب الإله، وليتبدد جميع أعدائك القائمين علينا وليقل لك كل منا "توبني فأتوب" (إر31: 18). أولادك يا رب المسبيون في بابل، لم يستطيعوا أن يصلّوا. قالوا: "عَلَى أَنْهَارِ بَابِلَ هُنَاكَ جَلَسْنَا، بَكَيْنَا أَيْضًا عِنْدَمَا تَذَكَّرْنَا صِهْيَوْنَ" (مز137: 1).
في أرض السبي التي سبانا إليها الشيطان، التي سُمّيت بابل، هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا الأيام الحلوة التي قضيناها معك، حول المذبح والذبيحة، وفي الصلوات والتسبيح، هناك في مدينة الله المقدسة، وعلى جبله الدسم، نتمتع ببركاته الروحية. أما في أرض السبي. فعلى الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا. لأن هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، فقلنا: كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟! كيف نغني أغنية للرب، ونحن متغربون عنه، في أرض الخطية؟! لذلك ارددنا يا رب فنخلص. "حِينَئِذٍ امْتَلأَتْ أَفْوَاهُنَا ضِحْكًا، وَأَلْسِنَتُنَا تَرَنُّمًا. حِينَئِذٍ قَالُوا بَيْنَ الأُمَمِ: إِنَّ الرَّبَّ قَدْ عَظَّمَ الْعَمَلَ مَعَ هؤُلاَءِ. عَظَّمَ الرَّبُّ الْعَمَلَ مَعَنَا، وَصِرْنَا فَرِحِينَ" (مز126). لنسأل: كيف وصلنا إلى هذا، ونتحاشى الأسباب حتى لا يتكرر.
أسوأ خطيئة يقع فيها الإنسان، حينما يكون مسبيًا في الخطية، ويحب السبي ويفرح به.
وكلما ينجيه الرب من السبي، يعود فيشتهيه!! مثل الذين أخرجهم من نير عبودية فرعون، وعادوا يقولون: "لَيْتَنَا مُتْنَا بِيَدِ الرَّبِّ فِي أَرْضِ مِصْرَ، إِذْ كُنَّا جَالِسِينَ عِنْدَ قُدُورِ اللَّحْمِ نَأْكُلُ خُبْزًا لِلشَّبَعِ" (خر16: 3). هذه حالة الإنسان الضائع، الذي حتى لو تركته الخطية يشتاق إليها، ويود لو يقع في سبيها مرة أخرى.
أما الذي يشعر بسبيه، ويطلب من الرب أن يرد سبيه، فهذا قريب من الخلاص. إنه يطلب من الرب أن تنتهي فترة التخلي، وأن يرسل إليه نحميا أو عزرا أو زربابل.
لا بد أن تنكسر النفس أمام الله، لكي يرد سبيها. تقول له: "أنظر إلى ذلي ومسكنتي ونجني" (مز119). وحينئذ "من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم – يقول الرب – أصنع الخلاص علانية" (مز12: 5).
إذًا قم أيها الرب، وليتبدد جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف، وربوات ربوات يصنعون مشيئتك.
قبل أن يولد يعقوب، قال الرب إنه أحب يعقوب (رو9: 13). وها قد سُبيَ يعقوب! فالآن يا رب "هوذا الذي تحبه مريض" كما قيل عن لعازر (يو11: 3). فلا تبطئ يا رب أيامًا حتى يموت وينتن. "اللهم التفت إلى معونتي. يا رب أسرع وأعني" (مز70: 1). ما أجمل ما قيل عن سبي سدوم: "فَلَمَّا سَمِعَ أَبْرَامُ، أَنَّ أَخَاهُ سُبِيَ جَرَّ غِلْمَانَهُ الْمُتَمَرِّنِينَ" (تك 14:14) "وَاسْتَرْجَعَ لُوطًا أَخَاهُ أَيْضًا وَأَمْلاَكَهُ".
فاسترجعني يا رب إليك، حتى لو كان ذلك بسبب اختياري لسدوم.
عندما تقول: "رضيت يا رب عن أرضك، رددت سبي يعقوب"، ربما كلمة "أرضك" تشمل معانٍ كثيرة..
إما أن هذه الأرض تعني العالم كله. أو قد تقصد رضيت يا رب عن كنيستك وشعبك أو رضيت يا رب عن هذه النفس التي تتحدث إليك، وعن هذا القلب الذي تسكنه، وهذه الروح التي أعددتها لتكون هيكلًا لروحك القدوس (1كو3: 16).
هنا يقول المصلي: رضيت يا رب عن أرضك، ولم يقل رضيت يا رب عن أرضي؛ ذلك لأن أرضي هي أرضك، وأنا ملكك وصنعة يديك، وأنت تملكني فقلبي هو أرضك، تزرع فيها الفضائل، فينمو فيها الحب، حبك. وعندما يقول المصلي رضيت يا رب عن أرضك، إنما يتكلم بدالة مع الله، شاعرًا بصلته معه.
ومن الجائز أنه يقصد بكلمة أرضك: كنيستك وشعبك.
لسنا في كل مرة نصلي من أجل نفوسنا. إنما قد نصلي من أجل الآخرين: من أجل أخوتنا وأقربائنا ومعارفنا، ومن أجل الشعب كله. ونطلب رضى الله على الشعب، وكلما نجد إنسانًا حزينًا أو مجربًا، أو في ضيقة، نصلي إلى الله من أجله، ونطلب أن يرضى الله عن هذه الأرض.
إنها صلاة لأجل الشعب، مثل صلاة نحميا. كان نحميا يعمل في بلاط الملك أرتحشستا في بلاد الفرس. وكان مستريحًا، وله مكانة عند الملك. ومع ذلك لما سمع أن شعبه في ضيقة، وأن أسوار أورشليم مهدّمة، وأبوابها محروقة بالنار. يقول: "فَلَمَّا سَمِعْتُ هذَا الْكَلاَمَ جَلَسْتُ وَبَكَيْتُ وَنُحْتُ أَيَّامًا، وَصُمْتُ وَصَلَّيْت أَمَامَ إِلهِ السَّمَاءِ.. الإِلهُ الْعَظِيمُ الْمَخُوفُ، أَنَا وَبَيْتُ أَبِي قَدْ أَخْطَأْنَا، لَقَدْ أَفْسَدْنَا أَمَامَكَ.. فَهُمْ عَبِيدُكَ وَشَعْبُكَ الَّذِي افْتَدَيْتَ بِقُوَّتِكَ الْعَظِيمَةِ.. يَا سَيِّدُ، لِتَكُنْ أُذْنُكَ مُصْغِيَةً إِلَى صَلاَةِ عَبْدِكَ" (نح1: 4-11).
من المفروض أن نصلي لأجل الآخرين، ولأجل الكنيسة.
هناك أوشية في القداس تسمى (أوشية السلامة) يصلي فيها الكاهن من أجل الكنيسة. ويقول: "اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية"، والشماس يصرخ ويقول: "صلوا من أجل سلامة الكنيسة.." ويرد الشعب قائلين "يا رب ارحم".
وهناك أوشية تسمى (أوشية الآباء) يصلي فيها الكاهن من أجل البابا البطريرك، ومن أجل الآباء الأساقفة والقمامصة والقسوس، ومن أجل كل طغمات الإكليروس، وبنفس الوضع ينبه الشماس الشعب للصلاة فيردون قائلين: "يا رب ارحم".
إن صلوات القداس الإلهي تنبهنا إلى واجباتنا في صلواتنا الخاصة؛ حيث نصلي في مخادعنا من أجل الكنيسة. فلا نقف منها موقف المتفرج، ولا موقف الناقد، ولا موقف المتذمر أو المحارب، ولكن باستمرار نصلي من أجل الكنيسة وسلامها، ونقول للرب عنها: "رضيت يا رب عن أرضك، رددت سبي يعقوب".
إن وجدنا ما يتعبها من الداخل أو الخارج، نجعله موضع صلواتنا. فالكنيسة هي أمنا جميعًا، وهي جسد المسيح. يقول عنها الكاهن في صلواته إلى الرب: "هذه التي اقتنيتها بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام".
ويصلي من أجل قادتها ومن أجل كل الشعب، كما يصلي في مواضع أخرى من أجل المرضى ومن أجل المنتقلين.
ولما نقول: "رددت سبي يعقوب"، نقصد سبي أحبائك.
لأنك "أحببت يعقوب". وكأننا نقول له: هذه الأرض أرضك، وهذا الشعب شعبك. وكلهم أولادك وأحباؤك. ولسنا نصلي من أجل أحد غريب عليك، فكلهم يا رب صنعة يديك. وعلى الرغم من أن يعقوب هو حبيبك، إلا أنه قد سبي، ونطلب لأجله.
ونحن - على الرغم أننا أبناؤك - إلا أننا قد نخطئ إليك: "إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُّ أَنْفُسَنَا وَلَيْسَ الْحَقُّ فِينَا" (1يو1: 8).
حقًا إن المعمودية قد طهرتنا وأعطتنا طبيعة جديدة. ولكننا لسنا معصومين. ولا تزال لنا حرية الإرادة التي قد تميل إلى الخطية، فنسقط. والكتاب يقول: "الصِّدِّيقَ يَسْقُطُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيَقُومُ" (أم24: 16). مع إنه صدِّيق. لهذا نصلي ونقول: "رضيت يا رب عن أرضك، رددت سبي يعقوب".
وقد يجيب الرب ويقول: كم مرة رددته من سبيه، ثم يعود هو إليه!!
المشكلة أنه مريض يحب المرض. لذلك فإن مريض بيت حسدا، الذي استمر في مرضه 38 سنة، حسنًا قال له الرب: "أتريد أن تبرأ؟" (يو5: 6). قد يحب الإنسان الأشياء التي تؤدي إلى مرضه.
مثل مريض السكر! كذلك مدمن التدخين، يعرف تمامًا كم أضرّ به التدخين، ومع ذلك فهو لا ينقطع عنه، ويجد لذته في أن يدخن! وهكذا أنت تقول للرب: "رددت سبي يعقوب". فيقول لك: "مرارًا كثيرة رددته من سبيه، وهو يعود إليه بقدميه".
حقًا ما أكثر ما نعاتب الله على أمور، ونحن السبب فيها!
نعاتبه كما لو كان الله لا يريد أن يرضى عن أرضنا، أو هو راض بسبينا!! بينما الله "يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يَخْلُصُونَ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ يُقْبِلُونَ" (1تي2: 4).
إننا نحن الذين نحب الخطية والسبي، ونحب الأسباب التي تؤدي إلى هلاكنا وضياعنا.. إننا كالتلميذ الذي يهمل دروسه، وينشغل عنها باللهو وبالأصدقاء، ثم يرسب في الامتحان. فإن قلت له: هل أنت تحب أن ترسب؟ يقول: كلا، أنا لا أحب الرسوب. ولكنه يحب الأشياء التي تؤدي إلى الرسوب. وهكذا نحن.
وفي كل ذلك، نحن نشكر الله الذي يرضى عن أرضه، ويرد سبي يعقوب.. لقد تغرب يعقوب عن أرضه، وذهب عند خاله في فدّان آرام. وكان الرب قد وعده قائلًا: "وَهَا أَنَا مَعَكَ، وَأَحْفَظُكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ، وَأَرُدُّكَ إِلَى هذِهِ الأَرْضِ" (تك 28: 15). ونفّذ الله وعده، وردّه إلى بيت أبيه.
والله أيضًا ردّ بطرس إلى رتبته الرسولية، بعد أن أخطأ وأنكر. وقال له الرب حين ردّه: "ارْعَ خِرَافِي. ارْعَ غَنَمِي" (يو21: 15-17).
ومريم المجدلية، بعد أن كان عليها سبعة شياطين (لو8: 2)، عاد الرب فردّها إليه وجعلها قديسة عظيمة.. ونحن أيضًا نصلي من أجل المقيدين، والمربوطين برباطات الشياطين والسلاطين.
ونقول عنهم: "رضيت يا رب عن أرضك، رددت سبي يعقوب". نصلي من أجل العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم أحد يذكرهم، متذكرين قول الرسول "بُكَاءً مَعَ الْبَاكِينَ" (رو15:12).
ما أنبل الإنسان الذي يشترك في مشاعر الآخرين. وما أعمق قلب الذي لا يدين الخاطىء، إنما يطلب له المغفرة. ويقول مع المرتل في هذا المزمور: "غفرت آثام شعبك، سترت جميع خطاياهم".
علينا باستمرار أن نطلب من الله مغفرة الخطايا، سواء لنا أو لغيرنا، أو خطايا الشعب كله، كما فعل نحميا وعزرا. وكما فعل موسى النبي أيضًا (خر32).
وكما نقول باستمرار في الصلاة الربية "اغفر لنا خطايانا". قل له في صلاتك: اغفر يا رب لشعبك الذين دعيَ عليهم اسمك وانتسبوا إليك. استر جميع خطاياهم، لأنك تحبهم. والمحبة تستر كثرة من الخطايا. استرها بمحبتك أو برحمتك.
وكما نطلب من الله أن يغفر خطايا شعبه، علينا نحن أيضًا أن نغفر لمن أساء إلينا. فالرب قد قال: "اغفروا يغفر لكم" (لو6: 37).
على أن كثيرين يظنون أنهم قد غفروا، بينما الضيق لا يزال مترسبًا في قلوبهم. المغفرة الحقيقية هي أن تنسى الإساءة ولا تعود تذكرها.. وهذه هي المغفرة التي وعد بها الرب لشعبه فقال:
"لأَنِّي أَصْفَحُ عَنْ إِثْمِهِمْ، وَلاَ أَذْكُرُ خَطِيَّتَهُمْ بَعْدُ" (إر31: 34). والخاطئ الذي يغفر له الرب، قال عنه: "كُلُّ خَطِيَّتِهِ الَّتِي أَخْطَأَ بِهَا لاَ تُذْكَرُ عَلَيْهِ" (حز 33: 16). وقيل في المزمور: "طُوبَى لِلَّذِي غُفِرَ إِثْمُهُ وَسُتِرَتْ خَطِيَّتُهُ. طُوبَى لِرَجُل لاَ يَحْسِبُ لَهُ الرَّبُّ خَطِيَّةً" (مز32: 1-2). وهذه العبارة بالذات رددها القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومية (رو4: 7، 8).
وهذا ما طلبه داود النبي من الرب، فقال: "اذْكُرْ مَرَاحِمَكَ يَا رَبُّ وَإِحْسَانَاتِكَ، لأَنَّهَا مُنْذُ الأَزَلِ هِيَ. لاَ تَذْكُرْ خَطَايَا صِبَايَ وَلاَ مَعَاصِيَّ" (مز25: 6-7).
والقديس بولس الرسول يقول عن المصالحة التي تمت على الصليب: "إِنَّ اللهَ كَانَ فِي الْمَسِيحِ مُصَالِحًا الْعَالَمَ لِنَفْسِهِ، غَيْرَ حَاسِبٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ" (2كو5: 19).
لذلك عندما نطلب من الرب أن يغفر خطاياهم، إنما نعني أنه لا يذكرها لهم فيما بعد، ولا يحسبها عليهم.
بل كما طلب داود النبي في مزمور التوبة قائلًا: "اغْسِلْنِي فَأَبْيَضَّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلْجِ" (مز51: 7). فتكون هذه الخطايا قد انتهت تمامًا، وأصبح الإنسان نقيًا كأنه لم يخطئ من قبل. ولكن لكي يفعل الرب هذا، لا بد أن نتوب لكي يغفر.
نقول له: "غفرت آثام شعبك، سترت جميع خطاياهم" يقول: نعم، بشرط التوبة "ارْجِعُوا إِلَيَّ أَرْجعْ إِلَيْكُمْ" (ملا3: 7).
بل يقول أكثر من هذا: "إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تَهْلِكُونَ" (لو13: 3-5). إذًا صلاتنا من أجل أن يغفر الله خطايا شعبه، هي صلاة أيضًا من أجلهم أن يتوبوا، ليستحقوا مغفرته.
[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 26 أبريل 1996م
الفصل السادس أساساته فِي الْجِبَالِ الْمُقَدَّسَةِ
أساساته في الجبال المقدسة[1]
مز (86) [87]
وهو من مزامير صلاة الساعة السادسة.
أما موضوع المزمور فهو مدينة الله العلي، التي نحن سكانها أو مواطنوها. مدينة الله يمكن أن تكون قلب الإنسان، ويمكن أن تكون الكنيسة المقدسة – جماعة المؤمنين – التي فيها السيد المسيح هو الرأس، ونحن الأعضاء. هذه المدينة تأملها المرنم طويلًا، فصاح في قلبه من عمق الحب.
أساساته في الجبال المقدسة:
أي أن هذه الأساسات التي وضعها الله لهذه المدينة هي في الجبال المقدسة. هكذا تحدث عنها داود النبي كأحد سكانها أو مواطنيها. ومواطن آخر هو بولس الرسول يقول عنها أيضًا: "الْمَدِينَةَ الَّتِي لَهَا الأَسَاسَاتُ، الَّتِي صَانِعُهَا وَبَارِئُهَا اللهُ" (عب11: 10).
ويقول القديس أغسطينوس عن الأنبياء والرسل – كمواطنين من سكان هذه المدينة – "لعلهم كذلك من جهة أنهم هم أنفسهم الجبال التي عليها أساسات المدينة". ويستدل على ذلك بقول الرسول: "مَبْنِيِّينَ عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ" (أف2: 20). أي أن الرسل بكرازتهم وتبشيرهم كانوا هم أساسات لهذه المدينة، أو هم وضعوا لها أساسًا. لأنهم كما أنهم هم كانوا أساسات لنا، فإن هناك من كان أساسًا لهم ولنا جميعًا وهو يسوع المسيح نفسه الذي قال عنه نفس الرسول: "لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَضَعَ أَسَاسًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي وُضِعَ، الَّذِي هُو يَسُوعُ الْمَسِيحُ" (1كو11:3). ولذلك فعندما قال بولس: "مبنيين على أساس الرسل" أردف بعدها مباشرة: "ويسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية". ولكن كيف يكون الرسل أساسات، والمسيح هو الأساس، وليس أساس غيره؟!
هم أساسات – ليسوا بذواتهم – وإنما كمجرد أوانٍ خزفية لله، من حيث أن المسيح هو الذي يعمل فيهم، تمامًا كما قال بولس الرسول، أحد هذه الأساسات: "فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ" (غلا2: 20). وأيضًا من حيث أن ما يجري عليهم يجري على المسيح ذاته، الذي لم يقل لشاول الطرسوسي "لماذا تضطهد هؤلاء؟" وإنما قال له: "لماذا تضطهدني؟"، ويؤيد كون الرسل هم الأساسات – في المسيح – قول يوحنا الرائي عن أورشليم السمائية: "وَسُورُ الْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ أَسَاسًا، وَعَلَيْهَا أَسْمَاءُ رُسُلِ الْخَرُوفِ الاثْنَيْ عَشَرَ" (رؤ14:21).
أما عن كون هذه الأساسات على الجبال، فيلاحظ القديس أغسطينوس ملاحظة جميلة مؤداها أنك إن كنت تبني على الأرض، فإنك تجعل الأساس تحت الأرض. أما إذا كان البناء في السماء – أي مدينة سمائية – فإن أساساتها تكون على الجبال. كما يلاحظ ملاحظة أخرى وهي أن هناك فرقًا بين هذه المدينة والمدن العالمية. فالمدن العالمية بناؤها شيء وسكانها شيء آخر. أما هذه المدينة المقدسة، فإنها مبنية من سكانها الذين هم الحجارة الحية التي تُبنى بها هذه المدينة. وفي ذلك قال بطرس الرسول للمؤمنين: "مَبْنِيِّينَ كَحِجَارَةٍ حَيَّةٍ بَيْتًا رُوحِيًّا" (1بط2: 5).
المرتل حتى الآن لم يذكر اسم المدينة!! فإن سألته ما هي هذه المدينة التي أساساتها على الجبال المقدسة؟ لأجاب: "أحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب".
صهيون هي أورشليم، وكانت مفضّلة على جميع مساكن يعقوب. إذ أن فيها الهيكل، ومن أبوابها كانت تدخل الذبائح والمحرقات والتقدمات.. إلخ. ولذلك دُعِيَ عليها اسم الرب، وسمّاها السيد المسيح نفسه "مَدِينَةُ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ" (مت 5: 35).
وصهيون الأرضية هذه كانت ترمز إلى أورشليم السمائية. وفي ذلك يقول بولس الرسول: "بَلْ قَدْ أَتَيْتُمْ إِلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ، وَإِلَى مَدِينَةِ اللهِ الْحَيِّ. أُورُشَلِيمَ السَّمَاوِيَّةِ، وَإِلَى رَبَوَاتٍ هُمْ مَحْفِلُ مَلاَئِكَةٍ وَكَنِيسَةُ أَبْكَار" (عب12: 22).
هذه هي الكنيسة، أورشليم السمائية، التي يقول عنها القديس يوحنا في رؤياه: "وَأَنَا يُوحَنَّا رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ أُورُشَلِيمَ الْجَدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُهَيَّأَةً كَعَرُوسٍ مُزَيَّنَةٍ لِرَجُلِهَا وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ السَّمَاءِ قَائِلًا: هُوَذَا مَسْكَنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ" (رؤ21: 2-3).
ولئلا يظن الأمم أنهم غرباء عن هذه المدينة التي تحمل أسماء وذكريات يهودية، قال لهم بولس الرسول: "فَلَسْتُمْ إِذًا بَعْدُ غُرَبَاءَ وَنُزُلًا، بَلْ رَعِيَّةٌ مَعَ الْقِدِّيسِينَ وَأَهْلِ بَيْتِ اللهِ مَبْنِيِّينَ عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ" (أف2: 19، 20).
أعمال مجيدة قد قيلت عنكِ يا مدينة الله.. يرى القديسون أن المدينة المقصودة بهذه الآية هي الكنيسة المهيأة كعروس لعريسها، وليست أورشليم الأرضية التي خربت ودفعها الله إلى أيدي أعدائها، تنجس هيكلها ولم يُترك فيه حجر على حجر إلا ونقض. فمن قال هذه الأعمال المجيدة عن مدينة الله؟
إنه الله الذي قال: "سأذكر راحاب وبابل اللتين تعرفانني".
لأن الفلسطينيين أيضًا وصور والأحباش كانوا هناك: راحاب ليست من اليهود. إنها من أريحا، وأريحا كانت وثنية، وكذلك بابل. فكيف أتيح لراحاب وبابل أن تعرفا الله؟! وكيف أمكن أن يكون هناك – أي في صهيون – الفلسطينيون وصور وشعب الحبشة، وكل هذه قبائل غريبة؟! إنه خلاص العالم، خلاص الأمم. الغرباء لم يعودوا غرباء! إن الرسول يقول لهم: "أَنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ بِدُونِ مَسِيحٍ، أَجْنَبِيِّينَ، وَغُرَبَاءَ عَنْ عُهُودِ الْمَوْعِدِ، لاَ رَجَاءَ لَكُمْ، وَبِلاَ إِلهٍ فِي الْعَالَمِ. وَلكِنِ الآنَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، أَنْتُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ قَبْلًا بَعِيدِينَ، صِرْتُمْ قَرِيبِينَ بِدَمِ الْمَسِيحِ" (أف2: 12 ،13). "لِكَيْ تُخْبِرُوا بِفَضَائِلِ الَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ الْعَجِيبِ، الَّذِينَ قَبْلًا لَمْ تَكُونُوا شَعْبًا، وَأَمَّا الآنَ فَأَنْتُمْ شَعْبُ اللهِ" (1بط2: 9، 10). حقًا، إن أعمالًا عجيبة قد قيلت عنك يا مدينة الله!
راحاب الزانية الأممية، صارت من شعب الله، بل صارت جدة المسيح ذاته حسب الجسد!! وبابل العدوّة، مدينة السبي، التي بكى أولاد الله على أنهارها، ولم يستطيعوا أن يسبحوا تسبحة الرب في تلك الأرض الغريبة "بَابِلُ، أُمُّ الزَّوَانِي وَرَجَاسَاتِ الأَرْضِ" (رؤ17: 5). هذه أيضًا خلصت. ما أعجب هذا! راحاب وبابل اللتان ترمزان إلى الأمم وإلى الأشرار، يقول عنهما الله أنهما تعرفانه، وأنه سيذكرهما كما سيذكر أيضًا باقي الأمم! وكمجرد مثال ذكرت فلسطين وصور وشعب الحبشة كرمز لأولئك الغرباء!
فكيف حدث هذا الخلاص العظيم؟ كيف دخل كل هؤلاء في صهيون، وكانوا هناك، وأصبحوا هم أيضًا أعضاء في الكنيسة؟ ما هو السر المختفي وراء هذه الأعمال المجيدة التي قيلت عن مدينة الله؟ يجيب المرتل قائلًا: "صهيون الأم تقول إن إنسانًا، وإنسانًا قد صار فيها، وهو العلي الذي أسسها". هذا هو إذًا سر الخلاص العظيم. العلي الذي أسسها، صار إنسانًا فيها. لا تعجب فالعذراء صارت أمًا لإلهها الذي خلقها. "عَظِيمٌ هُو سِرُّ التَّقْوَى اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ" (1تي 3: 16)! حقًا إن أعمالًا مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. ولكن كيف عرفنا وتأكدنا من هذا السر العظيم؟
الرب يُحدّث في كُتُب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها: الذين ولدوا فيها هم المؤمنون، ورؤساؤهم هم الرسل، وكُتُب هؤلاء الرؤساء الذين ولدوا فيها هي الأناجيل والرسائل. في هذه يحدث الرب عن ميلاده بالجسد من أجل خلاص العالم. يحدث عن العذراء وعن الخلاص وعن الملكوت. لذلك سميت هذه الكتب أناجيل أي بشائر مفرحة. ولماذا سميت هكذا؟ لأن سكنى الفرحين جميعهم فيك. هللويا. افرحوا فقد ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. "اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا: افْرَحُوا" (في4:4).. فهوذا "الإنسان" تقول صهيون الأم أنه صار فيها، قد حمل خطاياها، ومات عنها، ودفع أجرة الخطية، لكي لا يموت كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، ما أعجب هذا! هل سوف لا يكون في صهيون غير الفرحين؟ نعم. وقد شهد يوحنا الرائي بنفسه وقال: "وَسَيَمْسَحُ اللهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُيُونِهِمْ، وَالْمَوْتُ لاَ يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ، وَلاَ يَكُونُ حُزْنٌ وَلاَ صُرَاخٌ وَلاَ وَجَعٌ فِي مَا بَعْدُ، لأَنَّ الأُمُورَ الأُولَى قَدْ مَضَتْ" (رؤ21: 4). ماذا أيضًا "وَلاَ تَكُونُ لَعْنَةٌ مَا فِي مَا بَعْدُ. وَلاَ يَكُونُ لَيْلٌ هُنَاكَ، وَلاَ يَحْتَاجُونَ إِلَى سِرَاجٍ أَو نُورِ شَمْسٍ، لأَنَّ الرَّبَّ الإِلهَ يُنِيرُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ سَيَمْلِكُونَ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ" (رؤ22: 3-5). حقًا، إن سكنى الفرحين جميعهم فيك.
تأمل روحي من الناحية الفردية الشخصية: البعض يأخذ عبارة "الجبال المقدسة" كرمز لحياة الوحدة والخلوة، كمديح: "أساساته في الجبال – المقدسة بأعمال – والمزينة بجمال – آبائنا الرهبان". وهنا يمكن أن ترمز "أبواب صهيون" إلى حياة التأمل، "وجميع مساكن يعقوب" إلى حياة العمل؛ حيث كان كل الشعب يعملون، بينما أورشليم – مدينة الملك العظيم – كانت للذبائح والعبادة.
ويمكن أن ترمز عبارة "صهيون" إلى قلبك الذي يطلبه الله "يا ابني أعطني قلبك"، أكثر من "جميع مساكن يعقوب" أي أكثر من جميع مشغولياتك وأعمالك الأخرى. وأن أساس العبادة هو في هذا القلب. فمنه يحكم على مشاعر الإنسان وعلى عمله هل هو خير أم شر، حسب نيته فيه. وطوبى لمن وضع الله أساساته في قلبه. فهذا تملك عليه المحبة، وتكون أعماله كلها روحية وليست مجرد مظاهر خارجية.
"أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله". أي أن الله صنع معك عجائب. عمل تغييرات في قلبك وفي نفسك. فما هي؟ "أذكر راحاب وبابل اللتين تعرفانني، هوذا القبائل الغريبة.. إلخ" أي أن أعمالي الخاطئة القديمة تحولت إلى معرفة الله. الزنا القديم (راحاب)، وسبي الخطية (بابل)، والأفكار الغريبة عن الحياة المقدسة (القبائل الغريبة) وباقي الأعمال الغريبة عن الملكوت، هذا كله قد تحول إلى مشاعر وأفكار وأعمال طيبة، كل هذا (كان هناك) يعرف الله.
"صهيون الأم تقول إن إنسانًا، وإنسانًا صار فيها". يشير هذا إلى حلول الله في قلب الإنسان "صار فيه". وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد. أي هو الله الذي خلقني وثبتني فيه إلى الأبد. فهو صاحب الفضل عليَّ.
"الرب يحدث في كل كتب الشعوب والرؤساء" أي أن الله يحدث في الأناجيل بالعمل العظيم الذي عمله معي، لأنه قال: "سَيَأْتُونَ مِنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِب وَيَتَّكِئُونَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ" (مت11:8)، كما حدث بإيمان الكنعانية وتوبة العشار. إلخ.
"لأن سكنى الفرحين جميعهم فيك يا مدينة الله". أي أن القلب بمعيشته مع الله يحيا حياة فرح بالرب. إذ لا توجد خطية تتعبه، ولا شهوة يشتهيها ويتعب في الحصول عليها، ولا حسد يؤرقه، ولا وخز ضمير من أجل خطأ ثابت، وإنما ليس سوى الفرح بالعشرة مع الله. كما قال بولس الرسول "من ثمار الروح فرح وسلام" (غلا5: 22).
[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ يناير 1965م
الفصل السابع الرب قد ملك
الرب قد ملك[1]
[مز 92] (93)
اَلرَّبُّ قَدْ مَلَكَ
هنا ونسأل: متى بدأ الرب يملك؟ والجواب أنه يملك منذ البدء، وليس لملكه انقضاء (دا 7: 14). إنه يملك الكل، لأنه خالق الكل، ولأنه رب الكل. هو خلق المسكونة كلها، فكلها ملكه. كما قيل في المزمور: "لِلرَّبِّ الأَرْضُ وَمِلْؤُهَا. الْمَسْكُونَةُ، وَكُلُّ السَّاكِنِينَ فِيهَا" (مز24: 1). وعندما خلق الله الإنسان، خلقه ملكًا، على صورته ومثاله. لذلك نقرأ في الأصحاح الأول من سفر التكوين إن الله قد قال لأبوينا الأولين: "أَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلأُوا الأَرْضَ، وَأَخْضِعُوهَا، وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ" (تك1: 28). لذلك آدم كان ملكًا على الفردوس.
وبعد الطوفان، حينما غُسلت الأرض من الخطية وتطهرت، أعطى الله لنوح وبنيه نفس البركة: المُلك والسيطرة. فقال لهم: "وَلْتَكُنْ خَشْيَتُكُمْ وَرَهْبَتُكُمْ عَلَى كُلِّ حَيَوَانَاتِ الأَرْضِ وَكُلِّ طُيُورِ السَّمَاءِ، مَعَ كُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ، وَكُلِّ أَسْمَاكِ الْبَحْرِ. قَدْ دُفِعَتْ إِلَى أَيْدِيكُمْ" (تك9: 2). على أن مُلك الإنسان ينبغي أن يكون داخل مُلك الله. أما الشيطان فملكه – إن ملك – يكون لونًا من ألوان التمرد على ملك الله.
ما دام الله ملكًا، وخلق الإنسان ملكًا، فمتى آل الملك للشيطان؟ حدث ذلك لما أخضع الإنسان، صار الإنسان الخاضع للشيطان عبدًا له. وصار الشيطان ملكًا على الذين يخضعون له. وبسقوط الإنسان ملكت الخطية على العالم، وبالخطية ملك الموت على العالم (رو5: 12). وصار الشيطان رئيسًا على هذا العالم (يو16: 11). السيد المسيح سماه هكذا، وقال عنه: "رَئِيسَ هذَا الْعَالَمِ يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٌ" (يو14: 30). والقديس بولس الرسول سماه "رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ" (أف2:2).
وكما كان الشيطان يملك العالم جملة، كان يملكه تفصيلًا. نسمع في سفر دانيال في الأصحاح العاشر عن "َرَئِيسُ مَمْلَكَةِ فَارِسَ" (دا10: 13)، وأنه عطّل ملاكًا 21 يومًا عن إنقاذ دانيال، أي أن مملكة الشيطان لها رئاسات في جهات من الأرض. إن كان الشيطان هكذا، فمتى بدأ الرب يملك؟ يقول المزمور:
"الرب ملك على خشبة" (مز96: 10) أي على خشبة الصليب.
عندما مات على الصليب، ودفع ثمن الخطية، واشترانا بدمه، كما قال القديس بولس الرسول: "لأَنَّكُمْ قَدِ اشْتُرِيتُمْ بِثَمَنٍ" (1كو6: 20) (1كو7: 23). وفي سفر الرؤيا يسبحون الحمل قائلين: "مُسْتَحِق أَنْتَ.. لأَنَّكَ ذُبِحْتَ وَاشْتَرَيْتَنَا للهِ بِدَمِكَ" (رؤ5: 9). وهكذا أصبحنا ملكه، لأنه اشترانا بدمه.
إذًا حينما نقول: "الرب قد ملك"، لا بد أن نتذكر ذبيحة الصليب. لأنه لولا ذبيحة الصليب، لاستمر الشيطان يملك على هذا العالم. إن المسيح بدأ يملك على خشبة الصليب. لذلك نحن نرتل مزمور: "الرب قد ملك" في آخر صلاة الساعة السادسة التي نذكر فيها صليب المسيح. فلو سأل أحد: هل ملك المسيح حينما تجسد؟ أو حينما بدأ رسالته في الكرازة والتبشير؟ نقول: كلا. كل هذه كانت بداية. لذلك فالسيد المسيح في بشارته، كان يقول: "توبوا فقد اقترب ملكوت الله" (مر1: 15). اقترب الملكوت بتجسد المسيح وبشارته. ولكنه تم على الصليب.
كان السيد المسيح "يَكْرِزُ بِبِشَارَةِ مَلَكُوتِ اللهِ" (مر1: 14). وحينما أرسل تلاميذه، قال لهم: "اكْرِزُوا قَائِلِينَ إِنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ" (مت10: 7). ولكن هذا الملكوت تم على الصليب. فحينما نقول الرب قد ملك، نقصد أنه بدأ ملكه على الصليب حينما اشترانا بدمه، فصرنا ملكه. وأخذ الرب "مفاتيح الهاوية والموت" كما قال للقديس يوحنا في الرؤيا (رؤ1: 18). وهكذا حطّم مغاليق الجحيم، وفتح باب الفردوس، لِذلِكَ يَقُولُ: "سَبَى سَبْيًا وَأَعْطَى النَّاسَ عَطَايَا" (أف 4: 8) واشترانا بدمه.
وبدأ الملكوت يتأسس بالدم وبالصليب. كل هذا كلام نقوله عن الكنيسة كلها.
ولكن بالنسبة إليك أنت: هل الرب ملك عليك أم لم يملك؟
وهنا أسألك سؤالًا: لنفرض أن الله قد ملك على المسكونة كلها، ولم يملك عليك أنت، فماذا يكون مصيرك؟! لو أن بشارة الملكوت وصلت إلى أقاصي الأرض، ولم تصل إليك، هل تحتمل أن تهلك؟ ولو دخل الناس جميعًا إلى الملكوت، ولم تدخل أنت، ماذا يكون وضعك؟ لا بد أن تفكر هل ملك الله عليك أم لم يملك؟
ومتى يملك الرب عليك؟ وما علامات ذلك؟
إن الرب يملكك، حينما تصعد معه على الصليب، وإنسانك العتيق تُدق فيه المسامير وينتهي. عندئذ يكون الرب قد ملك، ملك عليك. حينما تنشد مع الرسول قائلًا: "مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ" (غل2: 20). عندما يمسح الرب بدمه جميع خطاياك التي تبت عنها، حينئذ تقول: الرب قد ملك. وملكوت الله بالنسبة إليك، يجب أن يكون ملكوتًا كاملًا وليس جزئيًا.
أتقول له: أملك يا رب على عينّ، وليس على لساني! أو تقول له: أملك أموالي ولكن لا تملك قلبي! كل هذا مرفوض، لا بد أن يملك الله ملكًا كاملًا وليس ملكًا جزئيًا.
أنظر إلى كل عضو فيك متمرد على مملكة الله، لكي تخضعه لملكوته.. هل تظنون أن الشيطان حينما يريد أن يملك إنسانًا، يصرّ على أن يملكه كله؟ كلاَّ. إنه قد يملك عضوًا منه، ويقول له: يكفيني هذا، أو على الأقل يكفيني الآن. وبهذا العضو وحده يهلكه. يقول مثلًا: أنا يكفيني أن أملك فقط لسانك وحده. ولما أملك لسانك أهدمك كلك من أولك إلى آخرك.
يقول لآخر: لا أريد أن أملك منك سوى حواسك؛ عينيك وأذنيك وملامسك، ويكفيني هذا، وأحطمك بالحواس. ويقول لثالث: لا أريد أن أملك سوى عقلك أو قلبك، ويكفيني هذا لإهلاكك. الشيطان يريد منك، ولو ثقب إبرة، وهذا يكفيه.
لأجل هذا لا تترك جزءًا من أرضك المقدسة يحتله الشيطان، ولو شبرًا.
متى تقول: الرب قد ملك؟ حينما يمتلكك الرب كلك. يملك عقلك وفكرك وقلبك وحواسك، ويملك وقتك. ويملك كل ما تملكه. من منا يستطيع أن يقول الرب قد ملك، بهذا المعنى؟!
وجائز أن الرب يملكك اليوم، وغدًا تنضم للأعداء!!
فلا يصح أن يكون ملكوت الله ملكوتًا مذبذبًا؛ اليوم في حالة، وغدًا في حالة أخرى، لا بد أن يكون ملكوت الله مستقرًا في حياتك. حينئذ يمكنك أن تقول: الرب قد ملك. هل أنت فعلًا عضو في ملكوت الله، وقد سلمته حياتك لكي يملكها؟ ليتك تكون هكذا.
الرب قد ملك ولبس الجلال
لبس الهيبة والوقار. قلنا إن المسيح ملك على خشبة. ونقول أيضًا أنه – وهو على الخشبة – كان في عمق جلاله. وهو على الصليب: انشق حجاب الهيكل، وكانت ظلمة على وجه الأرض (لو23: 45) "وَالأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ، وَالصُّخُورُ تَشَقَّقَتْ، وَالْقُبُورُ تَفَتَّحَتْ، وَقَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ الْقِدِّيسِينَ الرَّاقِدِينَ" (مت27: 51-52).
المسيح حينما ملك، ملك بجلال وهيبة، واستطاع أن يمسك الشيطان ويقيده، ويشل سلطانه، وأن يحطم أبواب الجحيم، ويفتح باب الفردوس. أما عنك أنت، فهل تستطيع أن تقول عن الرب أنه قد ملك ولبس الجلال؟
هل الرب له جلال في حياتك؟ وهل له خشية ووقار في حياتك؟
هل أنت من النوع الذي يخاف الله، ويخجل من ارتكاب الشر قدامه؟ هل أنت من نوع يوسف الصديق الذي قال: "كَيْفَ أَصْنَعُ هذَا الشَّرَّ الْعَظِيمَ وَأُخْطِئُ إِلَى اللهِ؟" (تك39: 9). هل الله قد لبس الجلال في حياتك؟ هل مخافة الله وخشيته تظهر في عبادتك وتصرفاتك؟ فحينما تصلي، هل تشعر بأن الله ملكٌ عظيمٌ أمامك، وفي جلاله أمامك، فتصلي حينئذ بخشوع ومهابة لله.. هل في تصرفات حياتك لا تسلك بكبرياء، إنما في اتضاع أمام ملك الملوك الذي لبس الجلال، وأنت تشعر بجلاله. إن الله لم يملك فقط، وإنما لبس الجلال.
فيجب أن ننظر إليه باعتباره ملك الملوك ورب الأرباب (رؤ19: 16). فإن شعرت أنك أمام ملك الملوك، يجب أن تملكك الخشية والهيبة والاحترام والتوقير، وبخاصة لأنك مجرد تراب ورماد. الشاروبيم والسارافيم شاعرون أن الله ملك ولبس الجلال، لذلك بجناحين يغطون وجوههم، وبجناحين يغطون أرجلهم، في هيبة ووقار. ويوحنا الحبيب حينما رأى الرب في جلاله في سفر الرؤيا، يقول: "سَقَطْتُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ كَمَيِّتٍ" (رؤ1: 17).
هل هيبة الله ضاعت من قلوبنا؟! لأن كثيرين يخطئون أمام الله بلا خجل، بلا استحياء، بلا مبالاة بوجه مكشوف!! لماذا لا نتذكر هذه العبارة "الرب قد ملك ولبس الجلال".. هذا الذي تخشع أمامه الملائكة.
إن الذي يملك الرب عليه فعلًا، يظهر جلال الله في حياته. يظن البعض أن الرب يملك عليهم، عندما تكون لهم مواهب!! كلا، بل عندما تكون لهم نقاوة قلب. فشاول الملك بعد مسحه ملكًا، حل عليه روح الرب وتنبأ (1صم10:10). ومع ذلك لم يكن الرب يملك عليه، وهلك.. وفي اليوم الأخير سيقف البعض أمام الله، ويقولون له: "يا رب أَلَيْسَ بِاسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِاسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟" فيقول لهم: "إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! اذْهَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي الإِثْم" (مت7: 22، 23). واضح أن الرب لم يكن يملك عليهم.
عندما يملك الله عليك تظهر فيك ثمار الروح (غل5: 22، 23).
أيضًا عندما يملك الرب عليك ويلبس الجلال، أنت نفسك يظهر الجلال في حياتك. هناك أشخاص حينما يملك الرب عليهم، تكون لهم هيبة أمام الشياطين، فيخاف الشياطين منهم، ويقولون مثل هذا الشخص تظهر هيبة الله في حياته. يقال إن له هيبة من الله، بل إن الشياطين لا تجرؤ على الاقتراب منه. مثال قصة القديس إيسذوروس الذي لما أنقذ أخًا من حروب الشياطين، قال له الشيطان: أما يكفيك أننا لا نستطيع أن نعبر على قلايتك، ولا على القلاية التي إلى جوارك. وأخ واحد لنا في البرية جعلته يعتدي علينا بصلواته النهار والليل؟!
أو مثل ذلك الأخ المبتدئ الذي قال لشيخ: "جئت لكي أحيا تحت ظل صلواتك" أي يحتمي بصلواته، حيث لا يجرؤ الشياطين أن يأتوا.. الإنسان الروحي يهاب الله، وهو له مهابة عند الناس، وله مهابة أيضًا أمام الشياطين. حاربوه قبلًا فهزمهم. فعرفوا أن الرب قد ملك عليه، فصاروا يهابونه، يهابون الله الساكن فيه. ولكن ماذا عن الناس؟
الناس يهابونه، فلا يجرؤ أحد على الخطأ في حضرته.
لا يجرؤ أحد أن يقول أمامه كلمة بطالة، أو فكاهة شريرة، ولا يجرؤ أن يقترف أمامه فعلًا شائنًا، لأن له مهابة، كإنسان مثلًا لا يجرؤ أن يدخن أمام شخص روحي. ولا أن يخطئ في وجوده، بسبب كرامته وهيبته وجلاله ووقاره الروحي.
الرب قد ملك ولبس الجلال. وماذا يقول المزمور بعد ذلك.
الرب لبس القوة وتمنطق بها
المنطقة هي الحزام، يلبسه من يستعد للعمل والبدء فيه. وهنا الرب تمنطق بها أي لبس هذه القوة.
وهنا يبدو السيد الرب على الصليب في قوته التي هزم بها الشيطان وحطّم مملكته، القوة التي استرجع بها كل من سباهم الشيطان، فردّهم الرب إلى ملكوته، القوة التي فتح بها باب الفردوس..
فهل لبس الرب القوة في حياتك؟
أي قد بدأ يعمل فيك بقوة، هذا الذي نقول له في المزمور: "تَقَلَّدْ سَيْفَكَ عَلَى فَخْذِكَ أَيُّهَا الْجَبَّارُ، استلّه وانجح واملك" (مز45: 3). وهكذا يتقلد الله سيفه ويهزم كل فكر يحاربك، وكل شهوة وكل خطية، فيملك عليك، ويحارب عنك، وبقوة. إذًا حينما يملك الرب عليك، يبدأ يشتغل فيك بقوة، ويهلك جميع أعدائك من الشياطين. وبقوته ينزع كل تمرد في حياتك ضده. إن الله حينما ملك على الكنيسة، ظهرت قوته في حياتها.
وإذ بالإيمان ينتشر في كل مكان "وَكَانَتْ كَلِمَةُ اللهِ تَنْمُو، وَعَدَدُ التَّلاَمِيذِ يَتَكَاثَرُ جِدًّا" (أع6: 7)، وزحف الإيمان من أورشليم وكل اليهودية إلى السامرة ثم إلى أقصى الأرض، كان ملكوت الله قد أتى بقوة.
وهذه القوة قد وهبها الرب لتلاميذه، فكانوا يشهدون له بكل مجاهرة وبلا مانع. وبقوة وقفوا أمام رؤساء اليهود، وأمام الدولة الرومانية، وأمام كل فلاسفة الوثنية. وكيف ذلك؟ كان الرب قد أوصاهم ألا يبرحوا أورشليم حتى يلبسوا قوة من الأعالي (لو24: 49). ونالوا هذه القوة بحلول الروح القدس عليهم (أع1: 8). نعم، لبسوا القوة وتمنطقوا بها، كسيدهم. يقول الكتاب: "وَبِقُوَّةٍ عَظِيمَةٍ كَانَ الرُّسُلُ يُؤَدُّونَ الشَّهَادَةَ بِقِيَامَةِ الرَّبِّ يَسُوعَ، وَنِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ كَانَتْ عَلَى جَمِيعِهِمْ" (أع 4: 33). القديس بولس الرسول لما تحدث عن رسالته، نسب جهاده إلى عمل الرب فيه، فقال: "بِحَسَبِ عَمَلِهِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيَّ بِقُوَّةٍ" (كو1: 29). والقديس اسطفانوس رئيس الشمامسة، وقفت أمامه ثلاثة مجامع "وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُقَاوِمُوا الْحِكْمَةَ وَالرُّوحَ الَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ" (أع6: 10)، إذ كان يكرز بقوة.
هذا عن الكنيسة. وأما أنت أيها الأخ المحبوب، فهل تشعر بقوة الله في حياتك؟
اعرف أن الخطية ضعف، والإنسان الخاطئ هو إنسان ضعيف وعاجز، ليس لديه قوة لمقاومة حروب الشياطين، ولكن حينما يملك الرب عليه، يُملّكه القوة التي يتمنطق بها، حسب عمل الله الذي يعمل فيه بقوة، قوة بالنسبة إلى ذاته في الانتصار على الخطايا، وقوة بالنسبة إلى نشر ملكوت الله. الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها.
هذا هو نشيد ينشده المنتصرون، الذين قادهم الرب في موكب نصرته (2كو2: 14). السيد الرب ينشر ملكوته، وهم يتبعونه عاملين معه، فرحين بعمله فيهم، ومنشدين هذا المزمور "الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها".
ليتنا ونحن ننشد هذا المزمور، نتذكر الكنيسة وعمل الله فيها، وهي تنمو يومًا بعد يوم. وتزداد قوة في عملها، وتلبس القوة وتتمنطق بها. فالمسيحية ليست ضعفًا على الإطلاق، بل هي قوة من الروح القدس، يلبسها الناس ويتمنطقون بها.
يا أخوتي الأحباء، ابحثوا في حياتكم عن مواطن الضعف فيكم.
ابحثوا عن الأسوار المتهدمة التي تقفز منها الشياطين إلى داخل قلوبكم.
واطلبوا من الله أن يعمل فيكم بقوة، ما دام الله قد لبس القوة وتمنطق بها. ليقل له كل واحد منكم: أريد يا رب أن أرى قوتك في حياتي الخاصة. أنا أعترف أنني إنسان ضعيف وعاجز. ولكن بقوتك يمكنني أن أسير في طريقك. وعلى الرغم من ضعفى أقول: "أَسْتَطِيعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ الَّذِي يُقَوِّينِي" (في4: 13). أعطني القوة التي أعمل بها. تمنطق بالقوة في حياتي، أنت الذي قلت: "بِدُونِي لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا" (يو15: 5). يقول المزمور: لبس الرب القوة وتمنطق بها.
لأنه ثبّت المسكونة فلا تتزعزع
المسكونة يقصد بها ليس الأرض، وإنما يقصد الساكنين فيها. فعندما يقول المزمور: "يدين المسكونة بالعدل" (مز96: 13)، لا يقصد يدين الأرض، وإنما يدين الساكنين فيها.
ثبت المسكونة، فلا تتزعزع.
جماعة المؤمنين لا تتزعزع، لأن الرب قد ثبّت المسكونة. الكنيسة لا تتزعزع، لأن "َأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا" (مت18:16) العجيب أن الكتاب يقول: "تتزعزع الجبال بعزته" (مز46: 3). وفي (إش54: 10) يقول: "وَالآكَامَ تَتَزَعْزَعُ". وفي (إش13:13) يقول: "وَتَتَزَعْزَعُ الأَرْضُ مِنْ مَكَانِهَا فِي سَخَطِ رَبِّ الْجُنُودِ". بل أكثر من هذا يقول الرب عن علامات نهاية الأزمنة "وَقُوَّاتُ السَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ" (مت24: 29). عجيب أن الجبال تتزعزع، والأرض تتزعزع، وقوات السماوات تتزعزع. ولكن الكنيسة لا تتزعزع. لقد ثبت الله المسكونة فلا تتزعزع. لماذا؟ يجيب على ذلك السؤال داود النبي فيقول:
"عَنْ يَمِينِي فَلاَ أَتَزَعْزَعُ" (مز16: 8). نستنتج من كل هذا أن تأرجح حياتك الروحية وعدم ثباتها، أنك لا تعيش في صحبة الله باستمرار، ولا تحيا ملتصقًا بالله تأخذ القوة من يمينه، بثباتك في وسائط النعمة.
يا ليتنا يا أخوتي، نذكر آية جميلة قالها بولس الرسول: "إِذًا يَا إِخْوَتِي الأَحِبَّاءَ، كُونُوا رَاسِخِينَ، غَيْرَ مُتَزَعْزِعِينَ، مُكْثِرِينَ فِي عَمَلِ الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، عَالِمِينَ أَنَّ تَعَبَكُمْ لَيْسَ بَاطِلًا فِي الرَّبِّ" (1كو15: 58).
إن كان الرب قد ملك عليك في يوم من الأيام، فهل ملكوته لا يزال ثابتًا فيك لا يتزعزع؟ أم أنت كل يوم في حال مغاير؟! تعيش يومًا ثابتًا في الرب، ويومًا آخر مقهورًا من العدو! هل بيتك الروحي مبني على الصخر أم على الرمل؟ أقل ريح تهزّه، والسيول تهدمه؟! هل أنت صخرة ثابتة في كنيسة الله، أم ريشة في مهب الريح، كقول الشاعر:
كــــــريشة في مــهــب الـــريـــح طـــائـــرة لا تــســتـــقـــر عــلى حـــال مــن الـقــلـــق
ما أكثر الذين يعيشون في ملكوت الله، أو يظنون أنهم في الملكوت، بينما هم مثل الريش أمام الريح!! ما الذي يفهمه هؤلاء حينما يصلون في المزمور عبارة "ثبّت المسكونة فلا تتزعزع".. هم يوم مع إيليا ويوم مع آخاب!! يوم مع إيليا، وآخر مع أنبياء البعل. يوم في أورشليم، ويوم في غزة أو في سدوم! يوم يبتهجون يمينًا، وآخر يبتهجون شمالًا. يوبخهم النبي العظيم بقوله: "حَتَّى مَتَى تَعْرُجُونَ بَيْنَ الْفِرْقَتَيْنِ؟" (1مل18: 21).
إن كان الأمر كذلك، ليتنا نصلي طالبين من الله أن يثبتنا فلا نتزعزع. وإن سقطنا في يوم ما، نقوم بسرعة. يكون القيام هو الوضع الثابت في حياتنا، أما السقوط فلا يكون إلا شيئًا عارضًا ومؤقتًا ولا يستمر. كما قال داود النبي: "حبال المساحة وقعت عليَّ من الأعزاء. وإن ميراثي لثابت لي" (مز16: 6).
لا تنظر إلى الوراء مثلما نظرت امرأة لوط، وكان قلبها متزعزعًا بين الخروج من سدوم والبقاء فيها. ولا تكن مثل الغلاطيين الأغبياء الذين بدأوا بالروح وكمّلوا بالجسد (غل3:3).
لا تكن مثل ديماس الذي قضى فترة روحية يخدم في صحبة بولس الرسول، ثم تركه لأنه أحب العالم الحاضر (2تي4: 10). ولم يكن قلبه ثابتًا وهو يخدم؛ فكان حينًا مع القديس بولس، وحينًا مع شهوات العالم الحاضر!! احتفظ بالرب دائمًا عن يمينك. واثبت في وسائط النعمة لكي تعينك. كن كالطود (الجبل) الراسخ، بهيبتك المعطاة من الله.
واستمع إلى المعونة الإلهية التي يغنيها لك المرتل في المزمور: "يُسقط عن يسارك ألوف، وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقتربون إليك" (مز91: 7).
حينما وصل داود في المزمور إلى عبارة ثبت المسكونة فلا تتزعزع، حينئذ قال: "كرسيك ثابت منذ البدء. وأنت هو منذ الأزل".
كرسيك أي عرشك. والعرش رمز للمُلك. أي أن ملكوتك في قلوبنا ثابت منذ البدء. حقك في امتلاكنا هو حق أكيد ثابت لا نقاش فيه. فأنت الذي خلقتنا وافتديتنا واشتريتنا بدمك الكريم فصرنا لك. صرنا ملكك، لأننا كما قال الرسول اشترينا بثمن (1كو6: 20).
حينما نقول: "كرسيك ثابت منذ البدء" نذكر قول القديس أغسطينوس: "تأخرت كثيرًا في حبك أيها الجمال الفائق الوصف".
أين كرسي الله في قلبك؟ هل هو ثابتًا منذ البدء؟! ها هي السنوات تمر، وأنت كما أنت في خطاياك!! بأي وجه تقول لله: كرسيك منذ البدء؟! والأولى أن تقول: "تأخرت كثيرًا في حبك". أو على الأقل قل له: "إن لم يكن كرسيك ثابتًا فيَّ منذ البدء، فليثبت فيَّ منذ الآن". استقبل المسيح كملك، وأدخله إلى قلبك بأغصان الزيتون، بالفرح والتهليل. ماذا يقول داود بعد ذلك؟ إنه يقول:
رفعت الأنهار يا رب. رفعت الأنهار صوتها. من صوت مياه كثيرة.
حقًا إن بداية قصة الخلاص كانت قوية ومنتصرة؛ الرب قد ملك ولبس الجلال. لبس القوة وتمنطق بها، وثبت المسكونة فلا تتزعزع. ولكن هل ثبت الحال هكذا، أم قامت مقاومات عديدة ضد ملكوت الله، جعلت الأنهار ترفع صوتها من صوت مياه كثيرة، ومن البحار.
هناك فارق كبير بين النهر والبحر من الناحية الرمزية.
النهر ماؤه عذب يصلح للشرب وري الأرض. أما البحر فماؤه مالح لا يصلح للحياة. النهر هادئ، والبحر صاخب؛ ولذلك فالأنهار ترمز إلى الأبرار وعمل الروح القدس فيهم لريّ الناس. بينما البحر هنا يرمز إلى العالم في صخبه واضطراباته ومشاكله. انظروا إلى قول السيد الرب: "مَنْ آمَنَ بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ" (يو7: 38) ما هي هذه الأنهار؟ يكمل القديس يوحنا الإنجيلي فيشرح: "قَالَ هذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ" (يو7: 39). أنهار الماء الحي، قد تطلق على مواهب الروح. أو عن الأبرار الذين يحملون الماء الحي إلى الناس. ولعلها هنا تعني الآباء الرسل وتلاميذهم الذين حملوا الماء الحي إلى المؤمنين بكرازتهم وتعليمهم وتبشيرهم، ورووهم بهذا الماء. وفاضت عليهم بالإيمان والروحانية.
ولعل هذا الماء الحي هو ما وعد به الرب المرأة السامرية قائلًا: "مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ" (يو4: 14).
وعن هذه الأنهار التي تحمل الماء، قال داود النبي: "مجاري الأنهار تُفَرِّحُ مَدِينَةَ اللهِ" (مز46: 4). هذه الأنهار كما قلنا ترمز لمواهب الروح القدس، وأيضًا إلى الأشخاص المملوئين بالروح الذي يحملونه إلى الناس. فما الذي حدث لهذه الأنهار، للرسل والمبشرين والمعلمين؟ يقول المزمور:
رفعت الأنهار يا رب صوتها. حينما حل عليهم الروح القدس، رفعوا صوتهم بالكرازة والتعليم. يقول سفر أعمال الرسل عن ذلك اليوم: "فَوَقَفَ بُطْرُسُ مَعَ الأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ" (أع2: 14). إذًا أول صوت رفعته الأنهار كانت كلمة الكرازة والتعليم، التي آمن بها في ذلك اليوم أكثر من ثلاثة آلاف، انضموا إلى الكنيسة واعتمدوا.
وظلت الأنهار تعمل عملها. وكانت النتيجة هي قول الكتاب: "وَكَانَ الرَّبُّ كُلَّ يَوْمٍ يَضُمُّ إِلَى الْكَنِيسَةِ الَّذِينَ يَخْلُصُونَ" (أع2: 47).
رفعت الأنهار صوتها بالكرازة. فأراد الرؤساء إسكاتها، فرفضت أن تسكت وقالت: "نَحْنُ لاَ يُمْكِنُنَا أَنْ لاَ نَتَكَلَّمَ" (أع4: 20). وقالت الأنهار أيضًا: "يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ اللهُ أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ" (أع 5: 29). وهنا بدأت المضايقات والمقاومات والسجون والجلد.. فإذا أنهار أخرى، رفعت صوتها. رفعته بالصلاة.
قالوا: "يَا رَبُّ، انْظُرْ إِلَى تَهْدِيدَاتِهِمْ، وَامْنَحْ عَبِيدَكَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِكَلاَمِكَ بِكُلِّ مُجَاهَرَةٍ، بِمَدِّ يَدِكَ لِلشِّفَاءِ، وَلْتُجْرَ آيَاتٌ وَعَجَائِبُ بِاسْمِ فَتَاكَ الْقُدُّوسِ يَسُوعَ" (أع4: 29، 30).
ولكن لماذا هذه الصلاة التي بها تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه (أع 4: 31). لأنه كما قال داود النبي: "ارْتَجَّتِ الأُمَمُ، وَتَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟ قَامَ مُلُوكُ الأَرْضِ، وَتَآمَرَ الرُّؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الرَّبِّ وَعَلَى مَسِيحِهِ، (مز2: 1-2). نعم هذا ما قصده المرتل بقوله: رفعت الأنهار صوتها، من صوت مياه كثيرة.
وما هي هذه المياه الكثيرة؟ قال المصلون في ذلك اليوم: "لأَنَّهُ بِالْحَقِيقَةِ اجْتَمَعَ عَلَى فَتَاكَ الْقُدُّوسِ يَسُوعَ، الَّذِي مَسَحْتَهُ، هِيرُودُسُ وَبِيلاَطُسُ الْبُنْطِيُّ مَعَ أُمَمٍ وَشُعُوبِ إِسْرَائِيلَ" (أع4: 27) هذا عن وقت الصلب.
وماذا حدث بعد يوم الخمسين والبشارة فيه؟ قامت أهوال البحر ومياهه الكثيرة. هاج الأشرار والمقاومون، وهاجت المياه. يقول الكتاب: "وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ رُؤَسَاءَهُمْ وَشُيُوخَهُمْ وَكَتَبَتَهُمُ اجْتَمَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ مَعَ حَنَّانَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ وَقَيَافَا وَيُوحَنَّا وَالإِسْكَنْدَرِ، وَجَمِيعِ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ عَشِيرَةِ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ" (أع4: 5، 6).
قاموا ضد بطرس ويوحنا وحاكموهما. ثم أمروهما أن يخرجا خارج المجمع. وتآمروا فيما بينهم (أع4: 7، 15). وماذا أيضًا "جَلَدُوهُمْ، وَأَوْصَوْهُمْ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمُوا بِاسْمِ يَسُوعَ، ثُمَّ أَطْلَقُوهُمْ. وَأَمَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامِ الْمَجْمَعِ، لأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَانُوا مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ" (أع 5: 40 ،41).
وهناك مياه أخرى كثيرة شرحها القديس بولس الرسول:
فقال: "فِي الأَتْعَابِ أَكْثَرُ، فِي الضَّرَبَاتِ أَوْفَرُ، فِي السُّجُونِ أَكْثَرُ، فِي الْمِيتَاتِ مِرَارًا كَثِيرَةً. مِنَ الْيَهُودِ خَمْسَ مَرَّاتٍ قَبِلْتُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً إِلاَّ وَاحِدَةً. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ضُرِبْتُ بِالْعِصِيِّ، مَرَّةً رُجِمْتُ" (2كو11: 23-25). وماذا أيضًا؟ يقول الرسول: "بِأَخْطَارِ لُصُوصٍ، بِأَخْطَارٍ مِنْ جِنْسِي، بِأَخْطَارٍ مِنَ الأُمَمِ، بِأَخْطَارٍ فِي الْمَدِينَةِ، بِأَخْطَارٍ فِي الْبَرِّيَّةِ، بِأَخْطَارٍ فِي الْبَحْرِ، بِأَخْطَارٍ مِنْ إِخْوَةٍ كَذَبَةٍ" (2كو11: 26). حقًا إنها مياه كثيرة قامت ضد الأنهار.
وجميل أن يقول داود النبي عن كل هذه وأمثالها "لَوْلاَ الرَّبُّ الَّذِي كَانَ لَنَا لِيَقُلْ إِسْرَائِيلُ، لَوْلاَ الرَّبُّ الَّذِي كَانَ لَنَا عِنْدَ مَا قَامَ النَّاسُ عَلَيْنَا إِذًا لاَبْتَلَعُونَا أَحْيَاءً عِنْدَ احْتِمَاءِ غَضَبِهِمْ عَلَيْنَا إِذًا لَجَرَفَتْنَا الْمِيَاهُ، لَعَبَرَ السَّيْلُ عَلَى أَنْفُسِنَا. إِذًا لَعَبَرَتْ عَلَى أَنْفُسِنَا الْمِيَاهُ الطَّامِيَةُ مُبَارَكٌ الرَّبُّ الَّذِي لَمْ يُسْلِمْنَا فَرِيسَةً لأَسْنَانِهِمْ. انْفَلَتَتْ أَنْفُسُنَا مِثْلَ الْعُصْفُورِ مِنْ فَخِّ الصَّيَّادِينَ. الْفَخُّ انْكَسَرَ، وَنَحْنُ انْفَلَتْنَا" (مز124). وهكذا نتابع مزمورنا هنا، فيقول المرتل:
عجيبة هي أهوال البحر.
داود النبي يسمي المياه الكثيرة بالبحر. والبحر في الكتاب المقدس كثيرًا ما يرمز إلى العالم ومشاكله ومشاغله، كما يرمز إلى الشيطان وأعوانه من الأشرار. انظروا ماذا يقول سفر إشعياء النبي: "أَمَّا الأَشْرَارُ فَكَالْبَحْرِ الْمُضْطَرِبِ لأَنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْدَأَ، وَتَقْذِفُ مِيَاهُهُ حَمْأَةً وَطِينًا" (إش57: 20). وفي رسالة يهوذا يقول عن الأشرار وعن أعمالهم إنها: "أَمْوَاجُ بَحْرٍ هَائِجَةٌ مُزْبِدَةٌ بِخِزْيِهِمْ" (يه1: 13). حقًا، عجيبة هي أهوال البحر الذي هاج على المؤمنين بهذه المياه الكثيرة. ولكن قوة هذه المياه لم تستطع أن تجرفهم. لذلك قال المرتل بعد ذلك في المزمور:
الساكن في الأعالي هو أقدر.
أهوال البحر قوية. ولكن الله أقوى من البحر وكل أمواجه ولججه. يقول المزمور في ذلك: "يَا رَبُّ إِلهَ الْجُنُودِ، مَنْ مِثْلُكَ؟ قَوِيٌّ. أَنْتَ مُتَسَلِّطٌ عَلَى كِبْرِيَاءِ الْبَحْرِ. عِنْدَ ارْتِفَاعِ لُجَجِهِ أَنْتَ تُسَكِّنُهَا" (مز89: 8، 9).
لا تخف يا أخي من أهوال البحر. اطمئن أن السيد المسيح داس البحر بقدميه، وانتهر الريح فسكت، إذ قال له: "اسْكُتْ! اِبْكَمْ!" (مر4: 39).
فإن هاجت عليك أمواج البحر، قل: "يا رب من مثلك، متسلط على كبرياء البحر". لا تخف فإن الرب قد لبس القوة وتمنطق بها. وهو يعزينا بقوله: "ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ" (يو16: 33). ثبت قلبك إذًا، كي لا يتزعزع. واصمد أمام حروب الشيطان، أمام المياه الكثيرة.
ستجد أن أهوال البحر قد قذفت إليك بعثرات. بأفكار كثيرة، بشكوك، بشهوات، بأخوة كذبة يحاربونك. فتصرخ في صلواتك وتقول: "عجيبة هي أهوال البحر". وتجيبك النعمة قائلة: "الرب في الأعالي هو أقدر".
ارفع صوتك إلى الله لينقذك، كما رفعت الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. قل له: "أنا يا رب لست في قوة هؤلاء الذين يحاربونني. قم أنت يا رب وانتهر البحر، وأسكت لججه، لأنك أقدر".
إن أهوال البحر لم تقدر على الآباء الرسل، في كل ما تعرضوا له من محاربات، ولم تقدر على الشهداء في كل ما احتملوه من اضطهادات وإغراءات وتعذيب، ولم تقدر أهوال البحر على الآباء النساك والسواح في كل حروب الشياطين وحيلهم ومخاوفهم.. ولم تقدر أهوال البحر على داود النبي في كل مطاردات شاول الملك له، وفي كل خيانة أبشالوم ومشورة أخيتوفل، وعصيان يوآب وتهديده.
كانت أهوال البحر كثيرة. ولكن الرب في الأعالي هو أقدر لذلك كم تغنّى داود في المزمور الكبير وقال: "جلس الرؤساء وتقاولوا عليَّ" وماذا فعلت؟ يقول: أما أنا فكنت أتلو فى شهادتك. لأن ناموسك هو درسي (مز119). إننا لا نأخذ نصف الآية، ونترك النصف الآخر. نصفها يقول: "فِي الْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ". والنصف الآخر يقول: "لكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ" (يو16: 33). النصف هو "تُسَاقُونَ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكٍ" (مت10: 18) "وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ الْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ اسْمِي" (مت10: 22) والنصف الآخر "فَمَتَى أَسْلَمُوكُمْ فَلاَ تَهْتَمُّوا كَيْفَ أَوبِمَا تَتَكَلَّمُونَ، لأَنَّكُمْ تُعْطَوْنَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مَا تَتَكَلَّمُونَ بِهِ، لأَنْ لَسْتُمْ أَنْتُمُ الْمُتَكَلِّمِينَ بَلْ رُوحُ أَبِيكُمُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيكُمْ" (مت10: 19-20).
الله يسمح بأن تصل الضيقة إليك. لكن في نفس الوقت يدبر الوسيلة التي تخلص بها من الضيقة. يسمح للبحر أن تهيج أمواجه عليك. وفي نفس الوقت يجهز لك قوارب النجاة. ويأمر لجج البحر أن تسكت.
إذًا كن ثابتًا في الرب، وجاهد وانتصر. ولا تظن أنه حينما يدخل الله إلى قلبك، ستبطل الحرب عنك. كلا، بل تقوم عليك حروب وأخبار حروب. ولكن الله سيقصّر تلك الأيام، لكي تخلص. "الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهذَا يَخْلُصُ" (مت 13:24).
إن رأيت جليات الجبار بشكله المخيف، وسهمه ورمحه وتهديداته، فلا تخف. بل قل: أرسل يا رب حصاة إلى مقلاعي، وأعطها القوة أن ترتكز في جبهة ذلك الجبار. أنت يا رب قادر أن تخلص بالكثير أو القليل (1صم14: 6). فاصنع معي رحمة. اجعل وعودك المقدسة تمنحني قوة، فأتمسك بشهادتك، لأن:
شهادتك هي ثابتة جدًا.
وعودك بالمعونة حينما قلت: "يُحَارِبُونَكَ وَلاَ يَقْدِرُونَ عَلَيْكَ، لأَنِّي أَنَا مَعَكَ، يَقُولُ الرَّبُّ، لأُنْقِذَكَ" (إر1: 19). وكما قلت أيضًا: "أَنَا مَعَكَ، وَلاَ يَقَعُ بِكَ أَحَدٌ لِيُؤْذِيَكَ" (أع18: 10). حقًا إن شهاداتك ثابتة جدًا وبها ستساعدني على نقاوة قلبي. لماذا؟ بيتك هو قلبي وعقلي. تليق به القداسة، لأنك قدسته بدمك، وبسكنى روحك القدوس فيَّ، فهوذا الكتاب يقول: "أَنَّكُمْ هَيْكَلُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ؟" (1كو3: 16). وهيكل الله مقدس هو..
[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ مايو 1965م، 29 ديسمبر1995م، 2 فبراير1996م
الفصل الثامن أَحْبَبْتُ لأَنَّ الرَّبَّ سمَع صَوْت، تَضَرُعي
أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي[1]
مز (114) [116]
إنه مزمور من مزامير صلاة الساعة التاسعة، هو والمزمور التالي له (مز115) يأخذان في الطبعة البيروتية رقم (مز116). والمزامير من 111 إلى 117 تبدأ أو تنتهي بعبارة هلليلويا. فهي مزامير تهليل وفرح بالرب أو شكر. وكانت ترتل في مناسبات أعياد أو تكريس. وقد استخدمها السيد المسيح في الاحتفال بالفصح. كما قيل "ثُمَّ سَبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ".(مت30:26)
فلنتأمل إذًا في هذا المزمور آية آية، إنه يقول:
أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي.
كان هذا المزمور يقال في عيد الفصح. وكلمة الفصحPass Over تعني العبور، فيتذكر فيه الناس عبورهم من أرض العبودية، من نير فرعون، واجتيازهم البحر الأحمر. فالمزمور إذًا يحمل مشاعر الشكر لله، والتسبيح والحمد والعرفان بالجميل، والشعور بمحبة الله، وتذكر الضيقات التي أنقذ الرب النفس منها.
هو مزمور يعبر عن الخلاص.
والخلاص المادي من نير فرعون، يرمز إلى الخلاص الروحي من نير الشيطان. خلاص به رجع بنو يعقوب إلى بيوت آبائهم كما كانوا من قبل. لذلك في النصف الثاني من المزمور، أو في مزمور 116 يقول: "آمَنْتُ لِذلِكَ تَكَلَّمْتُ" "كَأْسَ الْخَلاَصِ أَتَنَاوَلُ، وَبِاسْمِ الرَّبِّ أَدْعُو". هنا شعور باستجابة الله، وشعور بالراحة التي يرجع إليها الإنسان بعد التعب. ولنتناول المزمور من أوله إذ يقول: "أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي".
أحببت
عبارة "أحببت" لها أهمية كبيرة في الحياة الروحية، وفي علاقة الإنسان بالله التي لابد أن تتأسس على الحب. وفي هذا المزمور حب مبني على خبرة مع الله، واستجابة الله لتضرع المصلي: "أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي. لأنه أمال أذنه إليَّ فأدعوه كل أيامي".
الرب استجاب لتضرع النفس، فشعرت بمحبته، فبادلته حبًا بحب. فكانت محبتها له نتيجة لمحبته هو، ونتيجة لخبرتها الروحية معه وكما قال الرب: "ادْعُنِي فِي يَوْمِ الضِّيقِ أُنْقِذْكَ فَتُمَجِّدَنِي" (مز50: 15). كثيرًا ما يستجيب لنا الرب، وفي فرحتنا باستجابته، نركز على الاستجابة، وننساه هو!!
نفرح بالعطية، وننسى المُعطي!! وبدلًا من أن نحبه هو، نحب ما أعطاه لنا، وننشغل به، وننسى الشكر. أما في هذا المزمور نقول: "أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي". وهذا ما يريده الرب منا. يريد أن نصل معه إلى هذا الحب. يريد مشاعر قلوبنا، هذا الذي قال: "يَا ابْنِي أَعْطِنِي قَلْبَكَ" (أم26:23). نعم هذا الذي أوصانا منذ العهد القديم قائلًا: "تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُوَّتِكَ" (تث6: 5). وفي العهد الجديد كرر السيد المسيح وصية الحب هذه، وقال إنها الوصية الأولى التي يتعلق بها الناموس كله والأنبياء (مت 22: 36-40).
هذا هو الحب، الذي به عاتب بطرس الرسول قائلًا: "يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟". وكرر له السؤال ثلاث مرات (يو15:21-17). لم يعاتبه على إنكاره وعلى ضعفه، وإنما سأله ثلاثًا عن حبه.. لكي يسمع منه هذا الرد: "أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ".
لقد بدأت النفس بالمخافة في علاقتها مع الله، حسب قول الكتاب: "بَدْءُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ الرَّبِّ" (مز111: 10) (أم9: 10). ولكنها بالخبرة وصلت إلى الحب. فطرحت الخوف (1يو4: 18)، وقالت: أحببت..
في المخافة كان يربطها بالله رباط الطاعة والناموس. ولكن بالخبرة ذاقت ما أطيب الرب (مز34: 8). ووصلت إلى رباط الحب، وتغنت بهذا الحب في المزمور، بعد أن تمتعت بخلاص الرب لها، وإنقاذها من العبودية.
طبعًا في أيامنا هذه، لنا أسباب كثيرة لعبارة أحببت. أسباب يقدمها لنا العهد الجديد. أحببت لأنه افتداني بدمه، لأنه جعلني هيكلًا لروحه القدوس (1كو3: 16) (1كو6: 19). لأنه جعلني ابنًا (1يو1:3). لأنه خلصني بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس (تي3: 5). لأنه قادني في موكب نصرته (2كو2: 14). لأنه وهبني نعمته لكي تعمل فيَّ، فأقول: "لاَ أَنَا، بَلْ نِعْمَةُ اللهِ الَّتِي مَعِي" (1كو15: 10).
فأقول في هذا الحب: "فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ" (غل2: 20). نعم، هناك أسباب كثيرة أقول من أجلها أحببت. ليس فقط بسبب العبور من عبودية فرعون، بل بالعبور من الموت إلى الحياة. لأننا كنا أمواتًا (أف2: 1). لأن أوجاع الموت اكتنفتني، فأقامني معه، وأجلسني معه في السماويات (أف2: 6). أيضًا نحب الله، حينما نشعر أنه حقق لنا وعده القائل: "اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (مت7:7). لهذا فسّر داود سبب حبه بقوله:
لأن الرب سمع صوت تضرعي
تضرعت إلى الرب، والرب سمع صوت تضرعي. هناك من يتضرعون إلى الرب بصوت لا يسمعه أحد، كما تضرعت حنة امرأة ألقانة، طالبة من الله أن يعطيها ابنًا: "كَانَتْ تَتَكَلَّمُ فِي قَلْبِهَا، وَشَفَتَاهَا فَقَطْ تَتَحَرَّكَانِ، وَصَوْتُهَا لَمْ يُسْمَعْ" (1صم13:1). عالي الكاهن لم يسمع صلاتها. ولكن الله سمع هذه الصلاة الصامتة في نظر الناس. ولكنها كانت تقرع بشدة على باب الله، ببكاء ونذر وقلب منسحق، واستجاب لها الله، ومنحها سؤل قلبها.
وهناك أشخاص يصلون بصوتٍ عالٍ. ويقول: "بِصَوْتِي إِلَى الرَّبِّ أَصْرُخُ. بِصَوْتِي إِلَى الرَّبِّ أَتَضَرَّعُ" (مز142: 1). "مِنَ الأَعْمَاقِ صَرَخْتُ إِلَيْكَ يَا رَبُّ. يَا رَبُّ، اسْمَعْ صَوْتِي. لِتَكُنْ أُذُنَاكَ مُصْغِيَتَيْنِ إِلَى صَوْتِ تَضَرُّعَاتِي" (مز130: 1، 2). وفي هذا الصراخ إلى الله، تكون كل حواسه مركزة، وكل مشاعره عميقة. إن آيات الصراخ إلى الله كثيرة جدًا في الكتاب المقدس، في صلوات الآباء والأنبياء والرسل القديسين.
وهناك أشخاص يصلّون بصوت مرتفع منغم.
"بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ، مُتَرَنِّمِينَ وَمُرَتِّلِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ" (أف 5: 19) (كو3: 16). وأيضًا مثلما نصلي في القداس الإلهي. بصوت ولحن، وكذلك صلاتنا في التسبحة.. وداود نفسه كان يصلي بلحن، بآلات موسيقية، بالدف والمزمار والقيثار والعشرة الأوتار، وأحيانًا بفرقة موسيقية معه.. والرهبان أيضًا يصلون التسبحة بصوت ولحن. وقديمًا كان لكل مزمور لحنه.
صرخ داود إلى الرب، والرب سمع صوت تضرعه. وقال هذا في كثير من مزاميره. قال في المزمور الخامس: "أنصت يا رب لكلماتي، واستمع صراخي. اصغ إلى صوت طلبتي". وقال في المزمور السادس: "اُبْعُدُوا عَنِّي يَا جَمِيعَ فَاعِلِي الإِثْمِ، لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ سَمِعَ صَوْتَ بُكَائِي سَمِعَ الرَّبُّ تَضَرُّعِي. الرَّبُّ يَقْبَلُ صَلاَتِي" (مز6: 8-9). وقال في المزمور الثالث: "بصوتي إلى الرب صرخت، فاستجاب لي من جبل قدسه". يقول إن الرب سمع له واستجاب. وماذا أيضًا؟
لأنه أَمَالَ أُذْنَهُ واستمعني
الله أمال أذنه واستمعني. في العادة إن الشخص يميل أذنه ليستمع، إن كان الصوت منخفضًا أو خفيفًا، أو يكاد لا يسمع. كصوت مريض مثلًا أو إنسان ضعيف أو متعب أو متأثر. فالذي يتكلم معه يميل أذنه ليسمعه. أو إن الصوت من بعيد، لا يكاد يصل واضحًا.. أو ليس لصاحبه القدرة أن يرفع صوته.
وهكذا كان داود في ضعفه، لأن أوجاع الموت اكتنفته. صوت يكاد يكون همسًا لا يُسمع، والله يميل أذنه ليسمعه. وكأنه يقول: "نعم، إن الله ينصت إلى كل همسة مني وأنا أدعوه. فيسمعني وهو يميل أذنه إليَّ". وهذا بلا شك لون من الحب والاهتمام. لذلك أنا أيضًا بادلته حبًا. وأحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي.
بنفس الأسلوب تقريبًا، صلى سليمان يوم تدشين الهيكل. فقال: "فَالْتَفِتْ إِلَى صَلاَةِ عَبْدِكَ وَإِلَى تَضَرُّعِهِ أَيُّهَا الرَّبُّ إِلهِي، وَاسْمَعِ الصُّرَاخَ وَالصَّلاَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا عَبْدُكَ أَمَامَكَ الْيَوْمَ. لِتَكُونَ عَيْنَاكَ مَفْتُوحَتَيْنِ عَلَى هذَا الْبَيْتِ لَيْلًا وَنَهَارًا. لِتَسْمَعَ الصَّلاَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا عَبْدُكَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ. وَاسْمَعْ تَضَرُّعَ عَبْدِكَ وَشَعْبِكَ" (1مل8: 28-30).
كم مرة يا أخي أمال الرب أذنه إليك، وسمعك واستجاب. ونسيت أن الرب قد قبل صلاتك!! فضاعت منك هذه الخبرة الروحية بنسيانك. ولم تبادل الرب حبًا بحب، ولم تستفد روحيًا من استجابته. بل نسيت الصلاة أيضًا. ولم تدعُه كل أيامك. وهكذا فَترت حياتك وروحياتك، أما داود المحب لإلهه، فلما أمال الله أذنه إليه واستمعه، يقول:
فأدعوه كل أيامي
أي أنني بهذا الحب الذي أحببته به لما سمع صوت تضرعي، كونت علاقة مستمرة معه، فأصبحت أدعوه كل أيامي، ليس لمجرد الطلب، بل بشعور الحب أدعوه.
مشكلتنا في حياتنا الروحية أننا نركز على الطلب. كلما نحتاج ونطلب، نصرخ إلى الله، ونطلب إليه أن يميل أذنه ليستمعنا. فإذا سمع واستجاب، تنتهي العلاقة بيننا وبينه، وننتظر حتى يربطنا به طلب جديد. دون أن نهتم حتى بالشكر على استجابته. ودون أن نكوّن معه علاقة حب تربطنا به باستمرار، سواء كان لنا ما نطلبه أو لم يكن. أما داود النبي فكوّن علاقة حب، أصبح بها يطلب من الله نفسه، فيقول: "طلبت وجهك، ولوجهك يا رب ألتمس. لا تحجب وجهك عني" (مز27: 8، 9). أنا أطلبك أنت نفسك.
ليس مجرد احتياجي منك، بل احتياجي لك..
أما نحن فللأسف نكون متعلقين بطلباتنا، وليس بالله. سواء تحققت أم لم تتحقق، فإن تحققت نفرح بها، وننسى الله معطيها، وإن لم تتحقق نظل نغضب ونعاتب. ونقول: "لماذا تبطئ. لماذا لم تستجب؟ ليتنا نذكر جميل الله علينا، ونشكره على كل استجاباته القديمة واحدة فواحدة ولا ننساها. كما قال داود نفسه في مزمور آخر: "بَارِكِي يَا نَفْسِي الرَّبَّ، وَلاَ تَنْسَيْ كُلَّ حَسَنَاتِهِ" (مز103: 2).
إذًا أنت تربط تضرعك إلى الله بالحب وبالشكر، وتدعوه كل أيامك. ولما وصل داود إلى هذه النقطة بدأ يتذكر كل إحسانات الله إليه، وكل الضيقات التي أنقذه منها الله، فقال: "لأن أوجاع الموت اكتنفتني، وشدائد الجحيم أصابتني". "ضيقًا وحزنًا وجدت، وباسم الرب دعوت: يا رب نج نفسي".
بالنسبة إلى داود: أوجاع الموت اكتنفته، حينما كان مطاردًا من شاول الملك الذي كان يريد قتله، وأيضًا ابنه أبشالوم الذي قاد جيشًا ضده وأراد قتله، وشدائد الجحيم أصابته في خطيته الكبرى التي ارتكبها ضد بثشبع وزوجها أوريا الحثي (2صم12،11 ). والجحيم هو مصير الخاطئ، لأن أجرة الخطية هي موت (رو 6: 23). وحياته شابها الضيق والحزن في كل ذلك.
وحينما كانوا يصلون هذا المزمور في عيد الفصح، كانوا يتذكرون كيف أن الموت كان يكتنفهم أمام البحر الأحمر، وفرعون يطاردهم. ودعوا باسم الرب: "يا رب نج نفسي". والرب كان يقاتل عنهم وهم يصمتون (خر14:14). أما أنت، فما هو شعورك، وأنت تقول هذه العبارة "أوجاع الموت اكتنفتني، وشدائد الجحيم أصابتني"؟
اذكر حينئذ خطاياك التي من نتائجها الموت والجحيم.
هذه الخطية التي تكتنفني من كل جانب، وبكل قوة. وبسببها ضيقًا وحزنًا وجدتُ، هذه أصرخ إليك يا رب بسببها، وأقول: يا رب نج نفسي. لأني إن سقطت فيها، أكون ميتًا من الناحية الروحية كالابن الضال(لو24:15&32)، ومثل راعي كنيسة ساردس، الذي قال الرب عنه إن له اسمًا أنه حي وهو ميت (رؤ3: 1). إذًا طالما أنا في الخطية، أقول: "أوجاع الموت اكتنفتني، وشدائد الجحيم أصابتني". ويمكن أن نقول هذه العبارة في كل الشدائد التي تصيبنا.
الضيق هو تعب من الخارج. والحزن تعب من الداخل.
ضيقًا وحزنًا وجدت. أي أنني قاسيت التعب من الخارج ومن الداخل. فكانت النتيجة أنني لجأت إلى الله، ودعوته: يا رب نجِ نفسي.
يحدث أحيانًا لأولاد الله في وقت من الأوقات، أن يجد الشخص نفسه، وقد ضاقت الدنيا في وجهه، ولاحقه التعب من كل ناحية، حتى إنه يقول في المزمور141 (142): "أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخًا. تأملت عن اليمين وأبصرت، فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني، وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت: أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. أنصت إلى طلبتي فإني تذللت جدًا. نجني من الذين يضطهدونني فإنهم قد اعتزوا أكثر مني".
أنا يا رب دعوتك، لما ضاقت الدنيا بي.
لما "ضيقًا وحزنًا وجدت"، ولم أجد حلًا لمشاكلي. لما فشلت المعونة البشرية وضاع المهرب، وليس من يسأل عن نفسي. لما سألت الرعاة والمرشدين، وبقيت كما أنا في خطاياي. لما جرّب الأطباء كل علاجهم معي، وما زلت في مرضي. لما تذللت جدًا، والذين يضطهدونني اعتزوا أكثر مني.. فلم أجد أمامي إلا أن أدعو الرب وأقول:
يا رب نج نفسي
"يا رب نجِ نفسي". صلاة من أصغر الصلوات، ولكن من أكثرها عمقًا. نحن لا يلزمنا في كل حروبنا الروحية والمادية إلا هذه الصلاة القصيرة "يا رب نجِ نفسي". نجِ هذه النفس التي اشتريتها بدمك الكريم وافتديتها (1كو6: 20). ودخلت في عهد معها فصارت لك (حز16: 8). "يا رب نج نفسي" صلاة قصيرة وقوية، كالسهم: توصل إلى الهدف بسرعة، وهي في نفس الوقت صلاة محددة ومتضعة. صلاة إنسان يشعر أنه عاجز عن تخليص نفسه، فيلجأ إلى الله مؤمنًا أنه قادر أن يخلص إلى التمام (عب25:7).
صلاة قصيرة ولكنها قوية في مفعولها: مثل صلاة اللص اليمين "اذْكُرْنِي يا رب مَتَى جِئْتَ فِي مَلَكُوتِكَ" (لو23: 42). ومثل صلاة العشار: "اللّهُمَّ ارْحَمْنِي، أَنَا الْخَاطِئَ" (لو18: 13). ومثل كلمة كيرياليسون (يا رب ارحم).
صلاة تذكرنا بطفل يتشبث بأبيه، وسط ميدان مزدحم بطرق المواصلات، صلاة مثل صرخة غريق ينادي قارب نجاة.. ليتك تحفظ هذه الصلاة، وتستخدمها باستمرار.
كلما تحيط بك الضيقات، وكلما يتآمر عليك الأعداء، تقول: "يا رب نجِ نفسي". كلما تضغط عليك الخطية وتحاربك الأفكار والشهوة، تلجأ إلى الله وتقول: "يا رب نجِ نفسي". كلما تفشل كل المعونات البشرية وكل جهادك الشخصي، تقول: "يا رب نجِ نفسي". أطلب النجاة لنفسك من كل ناحية؛ ليس فقط فى المشاكل الاجتماعية والمالية وما أشبه. وإنما أيضًا في كل حياتك الروحية، لكي ينجيك الرب من الخطية ومن نتائجها، ومن الفتور الروحي ومن كل فخاخ العدو المرئية وغير المرئية.
يا رب نجِ نفسي
إن أتاك الضياع من الخارج، قل: "يا رب نجِ نفسي". وإن أتاك الضياع من الداخل، قل: "يا رب نجِ نفسي، من نفسي"؛ نجني من شهوات ورغبات نفسي. نجني من أسلوبي في التفكير والتدبير، نجني من حواسي ومشاعري، نجني من ضعفي، وعدم مقاومتي، وقلة حيلتي. نجني من الشيطان والعالم والمادة. وهنا يشعر المصلي باستجابة صلاته فيقول: "الرب رحيم وصديق، وإلهنا يرحم".
حقًا إن الله يرحم. هذه قاعدة عامة. ولكننا قد نقف ضد رحمته واستجابته، بأفعالنا الخاطئة. هوذا الكتاب يقول: "مَنْ يَسُدُّ أُذُنَيْهِ عَنْ صُرَاخِ الْمِسْكِينِ، فَهُو أَيْضًا يَصْرُخُ وَلاَ يُسْتَجَابُ" (أم21: 13). إذًا سلّف الرحمة، أقرضها، فيردها الله لك. لأن الكتاب يقول: "مَنْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ يُقْرِضُ الرَّبَّ، وَعَنْ مَعْرُوفِهِ يُجَازِيهِ" (أم 19: 17). ويقول الرب في العظة على الجبل: "طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ" (مت5: 7). إذًا إن قلت في صلاتك "الله يرحم"، وإن قلت "يا رب ارحم".
اِرحم غيرك لكي يرحمك الله.
أتريد أن ينجيك الرب، وتصرخ قائلًا: "يا رب نجِ نفسي". إذًا أبذل كل جهدك في أن تنجي غيرك، كما يقول القديس يعقوب: "مَنْ رَدَّ خَاطِئًا عَنْ ضَلاَلِ طَرِيقِهِ، يُخَلِّصُ نَفْسًا مِنَ الْمَوْتِ، وَيَسْتُرُ كَثْرَةً مِنَ الْخَطَايَا" (يع5: 20).
أما إن كنت تُعثر غيرك وتُسقطه. أو يُعهد إليك بخدمة وتهمل في خلاص الأنفس. أو أن تسحق غيرك تحت أقدامك، وتذله وتتعبه وتحطمه. ما أسهل أن يقف أمامك قول الرب: "بِنَفْسِ الْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ" (لو6: 38).
بل في إنجيل معلمنا مرقس: "بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ" (مر4: 24). إذًا ليت مكيالك الذي تكيل به للآخرين، يكون مكيال الرحمة والشفقة والمغفرة، حتى إن طلبت رحمة الله، تكون لك دالة أن تأخذها، وتزاد لك أيضًا.
احترس إذًا في معاملتك لغيرك. وتذكر مثل المديون الذي سامحه سيده في عشرة آلاف وزنة، وبعد ذلك لم يسامح رفيقه في مائة دينار! وكيف أن سيده قال له: "أَيُّهَا الْعَبْدُ الشِّرِّيرُ، كُلُّ ذلِكَ الدَّيْنِ تَرَكْتُهُ لَكَ لأَنَّكَ طَلَبْتَ إِلَيَّ أَفَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّكَ أَنْتَ أَيْضًا تَرْحَمُ الْعَبْدَ رَفِيقَكَ كَمَا رَحِمْتُكَ أَنَا وَغَضِبَ سَيِّدُهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى الْمُعَذِّبِينَ حَتَّى يُوفِيَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ" (مت18: 24-34). وقال الرب بعد هذا المثل: "هكَذَا أَبِي السَّمَاوِيُّ يَفْعَلُ بِكُمْ إِنْ لَمْ تَتْرُكُوا مِنْ قُلُوبِكُمْ كُلُّ وَاحِدٍ لأَخِيهِ زَّلاَتِهِ" (مت18: 35). على أن الرب أحيانًا يرحمكم وأنتم لا تستحقون.
يرحمكم لا لأنكم رحمتم غيركم، وإنما لكي تتعلموا الرحمة.
لكي ترحموا غيركم في المستقبل، كما رحمكم الله عن غير استحقاق منكم. إنه يذيب قلبكم برحمته، لكي يعطيكم مثالًا عمليًا. حتى كما فعل بكم، تفعلون ببعضكم البعض (يو13: 15). كما أعطانا مثالًا آخر بمعاملة يوسف الصديق لإخوته، الذين لم يرحموه حينما ألقوه في البئر ثم باعوه كعبد (تك37). ولكنه اعتنى بهم وعالهم في أرض مصر (تك50: 15-21). بعد أن يتذكر المصلي رحمة الله، نراه يقول:
الذي يحفظ الأطفال هو الرب
كلمة (الأطفال) في الكتاب المقدس تشير إلى معنيين: إما المعنى الحرفي، أي الأطفال حسب السن. أو تعني المتضعين، الذين هم كالأطفال بحسب قلوبهم. وهنا قد تعني المعنيين معًا، وكيف ذلك؟
أي إن الله صديقًا ويرحم، فبالدرجة الأولى يرحم الأطفال الذين لا يستطيعون أن يخلصوا أنفسهم، فيلجأون إلى الله ليخلصهم.. الكبار قد يعتمدون على قوتهم أو فكرهم أو ذكائهم أو خبرتهم، أما الأطفال فليس لهم سوى الله. فاحسبني يا رب ضمن هؤلاء الأطفال. لست أدعي أنني كبير أستطيع تدبير أموري. لذلك قال بعدها:
اتضعت فخلصني
"الذي يحفظ الأطفال هو الرب". الطفل يصرخ ويبكي طالبًا الإنقاذ. أما الكبير فقد يخجل من أن يصرخ ويبكي. الطفل له ثقة وإيمان فيمن يتقدم ليخلصه. أما الكبير فقد يطلب، وربما يشك في استجابة طلبته، وليس له إيمان الطفل، الذي يثق بأن كل شيء مستطاع (مر9: 23).
عبارة "الذي يحفظ الأطفال هو الرب"، تذكرني بعبارة قالها الرب وهي: "هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ كَغَنَمٍ فِي وَسْطِ ذِئَابٍ" (مت10: 16). ماذا تستطيع الغنم أن تفعل وهي وسط الذئاب؟! لا شيء سوى أن تطلب معونة الراعي ليخلصها. إنها لا تهاجم الذئاب ولا تصارعها، إنما تلجأ إلى الراعي لكي يحفظها وسط الذئاب، إذ تشعر يقينًا بضعفها أمام الخطر الخارجي المحيط بها. كذلك الإنسان الروحي يشعر أن حروبه الروحية كالغنم وسط الذئاب.. إن ذئبًا واحدًا قد يزعج كل الغنم، فكم بالأولى ذئاب كثيرة؟! وإن كانت الذئاب في الخارج، قد تكون للغنم فرصة للهرب أو للتشتت. ولكن كم يكون الخطر مرعبًا إن الغنم وسط الذئاب، تحيطها الذئاب من كل ناحية؟! ليس لها إلا أن تصرخ إلى الراعي: "يا رب نجِ نفسي". كطفل يصرخ إلى الله الذي يحفظ الأطفال. وإذ يتخذ نفسية الطفل يقول: "اتضعت فخلصني".. هنا لا يقول اتضعت لكي يخلصني.
إنما يحكي خبرته مع الله الذي خلّصه، ويقول: "اتضعت فخلصني".
يقول أحد الآباء: كيف خلّص الله الغنم من الذئاب؟ ذلك بأن حوّل الذئاب إلى خراف. وهذا هو الذي حدث في عصر الاستشهاد الأول، في العصر الرسولي وباقي القرون الأربعة الأولى. في تحول شاول الطرسوسي إلى بولس الرسول (أع9). وفي إيمان كثير من كهنة اليهود وصيرورتهم أعضاء في الكنيسة (أع6: 7). في قبول الدولة الرومانية للإيمان، وتحوّل أباطرتها وقادتها من ذئاب إلى خراف.
وهكذا قال أحد الروحيين: إننا في العالم الآن نرى الغنم أكثر من الذئاب. فبينما الذئاب تنقرض أو يقل عددها، نرى الغنم تكثر وتتزايد على الرغم من ضعفها وعدم قدرتها على تخليص أنفسها. إنها اتضعت أمام الله فخلّصها.. ففي بساطتها ووداعتها وشعورها بضعفها، تعيش في حماية الراعي، وتغني كل حين قائلة: "الذي يحفظ الأطفال هو الرب".
ما أكثر الأمثلة في الكتاب المقدس عن حفظ الله للأطفال
موسى الطفل، الذي حفظه الله وهو ملقى في سفط (سبت) من البردي بين الحلفاء على حافة النهر (خر2: 3). ويوسف الذي حفظه الله من قسوة إخوته الكبار الذين احتالوا له لكي يميتوه (تك37: 18). وصموئيل الطفل الذي حفظه الله في نقاوته وطهارته، وهو في وسط بيئة رديئة لا أخلاقية، من أبناء عالي الكاهن (1صم2: 12-22). وهو الذي حفظ دانيال والثلاثة فتية في أرض السبي (دا 3: 6).
على أن عبارة "الله يحفظ الأطفال" لا تعني الأطفال الصغار فحسب؛ إنما يحفظ الله أيضًا كل من يسلك في وداعة الطفل وبساطته. هؤلاء البسطاء يحفظهم الرب، لأنهم يلجأون إليه ويؤمنون بمعونته. أما الجبابرة في قوتهم وفي عقولهم قد لا يلجأون إليه معتمدين على قوتهم. بينما البسطاء يصرخون قائلين: "الذي يحفظ الأطفال هو الرب".
هكذا كان القديس أنطونيوس وسط محاربات الشياطين، يقول لهم: "أيها الأقوياء، ماذا تريدون مني أنا الضعيف؟! أنا أضعف من أن أقاتل أصغركم". ومن حماية الله له، كانت خبرته هي هذه العبارة "اتضعت فخلصني".
يا أخي اعتمد على الله أكثر مما تعتمد على ذكائك.
اعتمد عليه كما يعتمد طفل صغير على أبيه في وسط الأخطار.
نعم، اعتمد على الله أكثر مما تعتمد على شخصيتك وقوتك. فإن الذين يعتمدون على ذواتهم، هم أقل الناس صلاة. ومثلهم أيضًا الأغنياء الذين يعتمدون على مالهم، بعكس الفقراء الذين في كل احتياجاتهم يعتمدون على الله.
الذي يحفظ الأطفال هو الرب. وكذلك يحفظ الأقوياء والشيوخ الذين يلجأون إليه. ولكنه بالأكثر يحفظ الأطفال، فلماذا؟
لأنه مُعين من ليس له مُعين، ورجاء من ليس له رجاء.
معين من ليس له معين من الناس، ولا من ذاته أيضًا. من ليس له اعتماد على ذراع بشري. ومن يقول: "الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء" (مز118: 8، 9). حقًا، إنك تشعر بيد الله في حياتك، حينما تقف أمامه ضعيفًا بعيدًا عن كل معونة بشرية، فيتدخل الله ليخلصك.
إن جدعون حينما أعد للحرب اثنين وثلاثين ألفًا لمحاربة جيش المديانيين، قال له الرب: "الشَّعْبَ الَّذِي مَعَكَ كَثِيرٌ عَلَيَّ لأَدْفَعَ الْمِدْيَانِيِّينَ بِيَدِهِمْ، لِئَلاَّ يَفْتَخِرَ عَلَيَّ إِسْرَائِيلُ قَائِلًا: يَدِي خَلَّصَتْنِي" (قض7: 2). وأدخله الله في تدريبات لإنقاص العدد حتى وصل إلى ثلاثمائة محارب فقط. وبهذا العدد فقط خلّصهم، وهم غير معتمدين على قوتهم.
نفس الوضع نجده في وقوف داود أمام جليات الجبار، الذي كان رمحه مثل نول النساجين.. خلع داود الحلة العسكرية التي أعطاها له شاول الملك. وقال لجليات: "أَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ بِسَيْفٍ وَبِرُمْحٍ وَبِتُرْسٍ، وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ بِاسْمِ رَبِّ الْجُنُودِ. الْيَوْمَ يَحْبِسُكَ الرَّبُّ فِي يَدِي" (1صم 17: 45، 46). وهكذا انتصر داود لا بقوة سلاحه، وإنما باسم رب الجنود. وهكذا استطاع أن يسجل خبرته في مزاميره فيقول: "قُوَّتِي وَتَرَنُّمِي الرَّبُّ، وَقَدْ صَارَ لِي خَلاَصًا" (مز118: 14).
وهكذا في العهد الجديد أيضًا يقول القديس بولس الرسول عن نجاح الكرازة: "لَنَا هذَا الْكَنْزُ فِي أَوَانٍ خَزَفِيَّةٍ، (أى فى أوانٍ ضعيفة سهلة الكسر)، لِيَكُونَ فَضْلُ الْقُوَّةِ ِللهِ لاَ مِنَّا" (2كو4: 7). قد تقول لقد صليت كثيرًا، ولم يخلصني الله!! ربما السبب في ذلك أنك لا تزال معتمدًا على الذراع البشري، ربما تكون مغرورًا بعض الشيء بقوتك. أو أن إيمانك ضعيف، أو لم تتضع بعد أمامه. أو توجد خطية تعوّق استجابة طلبتك.
لذلك تقف ذاتك عقبة في وصول المعونة الإلهية إليك.
كالذي تتعبه خطية، فيقف أمام الله، لا ليطلب نعمة تساعده على التخلص منها. وإنما يقف ليقول لله: "إنني لن أعمل هذه الخطية في المستقبل. أتعهد أمامك إني لن أرتكبها مرة أخرى. ويُكثر التعهدات، ثم يسقط لأنه اعتمد على ذاته وتعهداته، دون أن يقول كما في المزمور "يا رب نجِ نفسي".. ودون أن يقول كما قال القديس أنطونيوس الكبير: "نجني يا رب من هؤلاء الذين يظنون إنني شيء! أنا عاجز عن مقاتلة أصغرهم".
وقع في هذه السقطة القديس بطرس الرسول، الذي اعتمد على ذاته، ووقف أمام الله مفتخرًا يقول بأكثر تشديد: "وَلَوِ اضْطُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أُنْكِرُكَ" "وَإِنْ شَكَّ الْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ" (مر14: 31،29). "إِنِّي مُسْتَعِدٌّ أَنْ أَمْضِيَ مَعَكَ حَتَّى إِلَى السِّجْنِ وَإِلَى الْمَوْتِ" (لو22: 33). ولم يقل: أعطني يا رب القوة التي أستطيع بها أن أثبت وأقاوم ولا أنكرك.. فسقط بطرس وأنكر المسيح أمام جارية (مت26: 69–74). إذ كان معتمدًا على ذاته، واثقًا بنفسه أكثر مما يجب. ولم يختبر عبارة "اتضعت فخلصني".
إن أردت أن تنجح في حروبك الروحية، ضع أمامك هذا المبدأ "اتضعت فخلصني". قل له: أنا يا رب لست أدعي القوة، ولست أعد بالنصرة على الخطية. ولا أستطيع أن أقدم تعهدات بالسلوك في حياة البر. فقد ثبت ضعفي قدامك في محاربة الخطايا، التي أنا عاجز عن مقاتلة أصغرها. وليس لي ذكاء ولا حيلة في التعامل مع مؤامرات الناس الأشرار. إنما أنا ألجأ إليك كطفل يتغنى بعبارة "حافظ الأطفال هو الرب".
ألجأ إليك يا من تخافك الشياطين.
هذه التي كانت تصرخ أمامك وتقول: "مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللهِ؟ أَجِئْتَ إِلَى هُنَا قَبْلَ الْوَقْتِ لِتُعَذِّبَنَا؟" (مت8: 29). أنت الذي أخرجت الشياطين لَجِئُونُ من المجنون (مر5: 7-9). أنت الوحيد القوي القادر، أصرخ إليك قائلًا: يا رب نجِ نفسي. أنا جرّبت نفسي فتحقق لي ضعفي أمام هذه الخطايا التي "طَرَحَتْ كَثِيرِينَ جَرْحَى، وَكُلُّ قَتْلاَهَا أَقْوِيَاءُ" (أم7: 26). أنا أمام أعدائي ضعيف، ألجأ إليك أيها القوي.
هؤلاء الشياطين لا ينهزمون إلا بالاتضاع.
كما قال القديس الأنبا أنطونيوس: "أبصرت فخاخ الشياطين مبسوطة على كل الأرض. فقلت يا رب من يفلت منها؟! فأتاني الصوت "المتواضعون يفلتون منها". وأكد هذا قول الشياطين للقديس مكاريوس الكبير: لكن بشيء واحد تغلبنا.. بتواضعك. وهكذا اعترف داود أيضًا في المزمور قائلًا: "اتضعت فخلصني". ولما وصل إلى هذا الاتضاع والخلاص، قال بعد ذلك:
ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك
تقال هذه العبارة بمعنيين: أحدهما عن الموت الذي يوصل إلى الراحة الأبدية. أما عن المعنى الروحي الذي يتابع به المصلي كلامه السابق في المزمور بعد عبارة "اتضعت فخلصني"، يقول لنفسه: ارجعي إلى راحتك في الرب. فإنك كلما تبعدين عنه تتعبين. لقد أتعبتك الخطية كثيرًا، أتعبتك الشهوات والسقطات. أتعبتك محبة العالم وكل ما فيه، أتعبتك "شَهْوَةَ الْجَسَدِ، وَشَهْوَةَ الْعُيُونِ، وَتَعَظُّمَ الْمَعِيشَةِ"(1يو2: 16). ارجعي إذًا إلى الرب الذي هو مصدر كل راحة، الذي قال: "تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ" (مت11: 28). حق هو قول القديس أغسطينوس في اعترافاته للرب: "سيظل قلبي قلقًا، إلى أن يجد راحته فيك".
لن تجدي يا نفسي راحة في هذا العالم، هذا الذي انهمك سليمان في ملذاته ومتعه، وقال: "وَمَهْمَا اشْتَهَتْهُ عَيْنَايَ لَمْ أُمْسِكْهُ عَنْهُمَا" (جا2: 10). وأخيرًا وجد أن الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس (جا2: 11). ارجعي يا نفسي إذًا إلى موضع راحتك، إلى سلامك القلبي، سلامك مع الله. ارجعي إلى الرب الذي قال: "ارْجِعُوا إِلَي.. فَأَرْجِعَ إِلَيْكُمْ" (زك1: 3). نعم سأرجع اعترافًا بجميل الرب الذي أوصلني إليه. لأنه أنقذ نفسي من الموت، وعيني من الدموع. أنقذني من الموت. "لأَنَّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ" (رو6: 23). والإنسان الخاطئ له اسم أنه حي وهو ميت (رؤ3: 1). لطالما صرخت وقلت: "مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟" (رو7: 24). والرب أحسن إليَّ، فأنقذني من شهوات هذا الجسد.
وأنقذ عيني من الدموع، ورجليَّ من الزلل. هو الذي أنقذني، ولولاه لضعت. أنقذني من الزلل، ولولاه لزللت، وغرقت في دموع الندم واليأس. ارجعي يا نفسي إذًا إلى راحتك في الرب. لأنه بدون هذا الرجوع ستبقين في الدموع وفي الزلل. أما وقد أنقذني الرب من كل هذا، فإنني...
أرضي الرب أمامه في كورة الأحياء.
في كورة الأحياء، الذين ليسوا "أَمْوَاتًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا" (أف2: 1). هناك أرضي الرب. لأن خارج كورة الأحياء يوجد المطروحون في الظلمة الخارجية (مت8: 12). مبارك إذًا هو الرب الذي أوصلني إلى كورة الأحياء، هلليلويا.
عبارة "ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك"، نقولها أيضًا نيابة عن النفس حين مغادرتها للعالم. لأن الرب قد أحسن إليها وأنقذها من العالم وما فيه من موت الخطية ومن الدموع والزلل، وأوصلها إلى كورة الأحياء، حيث تتهلل هناك.
[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 15 مارس 1996م، 29 مارس 1996م
الفصل التاسع الرب يحفظك الرب يحفظ خروجك ودخولك
الرب يحفظك الرب يحفظ خروجك ودخولك[1]
[مز 120] (121)
أريد أن أتأمل معكم في بعض آيات من المزمور 121 الذي أوله "رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني". ولأني تكلمت عن هذا المزمور من قبل، لذلك سأتناول فقط الآيتين الأخيرتين من هذا المزمور اللتين يقول فيهما: "الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك، من الآن وإلى الأبد".
هذا المزمور يسمونه مزمور الحفظ: لأنه وردت فيه كلمة (الرب يحفظك) عدة مرات. وهو أيضًا من (مزامير المصاعد) التي يصلون بها وهم يصعدون الجبل إلى الهيكل.
ويمكن أن يقال هذا المزمور في مناسبات معينة. في وداع أي شخص - في دعاء بركة لأي إنسان – أم وابنها خارج من البيت، فتقول له: "الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك".. أو تقال هذه الكلمات لإنسان مسافر. وطبيعي – وهو خارج من منزله – لا يعرف ماذا سيصادفه في طريقه. ومن الجائز أن تحدث أمور غير متوقعة. فيجد عونًا روحيًا في كلام هذا المزمور أن الرب سيحفظه من كل سوء، ويحفظ خروجه ودخوله.
المزمور يعني أن الله هو الحافظ وهو المعين.
ومن الجائز أنها لا تكون كلمات موجهة كدعاء من البشر، ومن بعض الأحباء. إنما قد تكون تشجيعات من الملائكة، تقول لمن يصلي هذا المزمور: " الرَّبُّ يَحْفَظُكَ مِنْ كُلِّ سُوء. الرَّبُّ يَحْفَظُ خُرُوجَكَ وَدُخُولَكَ"؛ أي أنه معك فلا تخف".
يذكرني هذا المزمور بأول مزامير الساعة الثالثة "يستجب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب" (مز20: 1). هو أيضًا مزمور دعاء وبركة، كانوا يقولونه قديمًا للملك وهو خارج إلى الحرب. لكن يمكن أن يقال لأي أحد في أي وقت.
الربّ يَحفظك مِن كل سوء
يحفظك من كل الأشرار، من المؤامرات التي تُحاك ضدك، ويحفظك من الشياطين ومن ضلالات الشياطين، ومن أعوان الشياطين، ومن أية تهم تلفق ضدك.
الرب يحفظك في الغربة، الرب يحفظك من المرض، من العدوى، ومن الألم. الرب يحفظك من حوادث الطريق، وأية حوادث من نوع آخر.
الرب يحفظك من المشاكل، ومن العلاقات الخاطئة. الرب يحفظك من الشكوك، ومن السقوط ومن الارتداد، ومن الهلاك. وإن سرت حسنًا، يحفظك الرب من الكبرياء والخيلاء، ومن الافتخار والمجد الباطل، ومن الخطية عمومًا.
الربّ يَحفظ نفسَك
النفس غير الجسد، والنفس أهم من الجسد. ولذلك يقول المزمور: الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، أي يحفظ عقلك ويحفظ روحك، ويحفظ حياتك وإيمانك.
لقد سمح الله للشيطان أن يضرب أيوب في جسده، من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، ومع ذلك قال له: "وَلكِنِ احْفَظْ نَفْسَهُ" (أي2: 6). أي لا تضره في شيء من جهة نفسه، فكان أيوب مريضًا بمرض متعب ومؤلم. ولكن نفسه محفوظة في يد الله، إلى أن أتى الموعد الذي انتهت فيه التجربة.
بولس الرسول أيضًا؛ سمح الله أن يضربه الشيطان بشوكة في الجسد، ولكن مع ذلك بقيت نعمة الله معه. وقال له الرب: "تَكْفِيكَ نِعْمَتِي" (2كو12: 9). وحفظ الله نفسه؛ الجسد كان يؤلمه المرض، ولكن نفسه كانت محفوظة، بل أكثر من هذا قيل عنه إنه "كَانَ يُؤْتَى عَنْ جَسَدِهِ بِمَنَادِيلَ أَوْ مَآزِرَ إِلَى الْمَرْضَى، فَتَزُولُ عَنْهُمُ الأَمْرَاضُ، وَتَخْرُجُ الأَرْوَاحُ الشِّرِّيرَةُ مِنْهُمْ" (أع19: 12). كل ذلك بالرغم من الشوكة في الجسد!
يعقوب أب الآباء؛ بعد أن صارع مع الله وغلب، وغيّر الله اسمه، ومنحه بركة، ضربه على حُقَّ فَخْذِهِ، فصار"يَخْمَعُ عَلَى فَخْذِهِ" (تك32: 31) غالبًا تعب من Sciatic Nerve أي العصب الذي في آخر العمود الفقرى تقريبًا، ويمتد إلى أصابع القدم. ومع ذلك الألم كان مباركًا، وكان ملاك الرب يتبعه في حياته ويخلصه من كل شر (تك 48: 16). وقد نجّاه الرب من عيسو أخيه.
عبارة الرب يحفظ نفسك تنطبق أيضًا على الشهداء والمعترفين؛ أجسادهم تتألم جدًا بأنواع أمراض وآلام كثيرة؛ من جَلد، وسحل، وتقطيع أعضاء. ولكن نفوسهم كانت قوية جدًا. وفي كل آلامهم ومراحل استشهادهم، كانت الملائكة تهمس في أذن كل واحد منهم: الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحفظ نفسك.
قديس يقطعون يديه ورجليه، ولكن نفسه تبقى سليمة. القديس صموئيل المعترف فقأوا إحدى عينيه، ولكن نفسه بقيت قوية مع الله. المهم هو النفس وسلامتها.
داود مثلًا؛ أصابته اضطهادات كثيرة من شاول الملك، وعاش مطاردًا من برية إلى برية. ولكن الله حفظ نفسه، وهو قال لشاول الملك: "كَذلِكَ لِتَعْظُمْ نَفْسِي فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ فَيَنْقُذْنِي مِنْ كُلِّ ضِيق" (1صم26: 24). كان الرب يحفظ نفس داود، إلى أن سلّمه المُلك أخيرًا.
آباء البرية مثل القديس أنطونيوس الكبير. كم لاقى هذا القديس من محاربات كثيرة من الشياطين، بضربات وبأصوات مرعبة. ولكن الرب حفظ نفسه، فلم تهتز من الداخل، ولم يصبها أي ارتباك. بل أن القديس أنطونيوس كان قوي النفس جدًا.
وهكذا المتوحدون والسواح، عاشوا في قفر البرية في وسط الوحوش ودبيب الأرض، ولكن أنفسهم كانت قوية.
إن الله قد يسمح بالتجارب، ولكن يحفظ الإنسان منها أو من نتائجها، فهو لا يمنع التجربة. ولكن أثناءها يحفظ الإنسان من كل سوء.
بولس الرسول؛ كم كابد من ضيقات، ولكن الله كان يحفظ نفسه خلالها، وكانت الملائكة تغني له: "الرب يحفظ نفسك". إنه يقول عن نفسه وزملائه: "مُضْطَهَدِينَ، لكِنْ غَيْرَ مَتْرُوكِينَ. مَطْرُوحِينَ، لكِنْ غَيْرَ هَالِكِينَ، حَامِلِينَ فِي الْجَسَدِ كُلَّ حِينٍ إِمَاتَةَ الرَّبِّ يَسُوعَ" (2كو4: 9 ،10). بل يقول أيضًا: "نَحْنُ الأَحْيَاءَ نُسَلَّمُ دَائِمًا لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ يَسُوعَ، لِكَيْ تَظْهَرَ حَيَاةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا الْمَائِتِ" (2كو4: 11). "كَمَائِتِينَ وَهَا نَحْنُ نَحْيَا، كَحَزَانَى وَنَحْنُ دَائِمًا فَرِحُونَ، كَأَنْ لاَ شَيْءَ لَنَا وَنَحْنُ نَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ" (2كو6: 9، 10).
أبطال الإيمان؛ مثل القديس أثناسيوس، الذي نُفيّ عن كرسيه أربع مرات، وتغرّب واتُّهم بتهم عديدة. ومع ذلك كانت نفسه قوية في يد الله، ولم يصبه أي ضرر. القديس ساويرس الأنطاكي؛ الذي نفي عن كرسيه في أنطاكية. وجاء وعاش عندنا في الإسكندرية، الرب حفظ نفسه وبقي بطلًا للإيمان.
الرب يحفظ خروجك ودخولك
إنها عبارة يمكن أن تدخل في حياتنا اليومية باستمرار؛ وأنت خارج من بيتك، الرب يحفظ خروجك، ثم عندما ترجع إلى بيتك، الرب يحفظ دخولك. إنه شيء جميل أنك وأنت خارج من بيتك إلى العمل، تغني الملائكة في أذنيك: "الرب يحفظ خروجك ودخولك". تدخل إلى مكان عملك فيقولون لك: "الرب يحفظ دخولك وخروجك. وهكذا في كل مكان تدخله وتخرج منه".
هكذا من جهة الموضوعات؛ تدخل في موضوع معين، تتحدث فيه، يقول لك المزمور: "الرب يحفظ دخولك وخروجك"، أي تخرج من الحديث أو الحوار بنتيجة طيبة.
تكون في ندوة في مناقشة، في حوار. تسمع نفس العبارة. تكون ذاهبًا إلى لقاء هام أو اختبار Interview مثلًا، لكي يختبروك فيه هل تصلح أم لا؟ تسمع نفس العبارة: "الرب يحفظ دخولك وخروجك، يحفظ دخولك بغير خوف أو اضطراب"، ويحفظ خروجك بسلام وقلبك مطمئن.
تكون داخلًا إلى المستشفى؛ فيزورك بعض الأحباء ويقولون لك: الرب يحفظ دخولك وخروجك، الرب يحفظ دخولك أثناء الكشف والفحوص الطبية، ويحفظ خروجك منها جميعها. أثناء عملية جراحية تُعمل لك، وتدخل حجرة العمليات، يقولون لك: الرب يحفظ دخولك في حجرة العمليات، ويحفظ خروجك منها.
تكون ذاهبًا إلى محاكمة في إحدى القضايا، وتتبعك أيضًا عبارة المزمور: "الرب يحفظ دخولك إلى المحكمة، ويحفظ خروجك منها".
إن هذا كله يذكرني بكلام البركة الذي ورد في سفر التثنية لمن يسمع كلام الرب ويحفظ وصاياه: "وَتَأْتِي عَلَيْكَ جَمِيعُ هذِهِ الْبَرَكَاتِ وَتُدْرِكُكَ، إِذَا سَمِعْتَ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ، مُبَارَكًا تَكُونُ فِي الْمَدِينَةِ، وَمُبَارَكًا تَكُونُ فِي الْحَقْلِ.. مُبَارَكًا تَكُونُ فِي دُخُولِكَ، وَمُبَارَكًا تَكُونُ فِي خُرُوجِكَ" (تث28: 2-6).
الرب يحفظك في خروجك ودخولك، حتى في الموت والحياة: الروح تخرج من جسد الإنسان، وتدخل إلى مكان الانتظار. ومعها عبارة "الرب يحفظ خروجك ودخولك". خروجك من الجسد، ودخولك إلى الفردوس، وفي يوم القيامة تسمع نفس العبارة: "الرب يحفظ خروجك من الفردوس، ودخولك إلى الجسد مرة أخرى". إنها عبارة تقال للروح عند الخروج من هذه الحياة الأرضية، والدخول إلى الحياة الأبدية.
لعل نفس هذه العبارة قيلت ليونان النبي في دخوله إلى جوف الحوت، وفي خروجه منه. حفظ الرب دخوله، فلم يؤذه الحوت بل حفظ حياته. كذلك حفظ الله خروجه سالمًا لكي يؤدي رسالته.
نفس العبارة أيضًا تنطبق على الثلاثة فتية في أتون النار؛ الرب يحفظ دخولكم وخروجكم. لقد حفظ الرب دخولهم فلم تؤذهم نار الأتون. لا أحرقتهم ولا أحرقت ثيابهم. وكانوا يتمشون في وسط النار في سلام، إلى أن حفظ خروجهم منها أحياء. وكل منهم يسمع قول المزمور: "الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك".
نفس الوضع حدث مع دانيال النبي حينما ألقوه في جب الأسود؛ الرب حفظ دخوله، فلم تهجم عليه الأسود وتلتهمه، بل أنه تغنى بعبارة: "إِلهِي أَرْسَلَ مَلاَكَهُ وَسَدَّ أَفْوَاهَ الأُسُودِ" (دا 6: 22). وحفظ الله أيضًا خروجه من الجب سليمًا.
أبونا نوح أب الآباء، وهو داخل إلى الفلك، كان الملائكة يقولون له: "الرب يحفظ دخولك وخروجك". وهكذا دخل وعاش في الفلك وسط (الوحوش)، طول مدة الطوفان الذي غطى الجبال، ثم أتت عبارة "ويحفظ خروجك" حينما أرسل حمامة وعادت إليه وفي فمها ورقة زيتون خضراء (تك8: 11). وبدأ الفلك يهبط حتى رسا على جبل أراراط. وأمر الله نوحًا أن يخرج هو وأسرته. فخرج والرب حفظه في خروجه.
لعازر الدمشقي؛ وهو خارج من عند سيده إبراهيم لكي يختار زوجة لإسحاق، وهو لا يعلم إلى أين يذهب. صاحبته هذه العبارة قبل أن يقولها داود: "الرب يحفظ خروجك ودخولك". وفعلًا حفظ الرب خروجه من بلده، ودخوله – دون أن يقصد – إلى موضع أقارب سيده، ولقائه مع رفقة وموافقتها على الزواج من إسحاق. ولما أرادوا أن يستبقوه ليكرموه، قال لهم: "لاَ تُعَوِّقُونِي وَالرَّبُّ قَدْ أَنْجَحَ طَرِيقِي" (تك24: 56). وكيف أنجح طريقك؟ لقد حفظ دخولي وخروجي.
كذلك حدث مع يعقوب ابن إسحاق قال له الرب: "وَهَا أَنَا مَعَكَ، وَأَحْفَظُكَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ، وَأَرُدُّكَ إِلَى هذِهِ الأَرْضِ" (تك28: 15)، وفعلًا حفظه الرب في خروجه من بيت أبيه، وفي دخوله بيت خاله لابان. ثم خروجه من هناك ودخوله مرة أخرى إلى بيت إيل.
نفس الوضع في قصة عبور الشعب للبحر الأحمر (خر14)
الرب حفظ الشعب في دخولهم إلى البحر، فلم تغرقهم أمواجه، بل كانت مثل سور حولهم من يمين ومن يسار. وأخيرًا حفظ الرب خروجهم من البحر إلى برية سيناء.
عبارة "الرب يحفظ دخولك وخروجك نقولها في مناسبات عديدة: إنسان مسافر بالطائرة، وهو يسمع عن حوادث كثيرة للطائرات. ويكون في رعب مما قد يحدث. وهنا يسمع قول المزمور: "الرب يحفظ دخولك وخروجك". وهكذا يدخل الطائرة بقلب مطمئن. ويخرج منها بقلب شديد وهي تهبط على الأرض في ال Landing. وأكثر من ذلك رواد الفضاء الذين ركبوا إحدى سفن الفضاء، وصعدوا إلى القمر أو المريخ. وطبعًا أسرة رواد الفضاء يقولون لكل منهم: "الرب يحفظ دخولكم وخروجكم".
ورائد الفضاء هذا يطير بمركبته، ويخرج من الغلاف الجوي الخاص بالأرض، ويصل إلى القمر أو المريخ وهم يقولون له: "الرب يحفظ خروجك"، ويقضي مهمته ويدخل إلى مركبة الفضاء ثانيًا، راجعًا إلى الأرض، وهم يقولون له الرب يحفظ دخولك: دخولك إلى المركبة، ودخولك إلى وطنك عائدًا إليه.
أيضًا العاملون في حقول الكرازة قديمًا، الذين كانوا يبشرون أحيانًا في بلاد من آكلي لحوم البشر. وكل واحد من هؤلاء – في سفره - يقولون له: "الرب يحفظ خروجك من بلدك ويحفظ دخولك إلى تلك البلاد، ويحفظ خروجك منها، تدخل إليها سالمًا، وتخرج منها سالمًا".
وبعض من هؤلاء يسافر إلى مناطق في أفريقيا مثلًا، وفيها أمراض مستوطنة وأوبئة. وربما منها مرض الإيدز، ومرض الملاريا الخبيثة وأنواع أخرى. ونحن نرسل كل واحد من هؤلاء إلى هناك ونقول له: "الرب يحفظ دخولك وخروجك، الرب يحفظ نفسك. الرب يحفظك من كل سوء".
أيضًا الرب يحفظك في يوم الدينونة الرهيب. حينما تقف أمام منبر الديان العادل: كيف تدخل إلى هذا اليوم؟ وكيف تخرج منه؟ الرب يحفظك..
[1] مقال لقداسة البابا شنوده الثالث نُشر في مجلة الكرازة، بتاريخ 21 مايو 2004م





